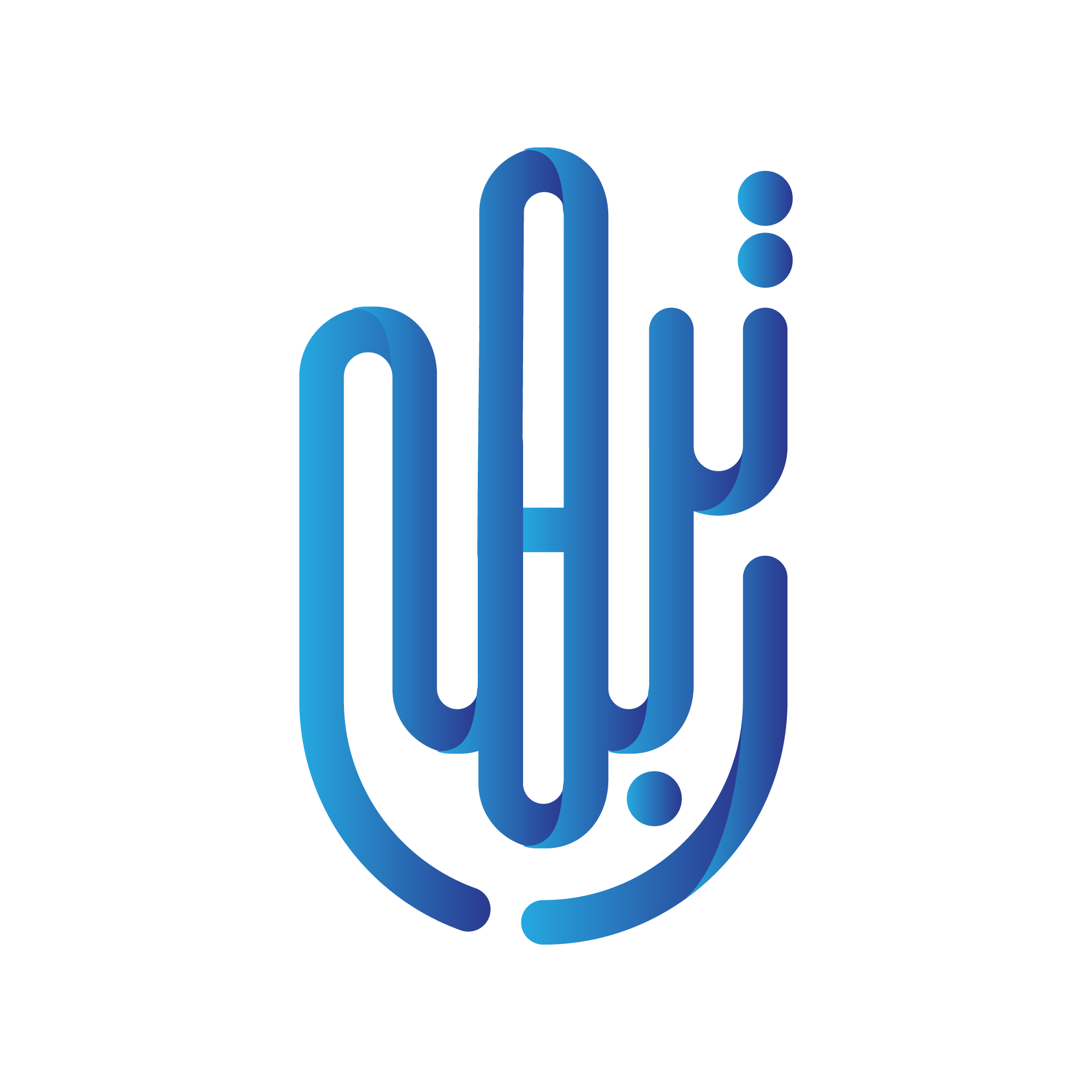في ليلةٍ هادئة، وبينا كنتُ في حلبة الظلامِ أُصارع النوم، التقطتُ هاتفي فأخذتُ أُقلِّبُ في الوسائل الحديثة لعلِّي أقفُ على فائدةٍ أو أطرب لبيتٍ أو أقتل الملل بمراقبةِ صراعٍ هنا أو هناك! لم أظفر بشيء يستحق، فأعدت الهاتف. دقيقة واحدة فقط، وإذ بي أختطفه من جديد بلا هدف مُحدَّد!
هكذا أزجيت ليلتي؛ أهربُ من هاتفي إليه! بعد ذلك أطلتُ التأمُّل مفكرًا ومتسائلاً؛ ما سِر التعلُّق المُمرِض في هذه الوسائل؟ وهل الحال حقاً كما قالت إلزا غودار، من ”أننا وصلنا إلى حدِّ الإدمان.. ولو اختفت شبكات التواصل الاجتماعي، لا قدر الله، لأصيب نصف العالَم بالجنونِ أو الاكتئاب!“.
غلبتُ نفسي، وألقيتُ بالهاتفِ بعيدًا، وامتشقتُ القلم، فكتبت: أسبابٌ كثيرة تجعل الفَرْد يُدمن هذه الوسائل، ثلاثة هي أشهرها: ١. الفراغ الموصِل إلى السباحةِ الدائمة في اللاشيء، ٢. الشعور بالنقصِ والبحث الحثيث عن القيمة، ٣. المحافظة على المكانةِ وإعجاب الجماهير.
الفارغُ لا يشعر بوجوده دون أن يُسرف في تبذيرِ أوقاته، والذي يشعر بالنقصِ لا ينفك يجوب القفار بحثاً عن القيمةِ للشعور بذاته، وصاحب المكانة المرتبطة بإعجابِ الجماهير ملزم نفسه بالحضورِ الدائم حتى لا يخبو وَهَجه ويذوي كوردةٍ سُدَّ عنها مجرى الماء.
ونحن إذا تأملنا حال هؤلاء الثلاثة؛ وجدنا أن آخرهم هو مظنة الهلاك! لأن الفارغ وإن تلاشت هذه المنصات سيدفعه فراغه إلى مكانٍ آخر يقضي فيه وطره، والباحث عن القيمةِ لن يعدم موطنًا آخر يلاحق فيه بغيته، أما الثالث الذي ارتبطتْ مكانته في هذه العوالم سيشعر بالتلاشي لحظة اختفائها.
وبعد، ننفذ إلى مدخلٍ وعظي فنقول: تعلّق الإنسان في أي شيء يحتمل أن يختفي من الوجود؛ له أضرار جسيمة وتبعات مؤثرة سلباً على اتزانهِ النفسي. أما تعلّقه في الثابتِ دائم الوجود؛ فيَخلق الطمأنينة، ويضاعف الثقة، ويُشعر بالأمان، وليس ذاك إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم علِّق قلوبنا بك.
اليوم، لا يقول عاقل بتركِ هذه الوسائل، والعزلة في رأس جبل، فهذا فضلاً عن أنه لن يتحقق، فإنه ليس حلاً ناجعا. الحل، أن يكافح المرء نفسه، ويروضها على الاعتدال، ولا يطلق لها العنان، بل يكبح جماحها كيلا ترديه في مجاهل الهلاك. ولن تصل بسهولة، وأي نشوة في سهولةِ الوصول؟ جاهد حتى تبلغ.
جاري تحميل الاقتراحات...