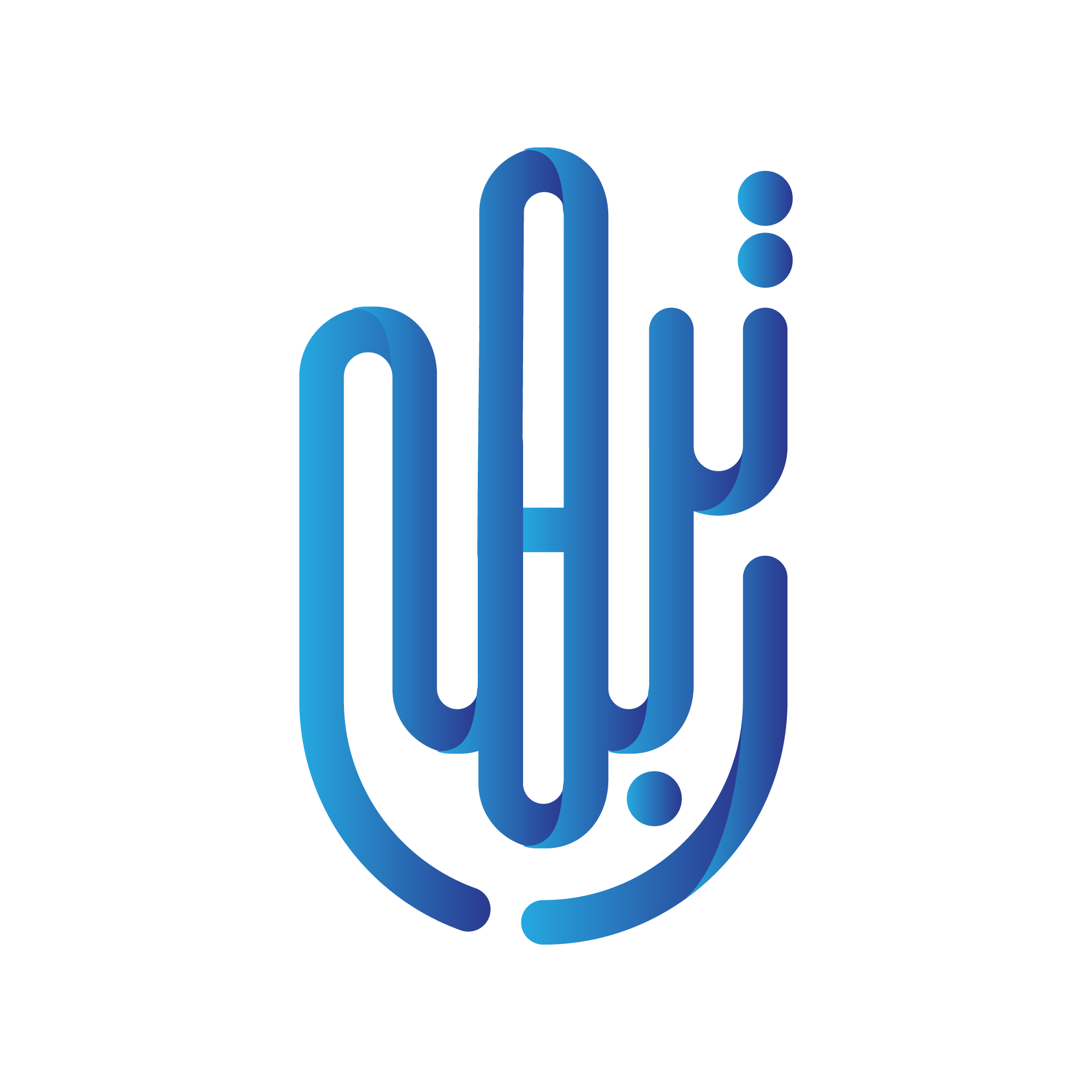عادتنا نحن الذين ترعرعنا على الأرصفة، أن نتعلَّم بعد الضرب لا التجريب، إذ أن تجاربنا مقرونة بالضرب، لأننا إما أن نسبب مصيبة أو نستقدم كارثة.
والضرب نظامٌ اجتماعي يشارك الجميع فيه، ابتداءً بالأب، مرورًا بالأقاربِ من الدرجة العاشرة، وصولًا إلى الجيران، وانتهاءً بالمارةِ، الكل يضرب.
حتى أنك تصل إلى مرحلةٍ لا تدري فيها لمَ ضُربت أو فيما ضُربت، ولكنك مؤمنٌ أنك قدْ فعلت شيئا، أو تنوي فِعل شيءٍ، أو احتياطًا حال فعلتَ شيئا.
وأنا لا ألومهم، فمع ما كنا نفعله يوميًا كان من الأجدر بأهلينا إيداعنا دار للأحداث، أو سجنٌ عائمٌ في عرض البحر ومن ثم خَرقه لنغرق ببطء.
تنساب أحداث القصة بعد صلاةِ الفجر، وغالب مصائبنا بعد الفجر، لأن الشياطين تنشط في هذه الأوقات، وحتى صلاة الفجر مع الجماعة لا تؤثر فينا.
إذ انصرفنا من مسجد الحارة أنا وبندر وعلي، ونحن نذكر الله تارة، ونراجع جدول مصائبنا لهذا اليوم تارة أخرى، أين سنذهب؟ وماذا سنُحدث؟! وكيف؟
وعلي هذا صبيٌّ من الجنوب، من قريةٍ منسيّةٍ فوق طود عظيمٍ اسمه منعا، نحيلٌ مثل عودِ الآراك، يلبس طاقيةً تستنطق من يراها ليقول: عدّل طاقيتك.
كانت أمه من أكرم نساء الحي وأحفظهن لحق الجار، وقدْ أحضرت معها من الجنوب عشرات الصِّحَاف، والتي عرفنا لاحقًا أنها لا تقدر بثمن.
وقدْ كانت أمه مشهورةً بإعداد المشاغيث والعصيدة، ولم تكن تكشف لنا وجهها كما يشيع بعضهم اليوم، بل كانت مثل باقي أمهاتنا، محافظة ملتزمة.
ولو أني لا أدري ما الذي هبط بهم من ارتفاع 3000 متر إلى صحراء نجد التي يموت فيها الإنسان والطير والزرع والأمنيات، والله لا أدري!
من هذا الذي يستبدل الجبال الشم بالمعادِن اليَشم، ويزهد في مزارع القوطة ليسقط في حديقة الفوطة، ويترك قرية جمالها موصوف إلى أخرى غبارها مندوف.
وقدْ سمعتُ أن والدهم أراد إنهاء بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بتقاعده، فطالت مدة الإجراءات تلك، فقرر بناء بيتٍ حتى تنتهي معاملته.
والدهم كان يشجّع النادي الأهلي بصورةٍ تبعث النشوة والاعتزاز، وطالما كنت أظن الملحفة الخضراء التي يتوشح بها طبلون سيارته دلالة على وطنيته!
وتشجيع نادٍ مثل الأهلي في حي السويدي أعجوبة في حد ذاتها، من ذا الذي سيشجع ناديًا مقرّه ليس في مدينته! أو ناديًا اسم حارسه المترو!
وللعم فايز لحيةٌ بيضاء عظيمة، كنت أظنه يصبغها لأنه يشجع الأهلي! لم يَدر في خُلدي أن السواد الأعظم من أهل الجنوب لحاهم بيض كبياض نواياهم.
كانت لحيته مدعاة للفرجة، فهي كثة جعداء، منحنية إلى الخارج مكونة انخفاضا ملحوظا في وسطها، لو وضعت فيه بيضتين لرجن عليهن زوج من الحمام البلدي.
عادتنا، أن نذهب للإفطار أول الأمر، صحن من الفول، نختمه بالهرب دون دفع الحساب لصاحب الدكان، وكل يوم نحن في فوّال، نأكل ونهضم ما أكلنا بالهرب.
لمَّا راجعنا جدولنا، وجدنا أننا على قائمة المطلوبين لدى جميع دكاكين الفول الواقعة في نطاق دائرة نصف قطرها 8 كيلومترات، فليس من العقل الظهور.
فقررنا سرقة سيارة والد بندر، نعم..لا نعرف سياقة السيارة، أصلًا أطوالنا لا تتجاوز 95 سم بالنعل، لكننا سنجرِّب…لأن مصيرنا أن نضرب نهاية اليوم.
السيارة هايلكس، طرازها 77، ويمكن تدوير محركها بالنظام المِلْعَقي، والنظام الملعقي شبيهٌ بالنظام الصوتي في المرسيدس، إلا أنك تحتاج إلى ملعقة!
وفعلًا، أحضر بندر ملعقةً لإشعال محرك الهايلكس، إلا أن ثمة مشكلة أخرى كبيرة، وهي أن صوت هدير المحرك قد يوقظ نصف سكان جنوبي الرياض!
فكانت خطتنا لذلك: وضع ناقل الحركة على وضعية الحياد، ومن ثمَّ دفع السيارة بعيدًا عن الحارة قدر المستطاع، حتى يمكننا إشعال المحرك دون حذر.
بدأنا التنفيذ، أنا داخل السيارة أقوم بتدوير العجلة، وهما يدفعان، ولما تحركت السيارة لم أستطع تدوير العجلة، كانت أثقل من دم حبيب الحبيب.
اتجهت السيارة بسرعة ناحية جدار في آخر الحارة، وبندر يركض أمام السيارة ويحاول إيقافها، وأنا متعلقٌ على العجلة، وهو يهمس بقوّة: لفّ لفّ لفّ!!
كنت أحسبه يقول: دفّ دفّ.. فنزلت من السيارة ورحت أدفعها أكثر...فانتهى الحال بالسيارة في جدارِ جارنا أبو عبد الله، تهشّمت واجهتها وتكسّرت.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، لقدْ أدركنا رغم حداثة أسناننا، أنهُ لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، ونحن الآن في حكم المذبوحين، فلن يضرنا السلخ!
علي كان يرتعد وهو يقول بلهجته الجنوبيّة: قَسم أن أبوك "الينِّي" ذيه يساوينا بالأرض، أنا بروح أندس عند "يَدَّتي"، ولا تعلمونه أني كنت معكم.
أشعلنا المحرك، بندر خلف العجلة، وأنا بجواره، كان إذا أراد زيادة سرعة السيارة انعدمت الرؤية، وإذا أراد مشاهدة الطريق انخفضت السرعة!
أخذنا جولة حول حمى الحارة، ثم بدأت الثقة تسري في أجسادنا مسرى الدم، أحسبنا مثلَ زميلين في سباقٍ للراليات…
صرنا نزيد من سرعة السيارة، وبدأنا نستعمل المكابح اليدوية على سرعات منخفضة، ثم شيئًا فشيئًا على سرعاتٍ عالية نوعًا ما.
آخرها كان منعطفًا يساريًا قويًا، في زاويته الخارجية أرض منخفضة، كان آخر منظر أذكره هو طبلون الهايلكس الأزرق وفتحة التهوية…
انحرفت السيارة في لحظة، كنت أسمع بندر وهو يصرخ: أشهد أن لا إله إلا..ظننت أننا سنموت، وأن بندر سيدخل النار، لأن الله لم يسعفه لإتمام الشهادة.
كنت أجلس مثل أرنبٍ وديع، أقلَّب نظري في وجهِ بندر وهو يحاول تعديل مسار السيارة، وقد وقف تماما على رجليه من هول الفاجعة، كان منظره فوق الوصف.
هي ثوانٍ، حتى انقلبت السيارة داخل الأرض الفضاء تلك، حبست أنفاسي وأغمضت عيناي، ولم يمر علي شريط حياتي، أظن لأنني في الفصل الأول منه.
فتحت عيني على منظر بندر وهو منقلبٌ وقد اسودَّ وجهه وعليه طبقةٌ من التُّراب، ظننت أول الأمر أنني في القبر، وأن بندر سيسألني! فبكيت بندم عظيم.
سَعل بندر، واستفاق، عرفت أنني لازلت على قيد الحياة، فرحت وانزاح عني همٌّ كاد يذبحني، قررت أن أقطع علاقتي ببندر في حينها، سأتركه وأذهب للبيت.
خرجت من نافذة السيارة، وخرج بندر من النافذة الأخرى، ثم انطلق يبكي مثل بكاء الفتاة إذا سَخر أحدهم من لون فستانها، أو شاهدت إحداهن تلبس مثلها.
فقلت له: احمد الله أننا أحياء نرزق، فصرخ في وجهي يقول: يلعن *** والله أن يذبحني أبوي، فقلت: لن يذبحك، فقط سيضربك، وهذه سنة من سنن الحياة!
لا يُلام بندر على هذا الخوف، فقد هدَّده والده ذات مرة بالسلاح علانيةً في الشارع لأنهُ كان يجلسُ على الصندوق فقط! أظنه هذه المرة سيسحله.
عن نفسي، هربتُ إلى أحد الأقارب الذين أثق فيهم، كانوا يخططون تزويجي ابنتهم المختلة لاحقًا، لذا استخدمتها كورقة ضغط، الحصانة مقابل الزواج.
أما بندر، فلم يعد يركب السيارات مدةً طويلة، يُقال بأن والده سحق كل أفكاره عن السيارة، وحتى اليوم…يصاب بالذعر إذا مرَّ من عند معارض السيارات.
.
جاري تحميل الاقتراحات...