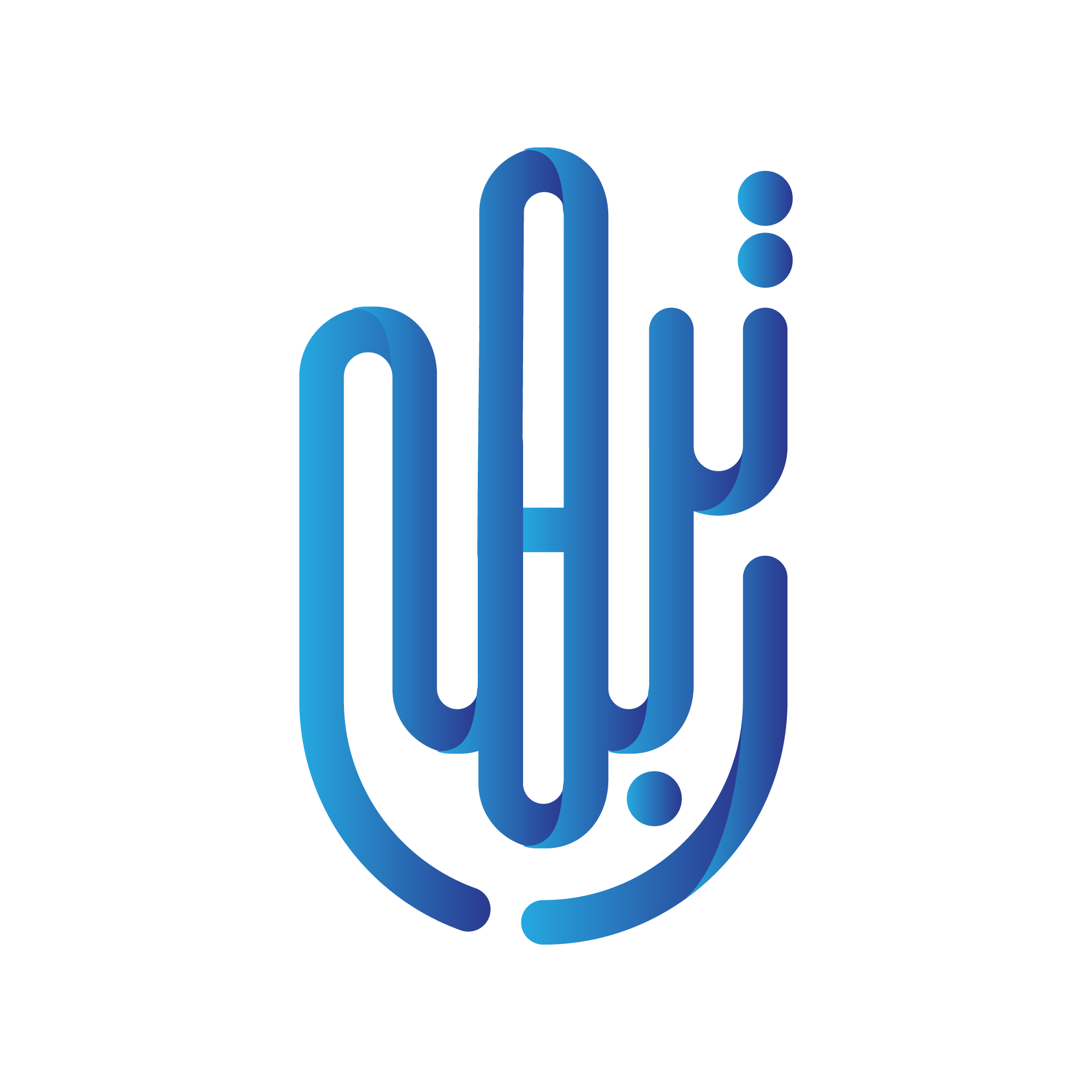كُلّما نظرت إلى صورتي في ملف أولى إبتدائي أدعو الله أن يغفر لخالي الذي أخذني عنوة لدكان التصوير ذلك اليوم، لا أنسى ذلك اليوم ما حييت.
من يشاهد الصورة تلك، سيرى في عيني بؤس أُمّة، وفي تسريحة شعري ثورة لصوص، وفي سُحنتي همٌّ وغمّ، أضف إلى ذلك خلفيّة الصورة العنّابية المظلمة.
تلك الخلفية التي تَصلح لغرف الإعدام بالغاز، أو الاستجواب ونزع الاعترافات أكثر منها خلفيةً لصورة شخصيّة، ولولدٍ على مشارف الدخول للمدرسة!!.
أوّلُ يوم يومٍ لي في المدرسة ذهبتُ وحيدًا، الاصطفاف في طابور المدرسة كان مثل المشي في سوق الغنم!، هذا يبكي وذاك يعوي، وهناك طفلٌ بلل ملابسه.
أوَّل يوم في المدرسة كان جنونيًا، أذكره جيدًا…كلّهُ أحداث متسارعة متعاقبة، وكأنك في مباراة نهائية امتدَّ الوقت الإضافي فيها إلى خمسةِ ساعات.
كان معلّم القراءة لهُ إصبعين إبهام في يده اليمنى، ومعلم الرياضيات أعور، ومعلم الرياضة البدنيّة يلبس بشتًا لا بدلة رياضية، كانت مدرسة غريبة.
كنتُ أحضر للمدرسة ثم أسرح حتى وقت الخروج من المدرسة، كنت مثل الموظف الحكومي، وراتبي هو مبلغ الفُسحة!، كنتُ منتظمًا دراسيًا بالجسد ليس إلّا.
كانت والدتي -حفظها الله- تطبع قُبلة على رأسي وأنا أهم بالخروج إلى المدرسة حاملًا أسفاري وهي تقول: "الله يقاك من العين"، عن أي عينٍ تتحدّث!.
عندما دخلت المدرسة تعرّفت على صديقي (بندر)، أطيب إنسان في الكون، طيّب وسَمح، كأنهُ نبيٌّ بلا رسالة من شِدَّةِ طهارته وصدقه، وقد كنت أسْتغله.
صديقي بندر هذا كثير الرسوب، رسب في كل سنواته الدراسية، بل رسب في مادة التربية البدنية!، ورسب في اختبار القيادة، وفي تحليل تطابق الدم للزواج.
كنتُ أنام في ليالي الصّيف وأنا مسمِّرٌ ناظري في اللّمبة السّهارية الخضراء على جدار غرفتي الأزرق، كانت تلك اللمبة رفيقة الليل…وأنيس الظلام.
يشاركني الغرفة أخي ونقيضي، فهو ناجح دراسيًا، مطيع منزليًا، أحمر الخدين متوردهما، شعره مسربل ومرتب، وهذا النوع من البشر دومًا يكون ثقيل طينة.
كان أخي هذا فضيحة، كان كالمذياع…يفتحهُ والدي بعد صلاة العِشاء وهو يشرب لبن الريّ، فيخبرهُ بما فعلت وما لم أفعل، كانت سنوات ظلامية تعيسة.
كنت في الليل أسمع صوت الجيران، وصلت إلى مرحلةٍ متقدمة من تمييز نبرات جارنا سيف، والتنبؤ بتصرفاته، كنت أستطيع تقديم دراسة مستوفية عنه وأسرته.
والدتي -والحق يقال- كانت صبورة جدًا عليّ، صبرها يُشبه ذاك الذي زرع بذرة، ثم سحب كُرسيًا وجلس يرقبها حتى أثمرت!، إنهُ نوعٌ من صبر لا يُحتمل.
كنا نقف في الشارع أنا وأولاد الحارة وكأننا من كفار قريش، أنا شخصيًا كنت أشبه عبد الله غيث في فيلم الرسالة، كنا ننتظر أي شيء لنتعارك معه.
لقد مارسنا كل أنواع الإفساد في الأرض، كنا نُدخن، نستنشق الدُّخان كما لو كان آخر نفس لنا، حتّى تتشقّق حيازيمنا، كما لو كنا مأجورين على ذلك!.
كان جارنا هلاليًا يكره النصر، كان يأخذني لمباريات النصر ضد أي فريق، لنشجّع ضد النصر!، من هنا أحببت النصر، حبي للنصر كان ثورة للأخلاق والعقل.
لم يكن التعارف على الفتيات سهلًا، نظام المعيشة لم يكن يساعد على ذلك، حتى أنا نفسي لم أكتشف أن لي أُختًا إلا بعد ٧ سنوات!.
كنت أذهب للمدرسة حبوا في آخر أيامي، أتسلل إليها كما لو كنت مصارعا يريد ضرب كف صاحبه للخروج من الحلبة، المدرسة بالنسبة لي أسوأ أعمال البشر.
في صغري، كان اسم (موضي) بالنسبةِ لي خاص لكبيرات السِّن، كنت أنطقه (أمْويضي)، لا يخلو بيت في الرياض من امرأة اسمها موضي، ونادرا ما تكون شابة.
كنا نحب تربية الحيوانات المريضة، قطط مشوهة ومقطّعة الذيول، كِلاب تنهق من شدة الاختلال!، حمام بلا ريش، ببّغاوات لا يمكنها ترديد الكلام.
كنا نطارد الكلاب أغلب الوقت، صرنا خبراء كما في قناة Nat Geo، فالكلب إذا أحس فيك نبح عليك، فإن خفت هجم عليك، وإن هربتك لحق بك وعضّك.
أذكر مرة لحقني كلب، من شدّة غضبه كاد أن ينطق ويشتمني وهو يركض خلفي!، حينها لم تحملني رجلاي، لقد جلست وأنا أشعر بالخزي، وقد عضّني عضّة أليمة.
كنا لا نعترض على أهلنا إذا ما هم أرادوا ضربنا، كان اعتراضنا غالبًا على موقع الضرب وتوقيته!، فمن المعيب أن تُضرب وسط أولاد الحارة وبين الناس.
ولا أريد وصف شعوري عندما أُضرب وسط أولاد الحارة -مع أنهم يُضربون مثلي-، لكنني على يقين بأن الله قد مهّد لي طريقا إلى الجنّة بعد تلكم الأيام.
كانت ملابسنا نمطيّة تصيبك بالكمد، مرقعة، وقد اكتسبت -مع مرور الوقت- لونا غير لونها الأصلي، ثوبي كان يقف سواء كنت ألبسه أم لا ألبسه من الوسخ.
أحببت نادي النصر حتى سجلت في نادي الرياض في لبن، كنت أريد أن أبدأ في نادي الرياض ثم أنتقل للنصر، لكن والدي كان أسرع منهما، تعرفون ماذا فعل!
قبل أن يعرف والدي بخبر تسجيلي في نادي الرياض كنت ألعب بالقدم اليمين، وبعد أن عرف والدي بالخبر صرت ألعب باليد اليمين واليسار فقط، ولفترة.
علاقتي بوالدي أيام المراهقة ليست بالعميقة، كانت محدودةً بإحضار اللَّبن والخبز، خلا ذلك…يلتزم كلّ منا بحدوده، إلا أن بيننا حرب باردة…طويلة.
والدي -مثلًا- لا يعرف أين مدرستي!، كان خالي هو والدي، كان رجلًا أصفر الوجه مشوبًا بحُمرة، قليل الكلام، كلما نظر إليّ دبّت في جسدي روح جديدة.
لكم وددت استعارة حنجرة "سرحان عبد البَصِير" وهو يصرخ في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، قائلًا: (دنا غَلْبَاااان). صرخته تلك تلخّص الحال.
كانت حارتنا تغصُّ بالمعاتيه، حتى قطط الحارة تستنكر العاقل، وتعرف أنه غريبٌ تاه!، فهي معتادة علينا وعلى عُتْهنا.
كان مؤذن مسجدنا يلعب معنا الكرة، وقد كان يؤخّر أذان المغرب حتى يُسجل فريقه هدف تعادل أو فوز، وكان الإمام يحضر ولم يؤذّن للصلاة بعد!.
وقد تمّ -في وقتٍ لاحق- عزله عن مهام المؤذن لما لُوحظ عليه من تأخير، فأبدله الله خيرًا، وصار مؤذنًا في مسجد جامع إضافة إلى سكنٍ خاص به.
كان بعض الأساتذة يحدثنا عن أم كلثوم الفنانة وصوتها ومن هذا الكلام، وكنت أحسبها أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ، فكنت أفكر طوال الليل حتى عرفت!.
في المرحلة المتوسطة كان شغلي الشاغل هو الدخان، كنت شارد الذهن، يقطع هذا الشرود سؤال بندر: في أي مرحلة دراسية نحن! -من فرط ضياعه هو الآخر-.
مرّت المرحلة المتوسطة بالكثير جدًا من أعقاب السجائر، والقليل جدًا من المحصول العلمي، كانت مرحلة سريعة، أسرع من غفوة عصر يوم الجُمعة.
أعتذر إن كنت قد أسرفت في السرد، وللبعضِ الذي قد نسيته في ثنايا الرد، أتمنى لكم ولأحبابكم أطيب الذكريات وأسعدها.
@ibrg_ ما أمكن ذلك -بحول الله-.
درّسني في المرحلة المتوسطة عبد العزيز الريّس، ولم أستفد منهُ شيئًا ولله الحمد.
كان أستلذ الكيمياء يُحضِّر الماجستير، ويقول لنا: "بعد الحصّة، عندي ماجستير"، كنت أُشفق عليه، ظننت الماجستير مرض يحتاج معه إلى جلسات علاج!.
المرحلة المتوسطة كانت بالنسبة لي كأزمة منتصف العُمر، احترتُ فيها بين رفقاء السوء، وأهل الصّلاح، وما عادت نفسي تأمرني بالسوء من فرط ذنوبي.
كنت منتظمًا في مدارس تحفِيظ القُرآن الكريم عصرًا، وأتعلّم عزف العودِ بعد صلاةِ العِشاء، وأنامُ بعد قراءة صفحةٍ من كتابِ رياض الصّالحين.
لقد كان في صدري معركة بين الظلام والخير، جزءٌ مني مع الفاسدين، وجزء آخر لا ينفك عن ترغيبي بالصّالحين، باختصار…كُنت أُحب الفاسدين ولستُ منهم.
كانت العطلات الصيفية متعةً لأقراني، إلا أنها تمثل كابوسًا لي، كنت أعمل في كل عُطلة، عملتُ في كل شيء، عملت حتَّى في حديقة الحيوانات بالملز.
عملي في حديقة الحيوانات علّمني الكثير، أهم ما تعلّمتهُ: أنني صِرتُ أتعامل مع بعض البشر بشكلٍ أفضل بكثير مما سبق.
في حديقة الحيوان بحي الملز شاهدت العجائب والفرائد، لأول مرة أشاهد أسدًا يأكل الفول، وكان يصدُّ عن اللبؤة كما لو كان مصابًا بعجزٍ أسدي.
شاهدتُ زرافةً قصيرة ومصابة بضمورٍ عضلي، ذئابٌ تعيش فرادى، وحيد قرن بلا قرن!، والبعير كان كبيرًا عاجزًا ساخطًا، وكأنه من شيبان نجد!.
كنت في الثانوية أُشبه الفتيان الذين يظهرون في دعاية برنامج الأمم المتحدة للغذاء، غائر العينين، و ثمّة سوادٌ يغطي وجهي كالذي يعلو القاهرة.
وقتما انتظمت دارسًا في المرحلة الثانوية، تعرّفت على صديقٍ اسمه (ثامر) من أهل الحريق، كان لعينًا بشكل عجِز معهُ إبليس، وطلبَ إبليس مناظرته!.
تعرّفت على ثامر عندما قال الأستاذ لنا: "بكرة عليكم واجب كذا وكذا". فقال ثامر وبصوت مسموع: "في النَّخل". هكذا قالها صراحةً، دون أي احترام.
ثامر هذا من بديع خلق الله، لو أنَّ مُلحدا شكَّ في صنيع الله وبديع خلقه، لاستشهدت بثامر، حاضر النُّكتة، خشن المعشر، قروي من الطراز الأولِ.
ثامر أرضعته أمه اللَّكاعة من ثدييها، كان حَرِيْقِيًا متعافي البدن، مطبوع على صدره V12، أقنى الأنف، مكتوب بين عينيه (خربان) يقرؤها كل عاقل.
ثامر قد عرَكته الحوطة، وضرّسته النعام، مرهف الحس، خفيف النَّفس، أهمّ ما عنده في دنياه سيّارته المازدا، ويحنُّ للحريق حنين من غالبته الفُرص.
في المرحلة الثانويّة أصابني تبلُّد مرير، كنت أتغيّب عن المدرسة وأذهب لمقهى شيشة رفقة ثامر، بسيّارته نوع مازدا طراز ٧٦ ولونها الذهبي الأخّاذ.
في المرحلة الثانويّة تعرّفت على أُستاذٍ قُبض عليه فيما بعد بتُهمةِ الإرهاب، كان مُعلمًا سمّيعًا لأُمِّ كلثوم، يتحدث عنها بإطناب ممل.
كانت حصّة اللُّغة الإنجليزية مضيعة للوقت، الأُستاذ نفسه لم يكن يتحدث الإنجليزية جيدًا، وأغلب التلاميذ لا يجيدون العربية أصلًا، ضياع.
أما حصّة الكيمياء فالأستاذ رجل هرِم، يتحدَّثُ أكثر شيء عن كيمياء الجسد، كان يُحب النساء بشكل مخزٍ، كان كل حديثه عن النساء اللواتي شغفن قلبه.
كنت بليدًا في مادة الرياضيات، علبة هندسة "العقيلي" بالنسبة لي أدوات حجامة، كنت أتردد في ناتج جمع ١+١، نشأت كارهًا للأرقام والأعداد.
في المرحلة الثانوية صرتُ مثقلًا بالهموم، صرتُ أبعد شيءٍ في الضياع والتيه، أعتقد أن الملائكة لا تدخل غرفتي إذا كنت أنا فيها.
قررت التوبة، عقدت العزم على أنْ أتوب، جمعت كل أشيائي الفاسدة وحفظتها عند بعض الأصدقاء، لأستعيدها حال عدولي عن التوبة!.
كنت أحب اللون الرمادي، أُحب عدم الوضوح، أُحب أن أبقى بين البين، وسط الاحتمالين، أمسك عصفورًا بيدي، وأحاول في العشرة التي على الشجرة.
عندما حلّت أزمة حرب الخليج، لم يبق في الحارة غيري…وهرٍّ مُحترمٍ، الكل هرب إلى مسقط رأسه، كان الموت يطل بوجهه الشّاحب علينا في اليوم مئة مرة.
كنا إبّان الأزمة ننام في سطح المنزل من شدّة توكلنا على الله، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أذكر ذلك العشاء المختصر، لبن وزيتون وحساء طماطم.
كنت أرقب صواريخ سكود كما لو كنت جنديا في الدفاع الجوي، وكلما انطلقت صافرات الإنذار صعدت منتشيًا فوق الخزّان لعل الصاروخ يتوجه إلينا وينسفنا.
عندي صورة التقطتها للعائلة أيّام الأزمة، وهم على وجبةِ العشاء، أسميتُها (العشاء الأخير)، لأنهُ في اليوم التالي أُعلن تحرير الكويت.
كانت الرياض خاوية إلا من بعض الذين خرجوا لشراء الأشرطة اللاصقة، التجوال فيها من بعد مغيب الشمس بساعتين يشبه التجوال في مقبرة لغير المسلمين.
قرر والدي إدخالي مدرسةً أهليّة، لأن استمراري في المدرسة الحكومية هو نوعٌ من الدوران حول نقطة، يريد أن أحصل على نسبةٍ تؤمن لي مستقبلًا.
الدخول في المدرسة الأهلية يشبه كثيرًا الدخول في مشغل نسائي، لأول مرة في حياتي أشاهد هذه الوجوه المُسفرة، نظافة ولطافة ورهافة.
كنت في هذه المدرسة الأهلية كالزبيبة بين مجموعةٍ من عناقيد العنب البَيْروتي الناضجة المُتدلّية، كنت أتعسهم وأفسدهم ولا ريب.
كان معنا طالب مدلل يسمّونهُ دحومي، رائحته ذكيّة، أقلامه ملونة، كُتبه مُجلّدة، ملابسه نظيفة، وجهه وجه حورية، أظنه يقاسم أخته أشياء كثيرة.
كانت الوالدة تحب حياكة البيوز، كانت تحول أي ثوب لي أضعه للغسيل إلى مجموعة من البيوز في لحظات، هكذا كانت تقضي جل وقتها، أو خاشعة فوق سجادتها.
كانت الوالدة تلُفُّ الريال في يدي ليبدو أكثر، كانت تمتصُّ صدماتي كما امتصَّت أوروبة غزوات الجرمان والغول والقوط، كانت شخصيّتي المفضلة أبدا.
كانت -ولا تزال- دعوات والدتي تصل أسرع من طرود FedEx، وتنسف كل شيءٍ كما لو كانت عبوات متفجِّرة، تشعر بي وأنا على بُعد آلاف الأميال.
كانت والدتي تعرف أن رعي الغنم حرفة الأنبياء، لذا أرادتني راعيًا للغنم…لعلي أكون نبيا، كانت تُحبني أكثر شيء، فالله الله بأُمهاتكم.
إن كانت الناس تُثقلها الهموم، فأنا تثقلني الذكريات، كان كلما تقدّمت بي الأيّام، ازداد قحط الأصدقاء، وتمرَّغت في وحلٍ من أشباههم.
كان أصدقاء الطفولة والمراهقة من الصنف النادر المهدد بالانقراض اليوم، كانوا من النوع الذي إنْ أنت أردت طعن أحدهم في ظهرهِ…أعطوك كُلهم ظهورهم.
ولن أنسى ما حييت أنهُ كلّما ادلهمَّ الظلام، وخيَّم الهدوء، وسكتَ صوت المؤذن بعد آذان العِشاء، كنت أخرج لأجوب طرقات السويدي مع صديقي بندر.
نكتفي اليوم، هذه تَعلَّة صائم، أدعو الله أن يقبل صيامنا الذي ينزف الآن، وأن تعذروني لهذا الإطناب الممل، والإسهاب المخل، دامت أيامكم بالبركة.
@ibrg_ تراك تورطني أنت.
كانت علاقتي بوالدي نوعًا من التراجيديا، لو اطّلع موريس چارد على تفاصيلها لألَّف لها موسيقة تصويرية خالدة.
كان الوالد -أدام الله ظِلّه- ينظر إلي نظرة نفعيّة صرفة، كنت أجيرًا باليومية، موظفًا بلغ نهاية سُلَّمه الوظيفي، جمهورية موز مغلوب على أمرها.
كنتُ أكره يوم الجُمُعة، كرهتُهُ لأنه يومٌ طويل، ولأن الذي يعقبه يوم سبت، ولأنه يوم المشاوير، ولأنهُ عيد، والشياطين لا تُحبذ الأعياد.
كنت أصحو الجُمعة على صوت المِنْفاخ الكهربائي الذي تستعمله الوالدة لتنظيف مجاري النوافذ، ونداء والدي الجهوري المُزَلزِل: “قوموا صلّوا”.
كانت تتضاءل نسبة الرؤية في البيت إلى أقل من النِّصف يوم الجمعة بسبب دُخان البخور، ورائحة القهوة العربية التي تطاردك في حلمك من شدّة رائحتها.
كان الوالد يذهب لصلاة الجمعة قبل التاسعة، كان يُقدّم ديناصورًا، أُدير المفتاح، وأُشعل المُحرك، على صوت السّواك الذي يلعب لعبته في فم الوالد.
نقفُ عند الإشارة المرورية، الشّمس تصفع وجهي، وكأنها أشرقت من كبدِ السماء، أشعرُ حينها أنني على بُعد شبرٍ من مصباح مكتبي أصفر ساخن.
كان والدي يُصرُّ على الصلاةِ في بَاحةِ المسجد، تحت مروحة زرقاء قديمة من طراز (TAT) تُحرّك السَموم حولنا، وصوتِ تكْتَكتِها السريالي.
كنتُ أبصق قُطنًا من شدّة الحرِّ بعد صلاة الجمعة، كأننا من معشر المُهاجرين ونحن نجلس وحيدان في باحةِ المسجد، وأعُدُّ حبيبات الرمل فوق السجاد.
في أيَّام الشِّتاءِ الباردة، تستحيلُ الرياض قطعةً من صفيحٍ بارد، تنكمش، وتتداخلُ الأحياء، بيتنا يزحف ويصير في منحدرٍ يطل على واد غير ذي زرع.
كنت في الأيَّام الباردة أخرج باكرًا عنوة إلى المدرسة، منتعلًا أملي!، ومتجهًا لبيت صديقي ثامر، كانت جدّتهُ هيلة تُعِد فولًا لا يُنسى.
لكم ودَدّتُ أن أُلطِّخَ نفسي بذلك الفول السَّاخن كيما يَقيَني برد الرياض القارس الذي يدُكّ العظم دكَّا.
هيلة هذه ثاني أفضل صانع للحم المقدّد (المقفر) بعد قبائل الجرمان، كانت تنشر اللحم في سطح بيتهم، وترفعه على الحِبال عاليا لتغيض أُمهات الحارة.
جدّته هذه عمّرت عُمر لُبد، وبنشاطِ أسد، شهدت موقع حصان طروادة، ورحل عنها الملكان اللذان يحفظان أعمالها منذ سنوات.
في آخر أيَّامها كان الطبيب يكشفُ على قلبها عند ساقها، نتيجة الترهل، كانت تُشبه رغيف التميس الذي أُحضره للبيت وقد أكلت نِصفه في الطريق.
كانت تستخدمُ الدَّيْرم وكأنّها زعيمة قبيلة هِندية، تُقلّبه في فِيها تقليب مُسْتاك، وإذا انتهت منه…وضعته بين أصابع رِجلها.
في آخر أيَّامها كانت تُصلّي وتحكي مع أبنائها وبناتها أثناء الصّلاة، وكانت -فجأة- تسألهم عن غنمها، وعن أُناسٍ ذهبوا للحجِّ مشيًا.
يقول ثامر: كانت جدّتي تقرأ سورة الإخلاص مرَّة في صلاتها، ولما قرأت (لَم يلد ولم يُولد)، اِلتفتت عليّ وسألتني: متى جاء حمد؟!.
عندما ماتت جدَّة ثامر سَرت في الحارة طمأنينة جليلة، طمأنينة ما بعثها جيش صلاح الدِّين في وقته.
تعلّمتُ الرسم في المتوسطة، كنت أرسم كل شيء وعلى أيةِ شيء، كنت أرسم الخط، فصرتُ أخطُّ الصحائف المدرسية للجيران بمقابل، إلا لحبيبتي أفراح.
أفراح هذه بنتُ الجيران، كانت تكبرني بعامين، كنت أتخيَّلها جميلة كالسيدة الخارقة في مجلّة الرجل الوطواط.
كنت أتخيلها ذات شفة صغيرة، ولِسان عصفوري، وعينٍ ذابلة، ورموش كأنهن سيوف أحباش، وأنفٍ ناتئ، وشعرٍ أسود منسدل كليل بهيمي، كانت خيالاتي جامحة.
كان طيفها يزورني كسفينةٍ تَمْخرُ عُباب جسدي كل ليلة، وأنا أتقلّب فوق سريري الحديدي، متجاهلًا همهمة أخي وحنقه جرّاء صرصرة سريري.
كنت قد بنيت مرصدا فلكيا يرتقب بزوغها، عندما تظهر وقد تقنّعت بملحَفةٍ فُصّلت لجسد أنحل بكثير، لم أنتبه لخيط اللعاب الذي امتد من فمي إلى صدري.
أوّل مرة شاهدتها -صدفةً- في نهار عيد الفِطر، كانت تسترق النظر من عند الباب، كان المنظرُ أشبهُ شيء بأغلفة أفلام الرعب.
ذهلت وصدمت، تمنّيت لو أن الأرض تنشق وتبلعُني، شعرتُ بهبوطٍ مفاجئ، ودوخة!، كنتُ -على عُجري وبُجري- أجمل منها، وأنا الذي ليس لي في الحُسن أمل.
كانت الطامة كبيرة، والنكبة خطيرة، كنتُ أجمل منها -وأنا الذي ليس لي في الحُسن أمل- تطلّب مني تجاوزها أعوامًا عديدة، وأزمنةً مديدة.
دقيقةُ صمت، ترحُّمًا على حال من تزوَّجها…
مرَّت بعدها الأيَّام، طويلة وصامتة، كأنها رسمٌ تخطيطي لقلبِ إنسانٍ متوفى.
هذه السيرة مخالفة للأصول، الأشخاص المذكورون حقيقيون، وبداعي احترامهم جرى تغيير الأسماء، أما أنا فغير متحرِّجٍ من الفضيحة.
ولا يمكن بأيةِ حال نقلها على السناب، أو مطّها لتغدو رواية، هي مقتطفات رأيت تشذيبها وإعادة صياغتها، ومن ثمَّ مشاركتها.
كُثُرٌ هي الليالي التي عُدت فيها إلى البيت يحملني بندر وثامر، لقد كنت أدخل في هوشاتٍ مع الجميع، أَضرِبُ وأُضرب.
كانت الجروح في مقدمة رأسي أكثر منها في مؤخرته، ليست شجاعة مني أو إقدامًا، بل كنتُ أنظر للوراءِ كثيرًا وأنا أهرب.
لستُ مقطوعًا من شجرة، لكنني هززتُ نفسي حتّى سقطّت!، هكذا يُعرّف ثامر بنفسهِ دائمًا عندما يتغيّب والده عن مجلس الآباء.
كان ثامر مثقفًا، يدسُّ أنفه في كل شيء، كُتب، مجلات، صُحف، رسائل، كراريس، دفاتر، يقرأ في كل فن، حتى الطبخ.
كانت ساقاه طويلتين، كأنه مالك الحزين، أكثر وقته حافيًا، وقد اكتسب باطن قدمهِ طبقةً من الوسخِ تَقيهِ، إلا أنَّ شمائل الطِّيبِ تتقاتل عنده.
وكما أحرق التوحيدي كُتبه في آخر أيّامه، فعل ثامر مِثله، أحرق بيتهم بعد وفاة والده، وعاد إلى الحَريق، رجع إلى مزرعته.
عاد المخبول إلى موطنه الأصلي، حيث النخيل والتّرنج والعبري والبمبر، عاد سيرته الأولى، شابًا همّه الأكبر تلقيح النخل.
كانت الرياض بالنسبةِ لثامر، كمن فتحَ هديّةً يتوقعها قيّمةً فوجدها مقلبًا سَمجًا.
كانت الوالدة ترعى بضع دجاجاتٍ في سطح البيت، ذاك الدّجاج الذي لم أر بيضةً واحدة منهُ، فيما بعد عرفتُ أن الديك مصاب بالعُقم.
كان ذلك الديك يعتنق غير الإسلامِ دينا، لا يصيح الفجر، ولا يصدح بصوتهِ عند بزوغ خيوط الصُّبحِ الأولى، لكن إذا شاهدني صاح وارتبك.
كانت والدتي -مع حُبها لي- تنكأ في كُلِّ مرةٍ جُرحي وهي تقول غاضبة: "يقولون يا حظّها جاها ولد، ليتك بنت وآخذ نفعك".
سأجعل أتحدث لكم الليلة عن حارتنا، المستوطنة التي ساقتنا إليها الأقدار.
الحارة التي بلعْتُ لأجلها صابونة زِسْت صفراء، لعلّها تغسل جوفي وتُطهّره من أدرانها ومثالب ذِكراها.
الحارة التي كنت حين أستحم مستعملًا شامبو العباءات الأحمر، أشرب القليل منه، وأهيم بعيدًا عنها، حتى يقطعني مُنادٍ: "خلّصت الما يا ولد".
أبصرت النُّور في أواخر شعبان، ولم تكن الممرضة التي أولدتني على درايةٍ بحجم المصيبة التي ظهرت للدُّنيا، وإلا لدسّت قُطن التَّطهير في فمي.
كانت حارتنا بسيطة، كمدنِ أوروبة الشرقيّة، بساطةٌ موغلةٌ في الفقرِ والعوز، كان الشارع معلمي الذي أُدين له بالفضل -بعد الله-.
كان بيتنا -أو لحدنا-، على شارعٍ ضيّق أوله مظلم، وآخره مُعتم!، ولمبّة صفراء متدلية فوق الباب وظيفتها إخبار الناس أنَّ هنا بيتًا.
كان الظلام يطوِّق حارتنا حتى في أكثر ساعات النَّهار نورًا، وأصوات البيوت متداخلة وكأنها صالات انتظارٍ لرحلةٍ تأخر إقلاعها أكثر من ١٠ ساعات.
كانت الحارة برمتها تغطُّ في موتةٍ صُغرى من بعد صلاة العِشاء، ولا تسمع إلا نقيق الضفادع في الوادي المتاخم، وفحيح الأزواج في غُرفِ النَّوم.
كان آباء الحارة دوثراكيين في جَلدهم وأسلوب معيشتِهم، والأُمهات…آه من حال الأُمهات حينذاك، هُن أكثر من أرسل إلى برنامج المسند: "منكم وإليكم".
كانت الأُمهات يتزاورن كل يوم بعد العصر، يتجاذبن أطراف النميمة، ويبعن نسيئةً، ويتبادلن السِّلع، صاع من الحنّاء مقابل ٩ أميالٍ من اللُّبان.
كانت كل أُمٍّ لديها ما يكفي حاجتها من المصائب، الأزواج، وأبناء مثلي وبندر وثامر وعزّام، كانت الجنّة تُحيط بهن أينما قلّبن أبصارهن.
أقامَ في الحارةِ وافدٌ مِصري حَبيب، لعنَ اليوم الذي سكن فيه حارتنا، كانت زوجته تدرِّسُ فتيات الحارة، وهو يدرِّسُ أولادها.
كنا نردد أهزوجةً بالغة الدناءة إذا ما نحن شاهدناه، فحواها: "أوه يا مصري يا مسخره، أمك راقل وأبوك مره". كُنّا جرذانًا بلا ضمير.
كان منزله بعد العصر يكتضّ بالدَّارسين الذين لا مستقبل لهم، درّسنا الرياضيات والقواعد والعلوم والأدب وقِلّة الأدب ومنتهى الطلب من جنس العرب.
كان يعمل نجّارًا، ولم يُكمل تعليمه حتى، لكن سحنته وسحنونه، وبنطاله الكروهات، جعلت منه إمام عصره، وفريد نوعه، و وثِق فيه الآباء ثقة الأنبياء.
ثواب هو اسم رجلٍ أبَّال، جاء إلى حارتنا بعد أن قذفت به صروف الدَّهر من برادِ الطَّائف إلى بَاحُوراء نجد، هذا المسكين.
ثواب رجلٌ مزواج، لديه ترسانة من الأولاد، حتى أنهُ بدأ يُرمِّز بعضهم بدلًا عن تسميته، كان عدد أولاده يرتفع وينخفض مثل مؤشر البورصة.
كانت عندهُ فتاة مجنونة -شفاها الله-، تصعدُ فوق الجدران، وتخيف الوغدان، تضحك مع شمسِ الأصيل، وتبكي إذا سَعْسَع اللَّيل.
كان والدها، ثواب، سائق أُجْرة كثير الضَّجر، وطوله شِبر، للدرجة التي كنت أرى فيها ركبتيه من تحت الباب إذا جاء يشتكيني عند والدي.
جارنا سعيد بلغ من العمر عتيّا، كان شبيهًا بجدِّ هايدي، إلا أنهُ لا يلبس سِروالًا، وليس عنده حفيدات يشبهن هايدي.
كان يخرج صباحًا عند باب بيتهم، يُسند ظهره للأيّام، صامتًا حتى تصليه شمس الظهر الحارقة، كنت أحسده على هذه البحبوحة، أردت أن أكبر وأصير مثله.
توفي سعيد صبيحة يومٍ سبتٍ حار، كان الهواء فيه مثل لهيب الشمس، أكل شحمًا وتوفاه الله، وجدوه ممددًا في باحة المنزل، رافعًا إصبعه الوسطى لأهله.
جارنا حسن كان مختلًا، يقولون: "فيهِ جِنيَّة!"، أكثر ما يفعله هو التَّدخين والمشي في الحارة، لو كانت هذه الجنيّة حقيقة لاصطفيتها خليلةً لي.
كان يتجوّل في الحارةِ مثل مسّاحٍ، ويتفرّس في الوجوه مثل مُسْتشرق، وإذا أشعل سيجارته استحال آلةً بخارية رديئة الصُّنع.
كنا لا ندري ما الخمرة، لكننا نعرف بأن جارنا سالم قد يبيع أولاده مقابل زِقّ خمر، كان يخمّر التمر الذي يصله من المحسنين في بيته بالقدر الكاتم.
كنا إذا سمعنا دويَّ انفجارٍ، علمنا أن ذاك هو قِدْرُه الكاتم، وأنَّ سالمًا فقد محصول الخمر هذا الأسبوع، فالتخميرُ عملية صعبة معقّدة خطرة.
كُنَّا نسميه أبا نَواس، غير أن أبا نواس إذا ثمل قال الشِّعر، أما هو فيخرج ويُفحّط في ملعبنا التُّرابي، والمسجل يصدح بأغنية بشير: "سرى ليلي".
كان يشرب حتّى تغدو نسبة الدَّمِ في الكحول ٢٪، كان يتخمَّر تخمُّر جاهليّة، حتى يفقد رُشده، بشرابٍ هو أسوأ ما يُذْهَبُ العقل به.
احتال ثامر مرّة على سالم، وأخذ من شرابهِ حتى ثَمِل، يقول ثامر: "نمتُ تلك الليلة، وحلمتُ بحمارٍ يأكل سيكل، وعمارة سكنية تقطع الشارع".
قفلة:
أصدقاء الإنترنت هم عادة أسوأ الأصدقاء، ذاكرتهم لا تشيخ، فكل شيءٍ مدوَّنٌ في الإنترنت، وهو ذاكرتهم.
أصدقاء الإنترنت هم عادة أسوأ الأصدقاء، ذاكرتهم لا تشيخ، فكل شيءٍ مدوَّنٌ في الإنترنت، وهو ذاكرتهم.
عزمتُ اليوم أن أُنهي ما قد بدأته، سأضع حدًا لذلك كُلّه، ففي التكرار مرارة، وفي الإطالةِ شَجْو، وفيكم ما يُغنيكم عن ذلك كُلّه.
بعد برهة، شعّ الإنترنت بنوره في البيوت، أنار الظُلمات، دخل مع كل شقِّ، كان كالغبار…يدخل في كل مكان ويجثم، يسوق الفرح ويطرد الترح.
عندما دخل الإنترنت إلى بيتنا جلست أيامًا لا أحادث أصدقائي، كنت ألعب الشطرنج على موقع ياهو مثل كاسباروڤ، والسنوكر مثل سوليڤان.
كان دخول الإنترنت إلى حياتي أشبه شيءٍ بخيطِ الدُّخان الذي انْسلَّ في جوف صائمٍ بعد فِطره، نشوة يخالجُها دَعَة.
حتّى والدي تغيّر، صار أكثر أبويةً، الرَّجل الصَّلف صار يهتَّم!، لا يدخل البيت إلا وقد تأبَّط جحّةً أو جْروةً؛ "إنهُ الإنترنت يا سادة".
وضعنا الحاسوب في غُرفة متطرّفة من البيتِ منسيّة، ما كان فيها حياة، إلا صوت طنين البعوض، وحفيف أغصان السِّدرة عند نافذتها.
أول مرة شغّل الإنترنت لنا خالي، ثم ذهب!، فتورَّطنا في إطفائِهِ، كانت والدتي تقول: "كبّوا عليه مويه"، صارت تستظرف أطال الله في عُمرها.
نقلني الإنترنت من سراديب الواقع، إلى مخيّمات الاستيطان، كانت نقلةً مجازية، كنت فيه كمن يحاول استخلاص السُّكر من مياه البحر الميّت.
صار الإنترنت في بيتنا كالماء، هو أعز مفقود، وأهون موجود، كالقائل -بتصرف-: كأننا والإنترنتُ أمامنا، قومٌ جلوس أمامهم إنترنت.
كنت إذا غادرت أولاد الحارة، قالوا لي: أكيد بتروح تلعب بالتلفون!. كانوا يسمّون الإنترنت تلفونًا.
كان الإنترنت في بدايته فسحة لي، الإنترنت كما وصفه البعض بأنهُ: أعظم حفلة تنكريّة عرفناها، وأنا فيها ذلك المدعو الذي يطرد في كلِّ مرة.
لقد سرق الإنترنت البدويّ الأبَّال من خيمته، والقرويّ النخّال من مزرعته، لقد غيّر المجتمع في لمحة عين، وكأنما جاء بالسِّحر.
كنت أرقب الإنترنت رقابة المريض لنبضهِ، وأحرص عليه حِرص المؤمن على فرضه، وأفديهِ فداء الشَّريف لعِرضه، كنت مُتغطرفًا في مشيتي: عندنا إنترنت.
كان الحاسوب مُربّع الشَّكل، شاشتهُ صفراء فاقعٌ لونها، مع سوادٍ خفيف يشوب أطرافها، وهنالك عسلٌ مندلق على زِرِّ المسافة.
وإذا انطلق صوتُ المودم في معالجة الإتصال، أشعر وأنني في آلةِ سفرٍ عبر الزَّمن، الرحلة غامضة، والمحطة الأولى موقع أينَ!!.
كنت أطالع موقع أين ساعةً، أقلِّبُ ناظري فيه، أتفحّص أيقوناته، أعمدته وألسنته، كانت حركة الماوس بحنو أصابع حورية على تطوف على ظهري.
كان أخي ونقيضي يجلس بجواري، ويقول لي: "كلّم ناس، كلّم ناس"، كُنا نعرف أن في الإنترنت أُناسًا لكن أين هم؟!.
كنت أقرأ لوالدي مقالات الخُفّاش الأسود، أجلس أمام الحاسوب وأقرأ، ووالدي يتلمَّظ قهوته تارة، ويشْرق بها من الضحك تارة أخرى.
بدأت المنتديات جولتها، ودارت صولتها، سجّلت في أوِّل منتدى عام ٢٠٠١م تقريبًا، كان مالِكه شاب لعائلةٍ ثريةٍ فاحشة الثراء.
أول موضوعٍ لي كان عن نادي النصر؛ وجدتهُ مُثبّتًا، لم أنم تلك الليلة، كنت أتخيل صيحات المعجبين والمعجبات تحت وسادتي، وأبتسم بتغطرس.
عند الظهر، وجدت المُشرف حَذف موضوعي، ثم عدّله ليكون عن الهلال، أعاد طرحه باسمهِ، وثبّته، ثم حذف عضويتي من المنتدى برمّته، طردني!.
كانت صدمةً لي، استجمعت ما بقي فيّ من قُدرات شيطانية، ومواهب إجراميّة، استعنت بالله، شمّرت عن الأسلاك، وبدأت حَربه.
كنت أدخل منتداه عند منتصف الليل، وأعيث فيه فسادا، أضع صورًا خليعة، أُكرر، أشتم الأعضاء، وهكذا…حتى أقفل منتداه.
تكوّنت عندي فكرة بعد هذه الحادثة، أنَّ غالبية المنتديات أوكار وشاية، ومواطن غواية، كُن الإناث يسرحن ويمرحن في المنتديات.
غالبية المنتديات عند التسجيل تظهر لك كمدينة يوتوبيا، وبعد التسجيل تغدو كقرية عند قيامِ السَّاعة، ليس فيها إلا شِرار الخلق.
مما شَهِدتهُ إبَّان عصر المنتديات، أستطيع القول: أن المرأة السعوديّة خطرةٌ جدًا، أخطر من امرأة العزيز، وكيدها ذروة سنام الكيد.
الرجل إذا استخفّ لأجل امرأة يصير كائنًا سَمِجًا، ثقيلًا، ولا يمكن بَلْعه، أما المرأة إذا تظرَّفت فتغدو مثل حصوة كلوية.
أمضيتُ سنواتٍ أبحثُ عن إكسير الحياة، وحجر الفلاسفة، ورجلٍ يصمد أمام امرأة، وامرأةً خفيفة الظِّل، المستحيلات بأُمِّ عينها.
كانت المنتديات الثقافية غارقة في قعر بحر التكلّف، والمنتديات الساخرة تطفو فوقه كجثّةٍ أزكمت الأنوف بزهمها، ومنتديات الحوار كُلُّها خُوار.
كتبت الشِّعر، كنتُ أدفعُ شِعري على كُرسيٍ مُتحرِّك من كثرةِ كسوره، وأدفعه إلى قِسم العِظام الأدبي، كان شَعرًا في عظمةِ السَّاق.
كتبت مواضيع مُخجلة، كنت أتمنى هجمةً سبتمّبريّة ثانية تقصدُ غرف الخوادم التي تحفظ غثائي وتُردّدهُ كالأُرْغُن.
كنت أنقل مواضيعي من منتدى إلى آخر كالمرأةِ المُطلقة، كنت حاطب ليل، وأعيد اجترار مواضيعي بتكرارٍ غير مبرر.
كانت الكِتابة المنتدويّة أسوأ تجربة بعد دخولي المدرسة، أذكرُ كاتبًا منتدويًا من أهلِ حائل، كنت أغبطهُ على ما حباه الله من بيان.
تعرّفت عليه، ثم قابلته، وفهمتُ أخيرًا مفاد العبارة المكتوبة على المرايا الجانبية للسيّارات: الأجسام في المرآة أقرب مما تبدو عليه في الواقع.
كان تياها بنفسه، يقرظ مكتوبه، ويشيد بردوده، ينوه إلى مفرداته، ويمجد استعاراته، وكأنه تشايكوفيسكي وهو يضع لمسته الأخيرة على كسارة البندق.
نشأت وأنا على يقينٍ من أن الكِتابة مِحنة لا مِهنة، آمنتُ أنه لا يمكن للكاتبِ سَبر أعماق النَّفس دون شعور، فكرة، ولغة، وحكمة يستعمل أفضالها.
الكتابة ليست بالعمل الودِّي، ولا بالجُهد الفردي، إن كتابة سطرٍ واحدٍ، تتطلّب منك نَهم مِرْياع، و ديمومة مذياع.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ولمن ذكروا في هذه العُجالة، وأخصُّ بذلك من بقي منهم على طبعه لم يتبدل.
تمَّت.
@matabalsadi99 دارت*
@umdalal100 سعسع الليل أي ذهب وولّى، أما عسعس الليل فيعني أقبل وجاء.
@RedhaAttome رحم اللهم من فضح وخفّف 😊
@alsuleem03 بنفس معرّفي هنا، ووالله إني مقلّ فيه.
@Abduxllah1
أخلف الله عليك وقتك الذي خسرته، 🌹.
أخلف الله عليك وقتك الذي خسرته، 🌹.
@soproudy "زكية زكريا"، هذا مِسكٌ ذاكٍ: أي ساطع الرائحة، صار الصحيح مستغربًا.
@ali_alfaifi يكفيني هذا الليلة 🌹
@AAlsaiem نصيحتك محل تقدير، شرّفت المكتوب وصاحبه.
@77Rheel لأن الحزن يطل بوجهه الشّاحب بين التغريدة وأختها.
@as64611 حياك الله، شرّفتني وأسعدتني، أنا مغمور ابن مغمور.
جاري تحميل الاقتراحات...