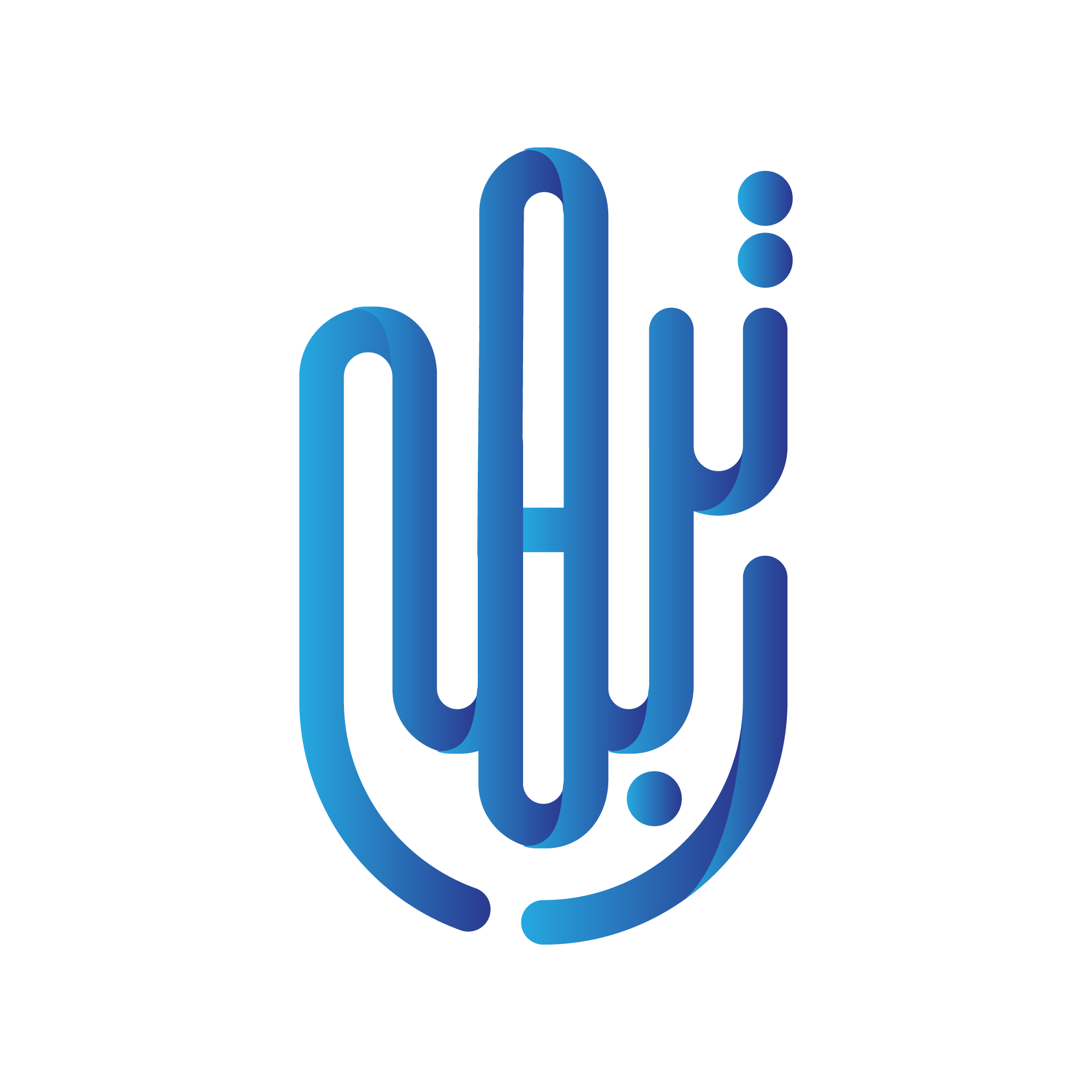يقول الكاتب محمد أمير ناشر النعم في مقالة له بعنوان: السيرة الذاتية مصدراً لسيرة الآخر:
"يقول غوته في كتابه (من حياتي: الشعر والحقيقة): "وقد يحسن في محاولةٍ لكتابة السيرة الذاتية أن يتحدث المرء عن نفسه".
للوهلة الأولى حملت هذه الجملة على محمل الفكاهة التي تنبلج على شكل متقطّع من سماء وقار غوته، فتنسكب في رشاقة على مشهده النصي كلّه، وتخرجه، للحظات، من تطقّمه الرصين إلى لبسة المتفضّل، وتضفي على رزانته وفخامته طلاوةً ورقةَ حاشية.
كان غوته أحد أهم مؤسسي فن كتابة السيرة الذاتية، حيث رأى أنّه يحب أن يكون فنّاً مستقلاً من فنون الكتابة الأدبية، وكان أحد أهم منظّريه الأوائل، فارتقى به من فن ّكتابة اليوميات إلى فنّ كتابة السيرة الذاتية.
وقد شرعت، فيما بعد، أعي أنّ غوته كان أبعد ما يكون عن التظارف والتفاكه في هذا القول، وبدأت أتلمّس فعلاً كلّما جلتُ في السيَر الذاتية كيف أنّ المؤلف الذي يُفترض به أن يقف أمامنا وجهاً لوجه، وأن يحدّثنا عن نفسه وذاته يسترسل في حديثه عن الآخرين، فلا يكتفي بكتابة سيرته الذاتية فحسب، بل يتعدى ذلك لكتابة سيَر للآخرين في تلافيف سيرته.
عندما يذكر لنا الكاتب إعجابه بشخص ما أو بغضه له، أو نفوره منه يورد مسوغات هذا الإعجاب، ، ويورد ما يؤكد نظرته ورؤيته أو انطباعه، فنحن أمام ملخصات نقدية مكثفة، تقدم لنا إضاءات على غاية في الأهمية، ويجب علينا عندئذ أن نضع هذا الكلام عن هذه الشخصية أو تلك في موضع الحسبان، مع تفريقنا البدهي بين ما هو معلومات وبين ما هو انطباعات أو تخيّلات، وتفريقنا بين مستويات الكتّاب أنفسهم ومؤهلاتهم وملكاتهم ودرجاتهم.
يمكننا أن نقرأ سير أحمد أمين أو عباس محمود العقاد في سيرة عبد الرحمن بدوي، ويمكننا أن نقرأ سيرة هوايتهد ونطلع على دخائل حياته في سيرة برتراند راسل، وبين يديَّ سيَر ذاتية عديدة هي أنموذج لما نحن فيه، ولكن تتبّع ما فيها يفضي بنا إلى كتابة كتاب لا مقال! من أجل ذلك نكتفي ههنا بإشارات مقتضبة حول سيرة ذاتية لمؤلف عزيز على قلبي هو شتيفان تسفايغ الذي نقع عنده على معلومات تخص سيَر الآخر تتفاوت أهميتها من العادية إلى شديدة الأهمية بحسب مكانة الشخص لديه، فنقرأ حديثه الممتع عن راينر ماريا ريلكه الشاعر النمساوي الحداثي الرومانسي البوهيمي، ونقرأ عن الشاعر والرسام الإنجليزي وليام بليك المتوفى سنة 1827، الذي أنكره مجايلوه، وأهملوه واحتقروا إبداعه، ثم غدت أعماله صوىً مرشدة في الشعر والفنون البصرية، فهو "ذلك العبقري الوحيد والإشكالي الذي ما زال خذلانه وكماله السامي يفتناني حتى اليوم"! ونقرأ عن تعرّفه جيمس جويس، ووصفه المفصّل لمظهره الخارجي، ونعرف عن معارفه في فقه اللغة مما لا نعرفه من مصدر آخر، ونقرأ حديثه الأكثر متعة ووصفه الفاتن للفنّان النحّات الفرنسي أوغست رودان فبعد تناول قصة لقائه به وعلاقته معه، ووصفه لمشغله، وكيف أن الفنان العظيم وقف أمامه يعدّل في تمثال كان يشتغل عليه، وأنه من فرط تركيزه واستغراقه نسي وجود تسفايغ بجانبه، وعندما انتهى مما هو فيه التفت فرأه واقفاً بجانبه فتفاجأ وذهل من وجوده. ويصف تسفايغ ذلك بهذه الكلمات المضمّخة بالوجد والانفعال: "لقد رأيت في تلك الساعة السر الخالد لكل فن عظيم، أجل لكل فنّ إنساني يتجلى فيه التركيز، ومجموع القوى كلها والأحاسيس كلها، وتلك الحالة التي يذهل فيها كل فنّان عن العالم. لقد تعلمت شيئاً رافقني طيلة حياتي".
من خلال هذه السيرة الذاتية نكتشف الصداقات الأمتن في حياته، والتي كانت مع رومان رولان، وسيغموند فرويد، وإميل فيرهارن. وهذا يعني أننا سنكون في إزاء سيرة هؤلاء أيضاً في تضاعيف سيرته.
أما إميل فيرهارن الشاعر البلجيكي الذي كان يزوره تسفايغ مرتين أسبوعياً حين مكث في باريس فنتعرفه معرفة مجملة، لكنها تكفي لكي نقدّر أهميته، وأهمية كونه أحد مؤسسي المدرسة الرمزية.
وأما رومان رولان فيورد تسفايغ معرفته به بوصفه اكتشافاً، وهو لا يتناوله أديباً فقط، بل كان بالقياس إليه صمام أمان لأوروبا كلها، باعتباره داعية السلام فيها، وكيف أنّه هو الذي قوّى هذا الجانب في تسفايغ نفسه. وإضافةً إلى كتب رومان الأدبية التي نعرف معظمها، وبعضها تُرجم إلى العربية، نقرأ معلومات مهمة عن نصّه (فوق المعمعة) الذي شنَّ فيه حملة على الكراهية الفكرية بين الأمم. ونقرأ عن اللقاءات العديدة بينهما. قبل الحرب العالمية الأولى، وبعدها، وعن نشاطهما المشترك، وعن الرؤى الموحَّدة، وحديثاً عن سجن رومان في سويسرا.
"يقول غوته في كتابه (من حياتي: الشعر والحقيقة): "وقد يحسن في محاولةٍ لكتابة السيرة الذاتية أن يتحدث المرء عن نفسه".
للوهلة الأولى حملت هذه الجملة على محمل الفكاهة التي تنبلج على شكل متقطّع من سماء وقار غوته، فتنسكب في رشاقة على مشهده النصي كلّه، وتخرجه، للحظات، من تطقّمه الرصين إلى لبسة المتفضّل، وتضفي على رزانته وفخامته طلاوةً ورقةَ حاشية.
كان غوته أحد أهم مؤسسي فن كتابة السيرة الذاتية، حيث رأى أنّه يحب أن يكون فنّاً مستقلاً من فنون الكتابة الأدبية، وكان أحد أهم منظّريه الأوائل، فارتقى به من فن ّكتابة اليوميات إلى فنّ كتابة السيرة الذاتية.
وقد شرعت، فيما بعد، أعي أنّ غوته كان أبعد ما يكون عن التظارف والتفاكه في هذا القول، وبدأت أتلمّس فعلاً كلّما جلتُ في السيَر الذاتية كيف أنّ المؤلف الذي يُفترض به أن يقف أمامنا وجهاً لوجه، وأن يحدّثنا عن نفسه وذاته يسترسل في حديثه عن الآخرين، فلا يكتفي بكتابة سيرته الذاتية فحسب، بل يتعدى ذلك لكتابة سيَر للآخرين في تلافيف سيرته.
عندما يذكر لنا الكاتب إعجابه بشخص ما أو بغضه له، أو نفوره منه يورد مسوغات هذا الإعجاب، ، ويورد ما يؤكد نظرته ورؤيته أو انطباعه، فنحن أمام ملخصات نقدية مكثفة، تقدم لنا إضاءات على غاية في الأهمية، ويجب علينا عندئذ أن نضع هذا الكلام عن هذه الشخصية أو تلك في موضع الحسبان، مع تفريقنا البدهي بين ما هو معلومات وبين ما هو انطباعات أو تخيّلات، وتفريقنا بين مستويات الكتّاب أنفسهم ومؤهلاتهم وملكاتهم ودرجاتهم.
يمكننا أن نقرأ سير أحمد أمين أو عباس محمود العقاد في سيرة عبد الرحمن بدوي، ويمكننا أن نقرأ سيرة هوايتهد ونطلع على دخائل حياته في سيرة برتراند راسل، وبين يديَّ سيَر ذاتية عديدة هي أنموذج لما نحن فيه، ولكن تتبّع ما فيها يفضي بنا إلى كتابة كتاب لا مقال! من أجل ذلك نكتفي ههنا بإشارات مقتضبة حول سيرة ذاتية لمؤلف عزيز على قلبي هو شتيفان تسفايغ الذي نقع عنده على معلومات تخص سيَر الآخر تتفاوت أهميتها من العادية إلى شديدة الأهمية بحسب مكانة الشخص لديه، فنقرأ حديثه الممتع عن راينر ماريا ريلكه الشاعر النمساوي الحداثي الرومانسي البوهيمي، ونقرأ عن الشاعر والرسام الإنجليزي وليام بليك المتوفى سنة 1827، الذي أنكره مجايلوه، وأهملوه واحتقروا إبداعه، ثم غدت أعماله صوىً مرشدة في الشعر والفنون البصرية، فهو "ذلك العبقري الوحيد والإشكالي الذي ما زال خذلانه وكماله السامي يفتناني حتى اليوم"! ونقرأ عن تعرّفه جيمس جويس، ووصفه المفصّل لمظهره الخارجي، ونعرف عن معارفه في فقه اللغة مما لا نعرفه من مصدر آخر، ونقرأ حديثه الأكثر متعة ووصفه الفاتن للفنّان النحّات الفرنسي أوغست رودان فبعد تناول قصة لقائه به وعلاقته معه، ووصفه لمشغله، وكيف أن الفنان العظيم وقف أمامه يعدّل في تمثال كان يشتغل عليه، وأنه من فرط تركيزه واستغراقه نسي وجود تسفايغ بجانبه، وعندما انتهى مما هو فيه التفت فرأه واقفاً بجانبه فتفاجأ وذهل من وجوده. ويصف تسفايغ ذلك بهذه الكلمات المضمّخة بالوجد والانفعال: "لقد رأيت في تلك الساعة السر الخالد لكل فن عظيم، أجل لكل فنّ إنساني يتجلى فيه التركيز، ومجموع القوى كلها والأحاسيس كلها، وتلك الحالة التي يذهل فيها كل فنّان عن العالم. لقد تعلمت شيئاً رافقني طيلة حياتي".
من خلال هذه السيرة الذاتية نكتشف الصداقات الأمتن في حياته، والتي كانت مع رومان رولان، وسيغموند فرويد، وإميل فيرهارن. وهذا يعني أننا سنكون في إزاء سيرة هؤلاء أيضاً في تضاعيف سيرته.
أما إميل فيرهارن الشاعر البلجيكي الذي كان يزوره تسفايغ مرتين أسبوعياً حين مكث في باريس فنتعرفه معرفة مجملة، لكنها تكفي لكي نقدّر أهميته، وأهمية كونه أحد مؤسسي المدرسة الرمزية.
وأما رومان رولان فيورد تسفايغ معرفته به بوصفه اكتشافاً، وهو لا يتناوله أديباً فقط، بل كان بالقياس إليه صمام أمان لأوروبا كلها، باعتباره داعية السلام فيها، وكيف أنّه هو الذي قوّى هذا الجانب في تسفايغ نفسه. وإضافةً إلى كتب رومان الأدبية التي نعرف معظمها، وبعضها تُرجم إلى العربية، نقرأ معلومات مهمة عن نصّه (فوق المعمعة) الذي شنَّ فيه حملة على الكراهية الفكرية بين الأمم. ونقرأ عن اللقاءات العديدة بينهما. قبل الحرب العالمية الأولى، وبعدها، وعن نشاطهما المشترك، وعن الرؤى الموحَّدة، وحديثاً عن سجن رومان في سويسرا.
أما سيرة فرويد فهي الأهم ههنا، لأنّ الكاتب كان أحد الشهود القلائل على أيام فرويد الأخيرة، عندما كانا كلاهما شريدين طريدين لاجئين في إنكلترا. " لقد عرفت فرويد ذلك الرجل العظيم البسيط الذي عمّق معرفتنا بالنفس الإنسانية، ووسّعها أكثر من أي واحد آخر"، والذي "كان متعصباً للحقيقة، مدركاً مع ذلك حدود الحقائق جميعها. قال لي ذات مرة: إنّ بلوغ الحقيقة المطلقة مستحيل استحالة بلوغ الحرارة درجة الصفر المطلق".
سيرة فرويد في سيرة تسفايغ هي قصة الدقة العلمية والشجاعة الأدبية: "يتروى في عرض القضايا حتى يجد البرهان القاطع، ولكنه لا تزعزعه معارضة العالم حين يطمئن إلى تحوّل فرضيته إلى يقين لا شكّ فيه. هو ذا رجلٌ مطالبه الشخصية بالغة التواضع، ولكنه كان مستعداً للقتال من أجل كل مبادئ مذهبه، ومخلصاً حتى الموت للحقيقة المتضمنة في نظرياته التي أثبتها".
"حين أبحث عن رمز للشجاعة الأدبية، البطولة الوحيدة التي يمكن أن يقوم بها الإنسان منفرداً على هذه الأرض، يمثل أمامي دائماً وجه فرويد الرجولي الوسيم الصريح، ذو العينين الداكنتين، والنظرة المحدقة الوادعة.
لقد تجرأ فرويد على التعبير دوماً عن أفكاره حتى لو علم أنّ المجاهرة الصريحة القاطعة بها قد توجع وتضايق، ولم يبحث قط عن مخرج سهل حتى بتقديم تنازلات سطحية، وأنا واثق أنّ فرويد لو كان ميّالاً إلى المسايرة فقال: (الرغبة الجنسية) بدلاً من (النشاط الجنسي)، و(الحب) بدلاً من (الدافع الجنسي)، واكتفى بالإشارة إلى استنتاجاته الأخيرة بدلاً من الإصرار المتشدد عليها دائماً لكان من الممكن أن يعبّر بلا عائق عن أربعة أخماس نظرياته أمام أية هيئة أكاديمية".
وهي سيرة أيامه الأخيرة ولحظاته الأخيرة، ولا أدري إن كنّا نقع على مثل هذا الوصف في أي مرجع آخر يتناول سيرة فرويد الذاتية! وفي هذا الصدد أذكر تلك الحادثة التي قصّها علينا تسفايغ: "وفي إحدى زياراتي الأخيرة اصطحبت معي سلفادور دالي، أكثر رسامي الجيل الشاب موهبة في رأيي، وكان يجلّ فرويد إجلالاً عظيماً، وبينما كنت أتحدث مع فرويد، انهمك دالي في تخطيط صورة له. لم أجرؤ على اطلاع فرويد عليها، لأنّ دالي قد أدخل الموت باستبصار فيها".
وسوف نقرأ في سيرة الآخر (فرويد) الوصف الأدق والأجمل والأكثر تراجيدية "فأنا لم أكن قط مدركاً ومقدّراً قيمة تلك الأحاديث الطويلة التي لا تعوّض أكثر مني في ذلك العام المظلم الذي قُدِّر له أن يكون آخر أعوامه [...] كان احتضاره لا يقل اتصافاً بالبطولة الأخلاقية عن حياته. كان فرويد قد عانى كثيراً من المرض الذي لم يلبث أن أخذه منّا، وكنّا نلاحظ أن سقف حلقه الاصطناعي قد جعل الكلام شاقاً عليه، ولذلك كنّا نعتذر عن كل كلمة يمنحنا إياها. ولكنه لم يدع كلمة تفلت. كانت كبرياء روحه الصلبة تحمله على أن يُظهر للأصدقاء أن إرادته ستبقى أقوى من أوجاع الجسد المبتذلة، وتقبُّض فمه من الألم. وبقي يكتب حتى الأيام الأخيرة، وحتى حين كان الألم يحرمه من النوم ليلاً، ذلك النوم العميق المتعافي الذي كان مصدر قوته طيلة ثمانين سنة، فإنه لم يقبل تناول جرعات منوّمة، أو أي نوع من المخدرات.
لقد أبى أن تغشّي هذه المهدئات صفاء ذهنه ساعة واحدة. آثر أن يكابد الألم، ويبقى متيقظاً. آثر التفكير وهو يتألم على عدم التفكير، وبقي بطل الروح حتى النهاية. كان الصراع رهيباً، وكلما طال ازداد مهابة. ومن يوم إلى آخر كان شبح الموت يتضح أكثر على وجهه. لقد غارت وجنتاه، وبرزت عظام صدغيه، والتوى فمه، وانعقد لسانه عن الكلام، ولم تُعجز (حاصد الأرواح الكالح) إلا عيناه، المرقب المنيع الذي أحدَّ منه العقل الباسل النظر إلى العالم. لقد بقي العقل والعين واضحين حتى اللحظة الأخيرة".
إننا أمام سيَر مصغّرة لذوات تكاد تندغم في مشاعرها وأحاسيسها وأفكارها في ذات الكاتب نفسه، ولذلك كان الحديث عن الكاتب لا يكتمل إلا بالحديث عنها.
إنَّ دوافع ذكر الآخر، وسرد شذرات من سيرته تختلف من كاتب لآخر، فبعضهم لا يرى نفسه إلا في مرآة الآخر، فيأتي ذكره عفو الخاطر منهمراً انهماراً ثابتاً، وبعض آخر يدعم ذاته ويعليها باقتناص ذكر الآخر إذا كان ذا شأن وقيمة ومكانة، فيستمد منه الشأن، ويقتبس منه القيمة، ويستلف المكانة، وقد نقع على كتّاب آخرين يرون في كتابة سيرتهم نُهزة لتصفية حساب فيه معنى التشفي والانتقام، أو معنى الادعاء والاتهام، أو معنى تعرية الستر، وهتك السر، تلميحاً وتلويحاً، أو إيضاحاً وتصريحاً، ولا نعدم في المقابل سيراً ذاتية تحتفي بالآخر على سبيل الامتنان والعرفان، وإبراز المحاسن والإشارة إلى مواطن الافتتان، وإشراك القارئ وإرشاده إلى مكامن الإبداع وحظائر البراعة.
ورغم اختلاف هذه الدوافع يظل ذكر الآخر في السيرة الذاتية أحد أهم مواطن اكتمال صورة هذا الآخر، لأننا سنقع على معلومات وأخبار وقصص وانطباعات لن نجدها، على الأعم الأغلب، في موطنٍ ثان.
سيرة فرويد في سيرة تسفايغ هي قصة الدقة العلمية والشجاعة الأدبية: "يتروى في عرض القضايا حتى يجد البرهان القاطع، ولكنه لا تزعزعه معارضة العالم حين يطمئن إلى تحوّل فرضيته إلى يقين لا شكّ فيه. هو ذا رجلٌ مطالبه الشخصية بالغة التواضع، ولكنه كان مستعداً للقتال من أجل كل مبادئ مذهبه، ومخلصاً حتى الموت للحقيقة المتضمنة في نظرياته التي أثبتها".
"حين أبحث عن رمز للشجاعة الأدبية، البطولة الوحيدة التي يمكن أن يقوم بها الإنسان منفرداً على هذه الأرض، يمثل أمامي دائماً وجه فرويد الرجولي الوسيم الصريح، ذو العينين الداكنتين، والنظرة المحدقة الوادعة.
لقد تجرأ فرويد على التعبير دوماً عن أفكاره حتى لو علم أنّ المجاهرة الصريحة القاطعة بها قد توجع وتضايق، ولم يبحث قط عن مخرج سهل حتى بتقديم تنازلات سطحية، وأنا واثق أنّ فرويد لو كان ميّالاً إلى المسايرة فقال: (الرغبة الجنسية) بدلاً من (النشاط الجنسي)، و(الحب) بدلاً من (الدافع الجنسي)، واكتفى بالإشارة إلى استنتاجاته الأخيرة بدلاً من الإصرار المتشدد عليها دائماً لكان من الممكن أن يعبّر بلا عائق عن أربعة أخماس نظرياته أمام أية هيئة أكاديمية".
وهي سيرة أيامه الأخيرة ولحظاته الأخيرة، ولا أدري إن كنّا نقع على مثل هذا الوصف في أي مرجع آخر يتناول سيرة فرويد الذاتية! وفي هذا الصدد أذكر تلك الحادثة التي قصّها علينا تسفايغ: "وفي إحدى زياراتي الأخيرة اصطحبت معي سلفادور دالي، أكثر رسامي الجيل الشاب موهبة في رأيي، وكان يجلّ فرويد إجلالاً عظيماً، وبينما كنت أتحدث مع فرويد، انهمك دالي في تخطيط صورة له. لم أجرؤ على اطلاع فرويد عليها، لأنّ دالي قد أدخل الموت باستبصار فيها".
وسوف نقرأ في سيرة الآخر (فرويد) الوصف الأدق والأجمل والأكثر تراجيدية "فأنا لم أكن قط مدركاً ومقدّراً قيمة تلك الأحاديث الطويلة التي لا تعوّض أكثر مني في ذلك العام المظلم الذي قُدِّر له أن يكون آخر أعوامه [...] كان احتضاره لا يقل اتصافاً بالبطولة الأخلاقية عن حياته. كان فرويد قد عانى كثيراً من المرض الذي لم يلبث أن أخذه منّا، وكنّا نلاحظ أن سقف حلقه الاصطناعي قد جعل الكلام شاقاً عليه، ولذلك كنّا نعتذر عن كل كلمة يمنحنا إياها. ولكنه لم يدع كلمة تفلت. كانت كبرياء روحه الصلبة تحمله على أن يُظهر للأصدقاء أن إرادته ستبقى أقوى من أوجاع الجسد المبتذلة، وتقبُّض فمه من الألم. وبقي يكتب حتى الأيام الأخيرة، وحتى حين كان الألم يحرمه من النوم ليلاً، ذلك النوم العميق المتعافي الذي كان مصدر قوته طيلة ثمانين سنة، فإنه لم يقبل تناول جرعات منوّمة، أو أي نوع من المخدرات.
لقد أبى أن تغشّي هذه المهدئات صفاء ذهنه ساعة واحدة. آثر أن يكابد الألم، ويبقى متيقظاً. آثر التفكير وهو يتألم على عدم التفكير، وبقي بطل الروح حتى النهاية. كان الصراع رهيباً، وكلما طال ازداد مهابة. ومن يوم إلى آخر كان شبح الموت يتضح أكثر على وجهه. لقد غارت وجنتاه، وبرزت عظام صدغيه، والتوى فمه، وانعقد لسانه عن الكلام، ولم تُعجز (حاصد الأرواح الكالح) إلا عيناه، المرقب المنيع الذي أحدَّ منه العقل الباسل النظر إلى العالم. لقد بقي العقل والعين واضحين حتى اللحظة الأخيرة".
إننا أمام سيَر مصغّرة لذوات تكاد تندغم في مشاعرها وأحاسيسها وأفكارها في ذات الكاتب نفسه، ولذلك كان الحديث عن الكاتب لا يكتمل إلا بالحديث عنها.
إنَّ دوافع ذكر الآخر، وسرد شذرات من سيرته تختلف من كاتب لآخر، فبعضهم لا يرى نفسه إلا في مرآة الآخر، فيأتي ذكره عفو الخاطر منهمراً انهماراً ثابتاً، وبعض آخر يدعم ذاته ويعليها باقتناص ذكر الآخر إذا كان ذا شأن وقيمة ومكانة، فيستمد منه الشأن، ويقتبس منه القيمة، ويستلف المكانة، وقد نقع على كتّاب آخرين يرون في كتابة سيرتهم نُهزة لتصفية حساب فيه معنى التشفي والانتقام، أو معنى الادعاء والاتهام، أو معنى تعرية الستر، وهتك السر، تلميحاً وتلويحاً، أو إيضاحاً وتصريحاً، ولا نعدم في المقابل سيراً ذاتية تحتفي بالآخر على سبيل الامتنان والعرفان، وإبراز المحاسن والإشارة إلى مواطن الافتتان، وإشراك القارئ وإرشاده إلى مكامن الإبداع وحظائر البراعة.
ورغم اختلاف هذه الدوافع يظل ذكر الآخر في السيرة الذاتية أحد أهم مواطن اكتمال صورة هذا الآخر، لأننا سنقع على معلومات وأخبار وقصص وانطباعات لن نجدها، على الأعم الأغلب، في موطنٍ ثان.
جاري تحميل الاقتراحات...