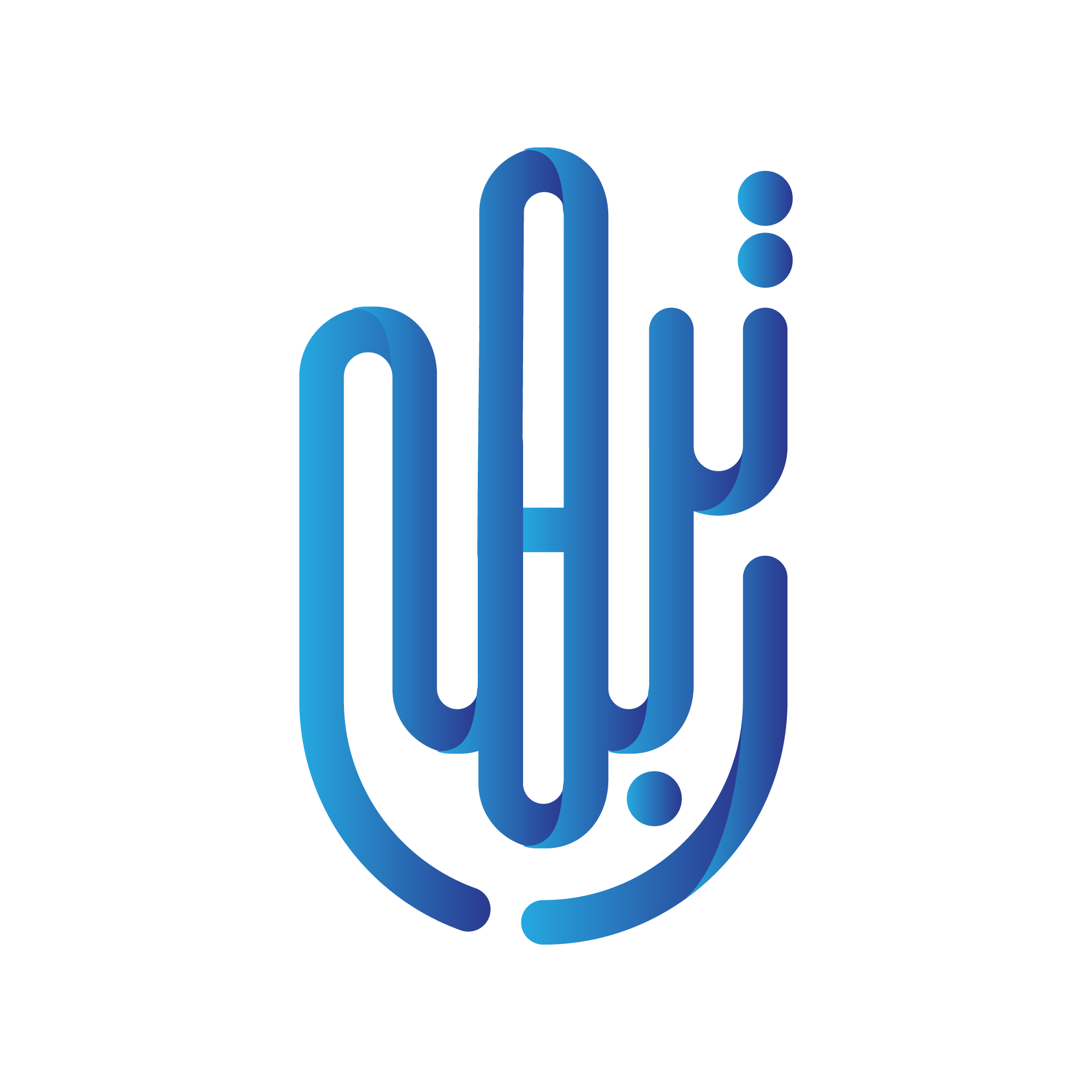الحادي عشرَ من سبتمبر 2009. تاريخٌ سيبقى مَحفوراً على ذاكرَتي إلى الأبدِ على مَا يبدُو. لا، ليسَت أحداثَ الحادِي عشر من سبتمبر، بل هُو تاريخُ اليومِ الذي غادرتُ فيهِ مطارَ الخُرطوم مُتجهاً إلى لندن لِأولِ مَرة. كانت الخطةُ وقتَها واضِحَةً وبسِيطة:
أن أمكُثَ عاماً واحداً لدِراسةِ الماجستير، ثم العودةُ إلى أرضِ الوطن بُغية العملِ في إحدى شركاتِ الاتصالاتِ أو التقنية رُبَّما. أحلامٌ كبيرةٌ لِفتىً في مُقتَبلِ العُمر، وُلِد بأم درمان وترعرع في أم بدة ودرسَ في مدارسِها ولعِب في حواريها.
(وأم بدة الثمانينات والتسعينات مختلفةٌ جِداً عن أم بدة هذِهِ الأيام - لمن يعرف!). ودعتُ والديّ وأشقائي وانطلقتُ على أملِ اللقاءِ القريب.
جلستُ على مقعدِ الطائرةِ وبجانبي رفيقي في الرحلةِ الطويلة صديقي الدكتور الخلوق جِداًّ أحمد خيري، وأنا أسترجِعُ شَرِيطاً من الذكرياتِ التي أوصَلتنِي إلى تِلكَ اللحظة. الأعوامُ (السنوات؟) الخمسةُ التي قضيتها في المدرسةِ القرءانيَّة بمجمعِ الرخا الإسلامي بأم بدة.
أصواتُ أستاذ الخير وشيخ عبدالجليل الكاروري راعي المدرسة وقتَها - أمدّهُما الله بالصحةِ والعافيةِ - ترِنُّ في أذني وهما يُكرّرَان على مسامعنا ونحنُ بعدُ في السابعة من العُمر: "هدفُنا إِعدادُ الطبيب الحافِظ لكتابِ الله، والمهندس الحافظ لكتاب الله، والطيار الحافظ لكتاب الله".
كنتُ أُغمِضُ عينيّ أحياناً وأنا أتخيل نفسي طياراً أو طبيباً حافظاً للقرءان - على الرغم من أنني لم أكُن أعي تماماً معنى تِلك الرسالة. أتذكرُ اللوحَ والدّوَاية، وحلقة الرّمية في النهار، والتُقابَة، والجمعية الأدبية في المساء.
ثلاثية الشقة المُرّة، والعُودَة المُرة والعُودَة الحِلوة. الفلقة والعلقة وسوط العنج. أتذكرُ شيخ أحمد الكاروري يقتطعُ من وقتهِ ليقوم بتحفيظِنا أهازيجَ لا أظنها تنمحي من ذاكرَتِي مهما طال عليها العهد:
ﻫﺪﺃَ ﺍﻟﻠﻴﻞُ ﻭﻏﺎﺭﺕ * ﻓﻲ ﻋﻼﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ
ﻭﻛُﺆُﻭﺱُ ﺍﻟﺬﻛﺮِ ﺩﺍﺭﺕ * ﻋُﺮﻓُﻬﺎ يَغشَى ﺍﻟﻔُﻬُﻮﻡ
ﻣﻦ ﻣَﻌَﺎﻧِﻴﻬَﺎ ﺇﺳﺘَﻨَﺎﺭﺕ * ﺃﻧﻔﺲٌ ﻛﺎﻧﺖ تَهُوﻡ
ﻭﺇﻟﻲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦِ ﺳَﺎﺭﺕْ * مِلءُ ﺟَﻨﺒَﻴْﻬﺎ ﺍﻟﻌُﻠﻮﻡ
ﻭﻛُﺆُﻭﺱُ ﺍﻟﺬﻛﺮِ ﺩﺍﺭﺕ * ﻋُﺮﻓُﻬﺎ يَغشَى ﺍﻟﻔُﻬُﻮﻡ
ﻣﻦ ﻣَﻌَﺎﻧِﻴﻬَﺎ ﺇﺳﺘَﻨَﺎﺭﺕ * ﺃﻧﻔﺲٌ ﻛﺎﻧﺖ تَهُوﻡ
ﻭﺇﻟﻲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦِ ﺳَﺎﺭﺕْ * مِلءُ ﺟَﻨﺒَﻴْﻬﺎ ﺍﻟﻌُﻠﻮﻡ
لم تكن تلك الأيام كلها جميلة. رأيتُ فيها أشياء لا تزال تؤرقني إلى هذا اليوم. وبعد هذا، فمن كان يَملِكُ أن يُدرِجَ أبناءَهُ في مَدرسةٍ قُرءانية فليفعل. لكن أبقِ عينك مفتوحَة، فالزمان قد تغير.
مدرسة بشير محمد سعيد الثانوية. أستاذ مالك وأستاذ محجوب وأستاذ بشير العوض عليه رحمة الله. كرة القدم التي كنا نلعبها في رابعة النهار في حوش الخليفة وميدان الربيع في حي العباسية.
أذكُرُ أنني قرأتُ مقالاً للكاتب الأستاذ جمال عنقرة في أحدى الصحف عام 1998 ربما، يتحدث فيه عن سوء الحظ الذي لازمَهُ حيثُ أنه كلما شجّعَ فريقاً رياضياً أو لاعباً كانت عاقبته الهزيمة والانتكاس.
كان ابنه قد قُبِلَ في نفس المدرسة في ذلك العام، وكان هدف المقال أنه يتمنى أن يزول عنه سوءُ الحظ حتى لا تُمنى المدرسةُ التي قُبِل فِيها ابنه بإحدى تلك الانتكاسات. الحمد لله، كلانا انتهى متفوقاً وطالباً في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
جامعةُ الخرطوم. وما أدراك ما جامعةُ الخُرطوم! عشتُ فيها الحياة الجامعية بطولِها وعرضِها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. كسرةُ القلبِ الأولى كانت هُناك، خيبةُ الظن الأُولى في بعض من ظننتُهم أصدقاءَ عُمرٍ كانت هناك.
لَعِبتُ الشطرنج في كافتيريا هندسة وكافتيريا جيولوجيا، و لعبتُ كُرَة القدم في الملعبين الشرقي والغربي، نشطت في العمل السياسي الطلابي وترشحت للاتحاد وخسرت، ومارست الأعمال الخيرية في عدد من المنظمات الطوعية.
جربتُ فيها كل ما استطعتُ تجربته، وارتكبتُ الكثيرَ من الحَمَاقات! تعرفتُ فيها على أناسٍ هم من خِيرة شباب وبنات السودان الذين قابلتهم في حياتي، وآخرين لا داعي لذكرهم.
عملتُ مُساعِد تدريس وقضيتُ الليالي الطوال في مكتب دكتور فايز عليه رحمة الله في إعداد الشهادات الجامعية ومراجعتها. تخريج الإبداع وكلماتُ الشيخِ المرحوم محمد سيد حاج عليهِ رحمةُ الله الذي شرَّفَ حفلنا المُتواضِع. وهذا غيضٌ من فيض.
أفتحُ عينيّ بغتة، ديسمبر 2022. نحواً مِن أربعَة عشرَ عاماً مرّت، وأنا لا أزالُ هُنا. لستُ أدري أين ذهبَ كلُّ هذا الوقت. الماجستير أردَفتهُ الدُكتوراة، فالنفسُ أمارةٌ بالسوء! على الرغم من خطتي البسيطة الواضحة آنفة الذكر، حدّثَتنِي نفسي إن أربعَ سنواتٍ أُخَر بعد الماجستير
لن تُكلِّفَني الكثير، بل ستفتحُ أبواباً عديدة في "المستقبل"، فطاوعتُها. عنفُوانُ الشباب والرغبة في إنجازٍ ظننتُ واهماً أن لم يسبقني إليهِ أحد. عشت الحياة الجامعية مرة أخرى بطولها وعرضها في جامعة نوتنغهام. كسرةُ قلبٍ أخرى وخيبات ظن أُخَر.
لعبتُ الشطرنج وكرة القدم، ونشطت في العملِ السياسيّ الطلابي وترشحتُ للاتحاد مرة أخرى وفزت هذه المرة!
ثم بعد الجامعة أخذت تُراودني نفسي مرة أخرى أن أبقى بضع سنوات بعدُ للحصولِ على "الخبرة" وربما أيضاً المُواطَنَة البريطانية لعل أبواباً أكثر ستُفتحُ في "المستقبل".
ثم بعد الجامعة أخذت تُراودني نفسي مرة أخرى أن أبقى بضع سنوات بعدُ للحصولِ على "الخبرة" وربما أيضاً المُواطَنَة البريطانية لعل أبواباً أكثر ستُفتحُ في "المستقبل".
لا أدري بالضبط أين هو هذا المستقبل الذي أضعت في انتظاره أربعة عشر عاماً من عمري أتجولُ بينَ حَوَاري وأزقة نُوتنغهام ولانكاستر ومانشستر، برفقة بعضِ الطيبين، والكثيرِ من "الضلاليين".
انتهى بيَ الحالُ أستاذاً في جامعة. وها أنذا. أجلس في مكتبي في الجامعة هنا في الخامسة فجراً - أنا هنا منذُ الأمس - أكتُبُ هذا المقال بعينينِ نصفِ مُغلقتين (أو نصفِ مفتوحتين - على حسب فلسفتك الخاصة في الحياة)، وأنا لا أكاد أعرفُ نفسي.
درجة الحرارة تُراوِحُ الصفرَ في الخارِج، تدنُوهُ حِيناً وتَعلُوهُ أحياناً. سجلاتُ طلابٍ تنتظرني لوضعِ العلاماتِ عليهَا وأنا لا رغبة لدي في النظر إليها على الإطلاق. كلماتُ أستاذ الخير وشيخ الكاروري ترنُّ حولي في كل مكان، ترقبُني من بعيد، باشمئزازٍ على مَا أظُن.
حياةُ الحداثةِ والصخب التي عشتُها هُنا ترسمُ في مُخيلتِي شخصاً آخر لا أدري ما غايتُهُ في الحياة بالضبط معظم الوقت. تجربة زواجي القصيرة التي لم يُكتب لها الاستمرار أثرت فيَّ بِطَرِيقَةٍ لم أتوقعها - كنتُ أظنُّ نَفسِي أَقوى قليلاً مِن هذا الحالِ الذي أنا عليه.
أتخيلُ نفسي كحصانٍ بريٍّ كُتِبَ عليهِ أن يَقضي سنواتٍ طويلةً من عُمُرِه محبوساً في ثلاجةٍ ضيقةٍ باردةٍ لا تمكنُهُ من مجرد أن يمُد ساقيهِ. لستُ مُكتئباً أو يائساً الآن - يتسلل إليّ بعضٌ من ذلك أحياناً، لكني أشعر بأني مُكبّل، ولا أدري بماذا بالتحديد.
حسناً. "الكُشتِينَة دي لازم تتشك وتتوزع من جديد".
حتى وإن أدّى ذلِك إلى أن تُمطِرَ السّمَاءُ حَصىً كما يَقُولُون!
دعواتكم..
حتى وإن أدّى ذلِك إلى أن تُمطِرَ السّمَاءُ حَصىً كما يَقُولُون!
دعواتكم..
جاري تحميل الاقتراحات...