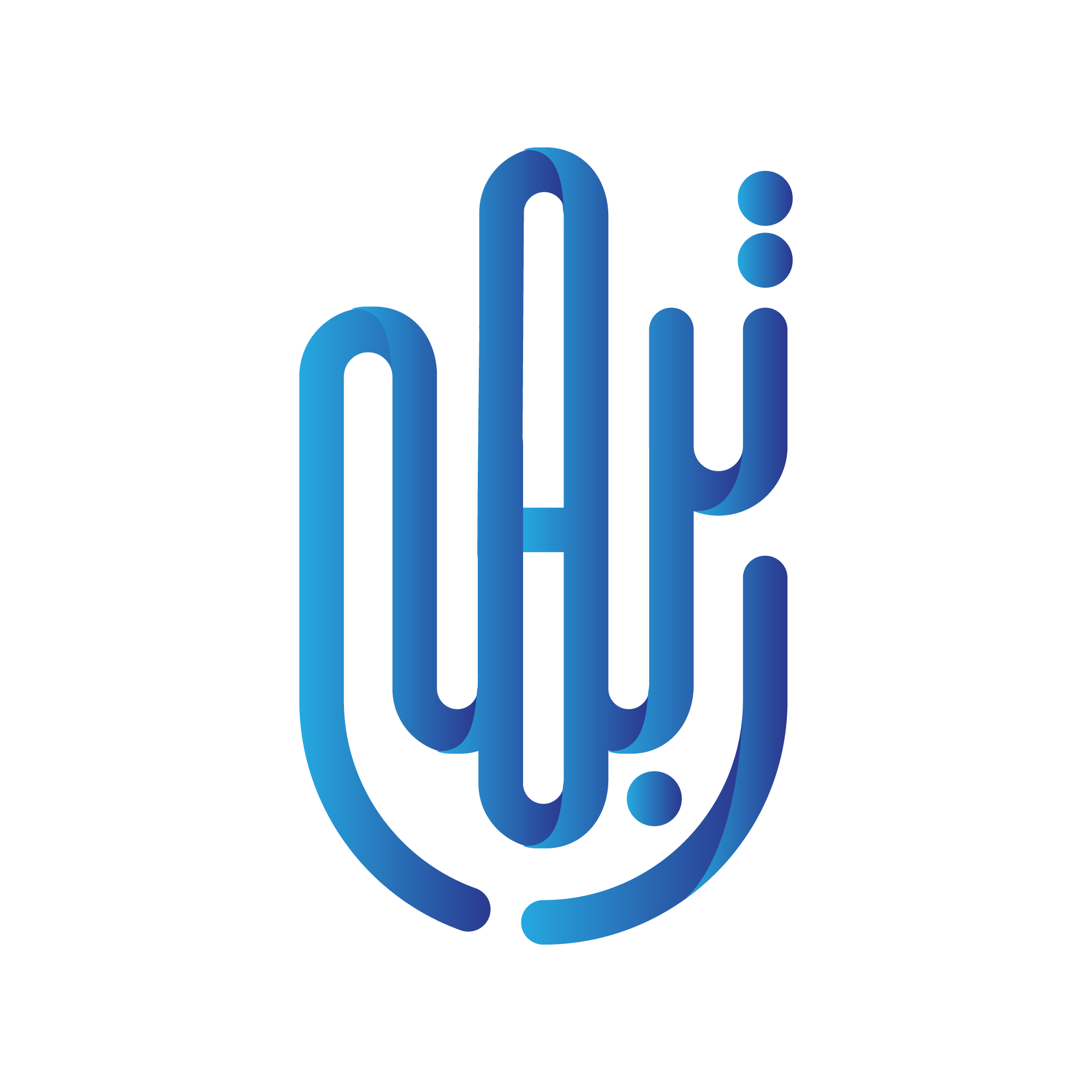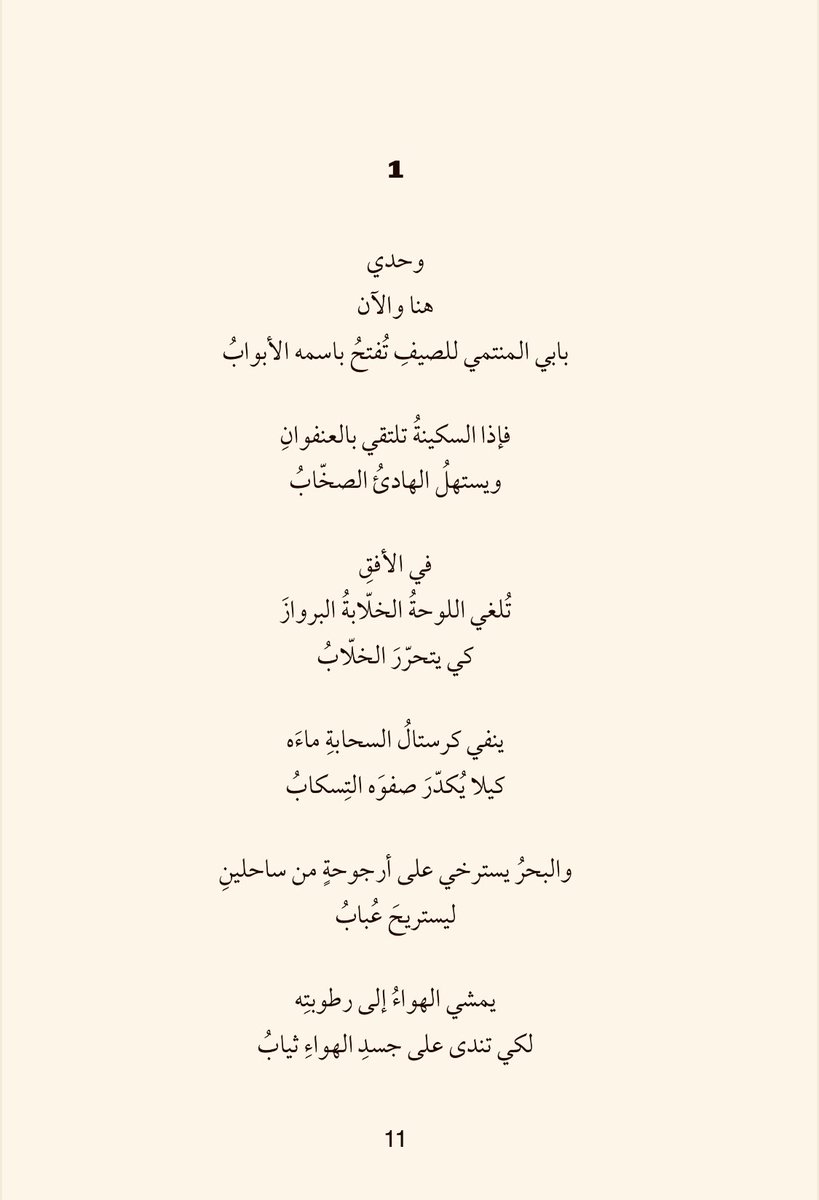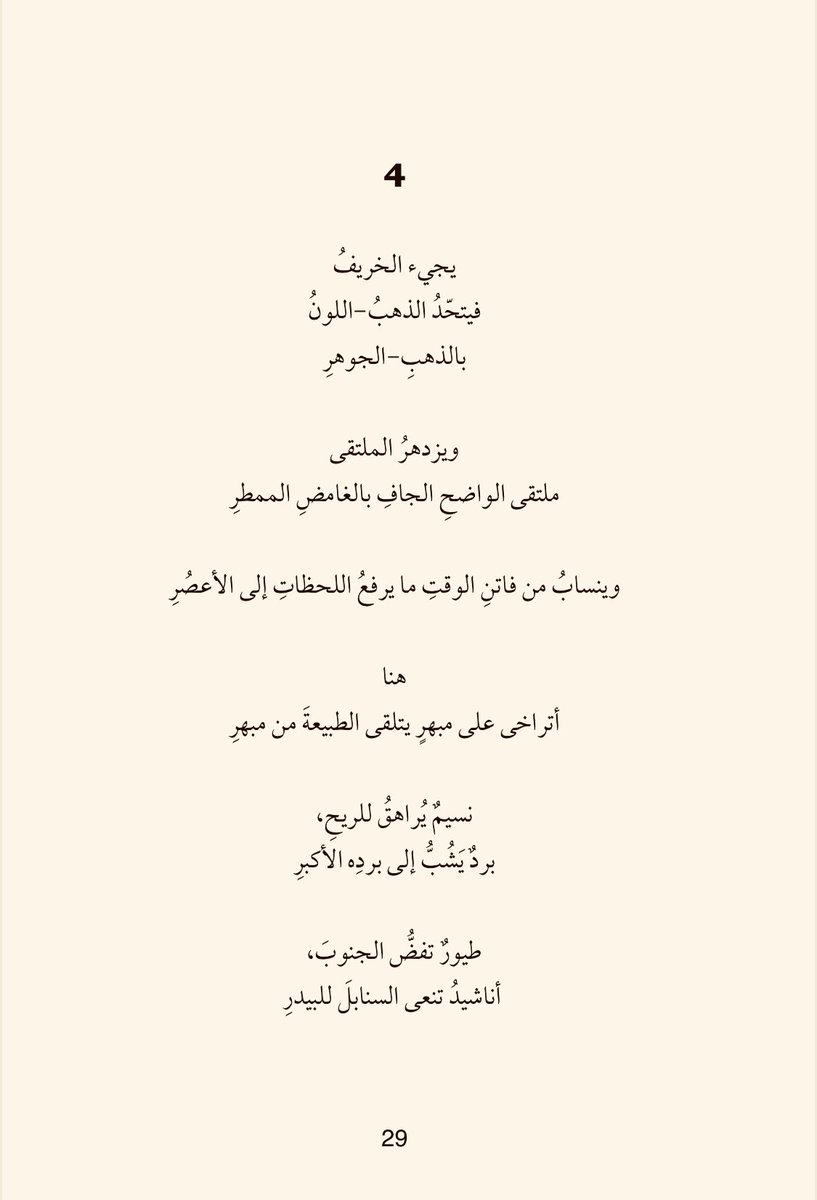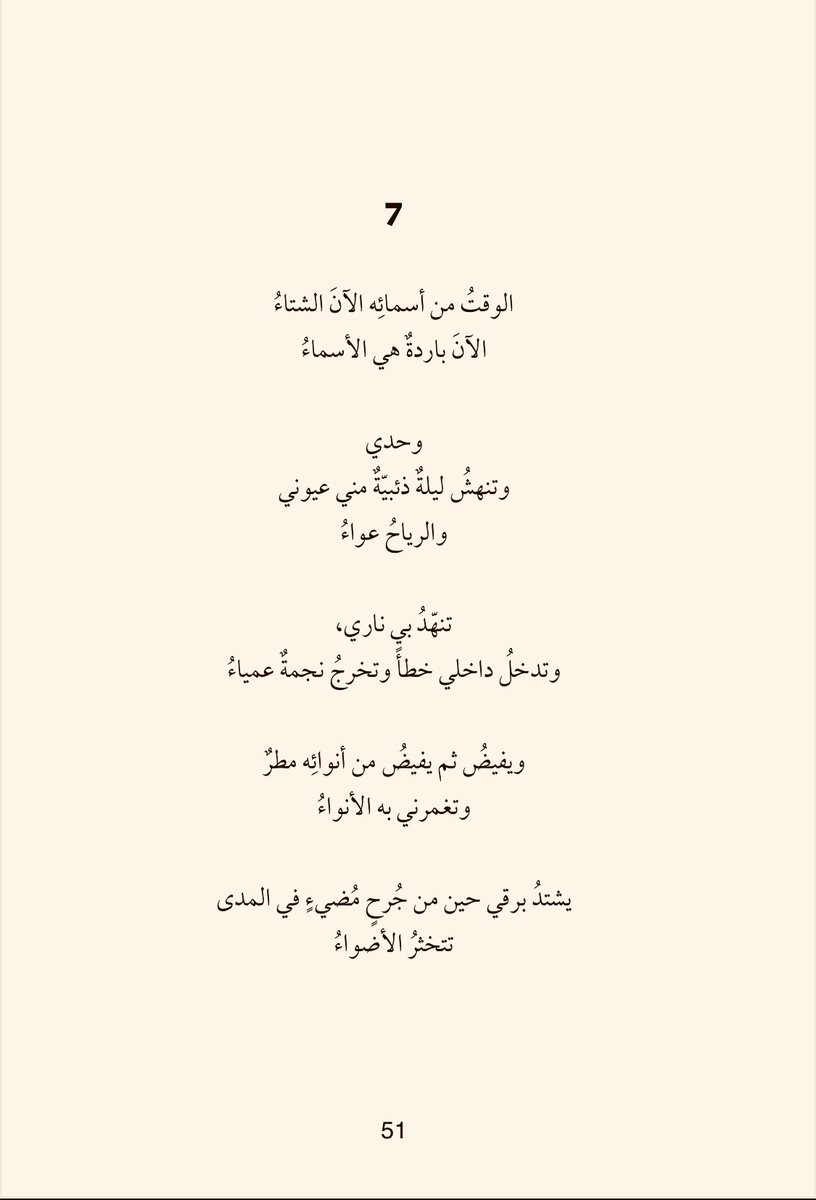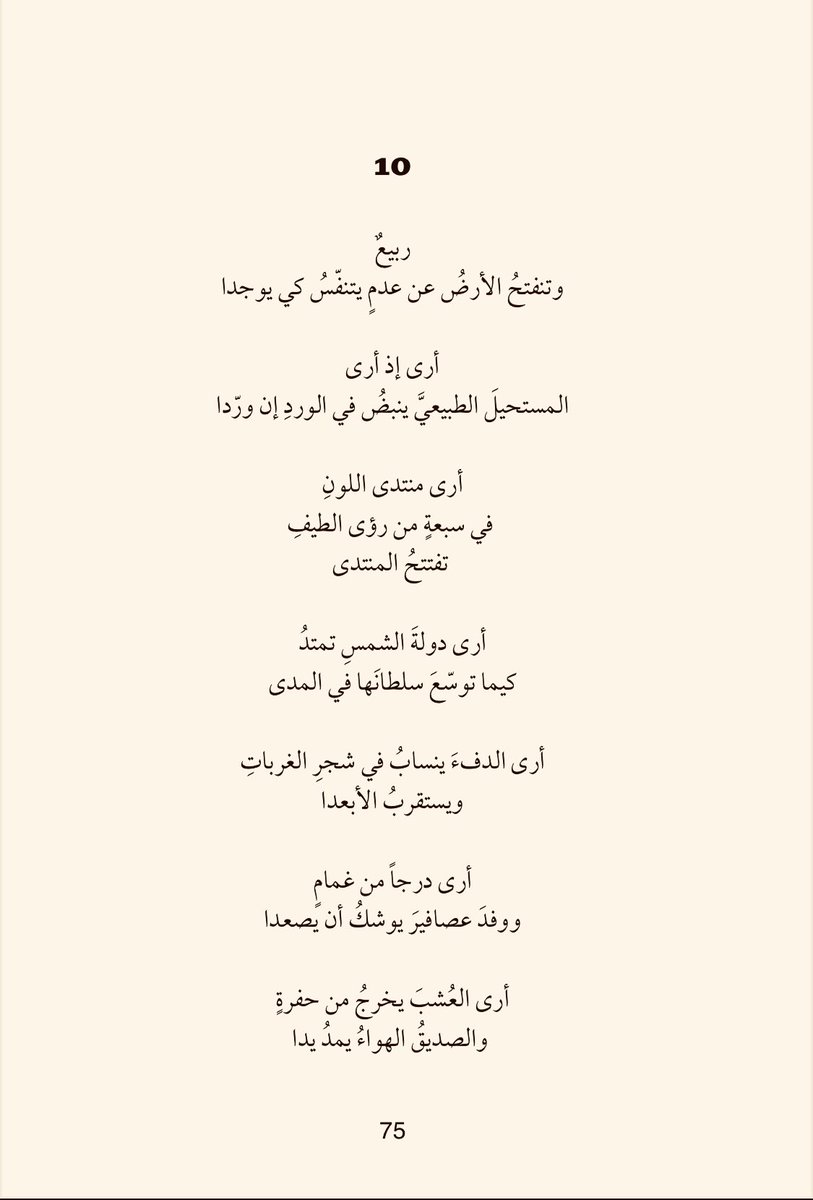أما هرقليطس، فعلى النقيض من مواطنه بارمينديس، كان يؤمن أنّ التغيّر هو الجوهر الأساسي للكون، وأنّ كل شيء في حالة تدفّق وصيرورة بما في ذلك الزمان والمكان، لذا صاغ مفارقته الشهيرة: لا تستطيع أن تعبر نفس النهر مرتين، ليس لأن النهر تغيّر بعد مرورك فقط، وإنما لأنك أنت أيضًا تغيّرت.
وأما درويش، فلقد فاته أنّ التقنيات والأغراض قد تتنقل بين الأجناس بأريحية، فكما تتسع الرواية للشعرية والفلسفة والتاريخ والجغرافيا يتسع الشعر، وكما يستفيد الروائي من تنويع الرواة وأزمنة السرد، يبدأ شاعرنا في منتصف الحدث ثم يرجع، ويعالج فكرة الراوي العليم وهو ما يزال الراوي المباشر.
يخبرنا عبد الباري أنّ قصيدته كُتبت في نيويورك ما بين يونيو ٢٠٢٠ - مايو ٢٠٢١. إذن نحن إزاء قصيدة طويلة مما يذكّر بجدارية درويش، وهي مكتوبة في نيويورك مما يذكّر بلوركا، لكنّ الأهم من كل ذلك أنها استغرقت عامًا وهو أمرٌ سيظهر شكلانيًا، فنحن إزاء شاعر يفوق درويش ولوركا هوسًا بالشكل.
كيف يمكن لعبد الباري أن يكتب قصيدة تمتد خمسًا وتسعين صفحة دون أن يتورّط في رتابة الإيقاع؟ كيف له أن يعكس دورة الفصول وثيمة التغيّر والجريان دون أن يوقعه تنويع التفاعيل في النشاز؟ اختار لذلك حلًا بسيطًا، وعبقريًا، ولا يخطر إلا على باله: سيبني قصيدته على تفعيلتين ويراوح بينهما.
تتكون القصيدة من أربعة فصول واثني عشر جزءًا، عدّة فصول وأشهر السنة، وتراوح الموسيقى ما بين متفاعلن للصيف وفعولن للخريف، متفاعلن للشتاء وفعولن للربيع، وداخل كل فصل يراوح بين الاستخدام الخليلي ثم الحرّ ثم الخليلي للتفعيلة، وهكذا يعكس دورة السنة وتتابع الشهور دون أن يتورط في نشاز.
قبل أن أشرع في القصيدة، أؤكد على نقطة ذكرتها سابقًا، هي الاستمرارية والتتابع في مشروع عبد الباري، فهذه القصيدة لن تُفهم إلا بعد قراءتنا لديوان خساراته السابق «لم يعد أزرقًا» فبعد أن خسر نفسه ثم حبيبته ثم أهله كي يكسب صوتًا جديدًا، ها هو يراوح أمام مدينة الدنيا جاهزًا للجديد.
تنثر الشمس أشعّتها فإذا لكل شيء ظلٌ يحادثه، ويسترخي البحر مرهقًا فإذا الساحل يهفو إلى ساحل، ويتحرّك الهواء باحثًا عن رطوبةٍ تصاحبه، إنه موسم «المثنى» بامتياز، لا مكان للوحدة الآن، وهو ما سيفتح العالم الداخلي على الخارجي؛ فإذا بمدينتين: لاهبة وظليلة، وإذا بسماءين: ملهمة وعالية =
وإذا بشمسين: مقلقة وصاهرة، وإذا بعشبين: فوق الهضاب وعلى حائط الروح. يقول محمد عبد الباري: لي في المكانِ مدينتانِ مدينةٌ * حمراءُ يخفقُ فوقَها اللّهابُ * ومدينةٌ أخرى تشيّدها الظلا * لُ بها النسائمُ من هوايَ عِذابُ * فوقي سماءانِ التي عن صحوها * المنداحِ يكشفُ غيمُها المُنجابُ =
ثمّ السخيّةُ بالمسافةِ حينما * مني يرفرفُ طائرٌ جوّابُ * شمسانِ لي شمسٌ -وتوضحني- بها * يمتدّ من قلقِ السؤالِ جوابُ * شمسٌ وتصهرُ نفسَها وشعاعُها * ذهبٌ على جسدِ المكانِ مُذابُ * عُشبانِ لي عُشبٌ بريءٌ حين تلب * بسُ ثوبَ أخضرها الجديد هضابُ =
عُشبٌ خبيرٌ حينما في حائطي * المهدومِ يكبر وحده اللبلابُ؛ إلى آخر الثنائيات التي تدفعه دفعًا للتواصل مع الآخر، ورغم أنّ أول من يتبادر إلى الذهن هو الآخر الأجنبي، غير أن شاعرنا يفضّل التواصل مع الآخر الذي تركه خلفه، ذاته التي اطّرحها وراءه، أو ذواته التي يطّرحها كلما دخل في الريح.
ها هنا مفارقة ذكية ومحزنة؛ تهفو ذات الشاعر المنتشية بطقس المثنى إلى الآخر، لكنّ ذاك الآخر يعود بها إليها، في دورة قصيرة وعاجزة تذكّر بالدورة الزمنية الأكبر، وهذا يرجعنا إلى أول أبيات القصيدة وأهم الثنائيات جميعًا: هنا والآن، الزمان والمكان، فلو توقفت الحركة لما كان ثمة قبل وبعد.
ثم يعمد عبد الباري إلى خدعتين شعرية وسردية، كي ينتقل برشاقة إلى ثاني أقسام الصيف، فيتحرر من المبنى التناظري للكامل دون أن يترك تفعيلته، ويرجع إلى لحظة دخوله نيويورك بعد أن رأيناه يجرّب صيفها، وهكذا نتبعه وهو يتهادى بشعلته المضاءة من هوى الأفق القديم إلى هوى الأفق الجديد.
كل ما في هذا الجزء يصرخ: «مرحى»، فنحن ما زلنا في الصيف، ونشوة الجديد لم تفارقنا بعد، شاعرنا الذي سأم من الخيال والتجريد وصمت القلب والوجوه الموروثة يريد أن تذوّبه نيويورك في مزيجها الحارّ، أن تهبه معنًى جديدًا، أن تدخله مهرجانها الدائم اللمعان، حيث الغواية والإثارة وأضواء النيون.
لذا يعقد الشاعر مع نيويورك صفقة: أن تحرره من الخيال والتجريد، ويحررها من المجسّد والمادي. ما إن يوافق الطرفان، حتى يبدأ الشاعر أعماله؛ فإذا بالشمس تسيل من قارورة عسل، والفراشة يتلوّن ظلها مزدهيًا، والتماثيل توشك على الغناء، والنوافذ تطير إلى البحر، والأبواب تمشي متنزهة على النهر.
ثم يرجع عبد الباري إلى بحر الكامل، فيذكّرنا أنّ هذا الضيف الذي يريد التحرر من ذواته السابقة لا يستطيع أن يتنكّر للحريق الذي تركه خلفه، فهو يحمل أسباب الدخان معه: كوشٌ على سبأٍ أرنّت سومرٌ * ذابت وغابت في الرمال مؤابُ * والقيروان ذوت وتحت الجامع ال * أموي سنّ ظلامه السردابُ.
لكنّ ضيف نيويورك الجديد هذا يدرك أنه ليس ضحية وطنه، أنه يحمل الضحية والجلاد في تكوينه، هو لا ينحى باللائمة على أحد، وما أجمل اعتذاره لوطنه حين قال: جرحُ الأحبّة أبيضٌ والآن من * خلفي يزيد بياضيَ الأحبابُ * إن كنتُ في وطني أموتُ فربما * في رفِّ مكتبةٍ يموتُ كتابُ؛ بيتان ساحران.
وألمسُ ألمسُ رقّة خاط *رةٍ بعدُ بالبالِ لم تخطرِ * أذوقُ أذوقُ البياض الذي ي * تناقضُ في الملح والسُكّرِ * أشّمُ أشّمُ احتراقَ المسافَ * ةِ في عابرٍ شاخ في معبرِ * وأسمعُ أسمعُ حتى دويَّ * ملامسةِ الريش للمرمرِ؛ يحسّ الشاعر بجاذبية الرجوع إلى الأصل، بتساقط الأوراق نحو التربة =
بتقهقر الغابة إلى القفر، بتراجع الياقوتة إلى سرّها الأحمر. ها هو يدركه فصل الموت والفناء، فيشعر بالرقّة والتحول والسعة: أنا الآن أشعرُ أنّ الحريرَ * بمثلِ حريريَ لم يشعرِ * وأنّي التحوّلُ في مظلمٍ * آخذٍ في الترقّي إلى نيّرِ * وأنيَّ أوسعُ من عالمي * وقد يغرقُ البحرُ في المبحرِ.
إن كان يريد التناهي في نيويورك، والتخلّي في متاجرها، والجلوس بين ناطحاتها، فيحسن أن يترك هذه المناظر الطبيعية ويتحول إلى نيويورك الحديد والفولاذ، حيث هارلم، وسنترال بارك، وكولمبوس سيركل، وتايمز سكوير، وامباير ستيت، ووول ستريت، وجسر بروكلين، وتمثال الحرية، لكنّ كل واحد من مظاهر =
الحضارة تلك يذكّره أن البربرية أخت الأناقة لا في الملابس فقط إنما في القلوب أيضًا. يتملّكه إحساس قوي بالنفور، ورغبة أقوى بالخروج، وكم كان بارعًا حين قسّم مشهده الليلي إلى ثلاثة أقسام: أول الليل متهاديًا بين المشاة، ومنتصف الليل لاهثًا ووحيدًا أمام معالم نيويورك، وآخر الليل =
منفردًا بالأرق، إلى أن يلقى تلك المرأة المصيرية كالموت، الشفّافة كاللهب، المبكّرة كالندى، الغامضة كالهواء، الطليعية كقصيدة، النادرة كطمأنينة، فيسلّم نفسه إليها وإلى سعار اللذة والتوق والحسّ، ويكون ذلك الاستسلام ضربًا من الموت والخروج الوحيد الممكن من بوابة العصر، حيث يراوح.
هذا التناظر يمتد إلى عوالم الشاعر الخارجية والداخلية، فالرياح والأنواء والبروق والرعود تعصف في الخارج والداخل، ومثلها بياض الثلج، ذلك اللون المتصوف، المرح، الكئيب، الغامض، الوضّاء، النادر، السلس، البريء، الموسمي، المسرحي، الشاعر، الحكّاء، إنه يفترش شوارع نيويورك ويفترش روحه أيضا.
إذن ليس أمام شاعرنا إلا الجلوس إلى طاولة الكتابة: يا فجأةً يفدُ الزحامُ على الفرا * غِ ومنزلي يحتلّه الغرباءُ * تحمرُّ طاولة الحوار ولا محا * ورَ لي ومني تذهب الآراءُ * من غير قاصٍ تختلي بي قصةٌ * وبلا مغنٍ يستهلُّ غناءُ * وبلا قصائد أو نساءٍ في الخيا * لِ تهب فيّ قصائدٌ ونساءُ =
رغمَ الزحامِ أنا وحيدٌ وحدتي * تكفي ليظمأ في البحيرةِ ماءُ؛ والبيت الأخير رائعٌ جدًا، فكل هؤلاء الندماء الذين يسامرهم في خياله لا يزيدون وحشته إلا وحشة، وكل هذه القصائد التي تتدفق من قلمه قد تطرب غيره لكنها لا تطربه، ولو نقعت القصائد غُلّة شاعرنا لتوقف عن النتاج بالكليّة.
ثم تخاطب نيويورك عاشقها الجديد محذرةً وناصحة؛ الأجدر به أن يعود إلى الشرق من حيث أتى، وكما جاء مع الرياح زحفت هي إلى البحر. يتجسم تحذيرها أشباحًا ستة تزوره تباعًا: وباء كورونا، أنقاض برجي التجارة، زيف التاريخ والحضارة، أدواء أمريكا، الحنين إلى الأوطان، طفولته البعيدة القريبة.
أبدع عبد الباري ما شاء وهو يصف مجموع أدواء أمريكا الحديثة ويشرّحها: بحثها المستميت عن المعنى، رأسماليتها المتوحّشة، مثقفون منفصلون عن الواقع، ناشطون حوّلوا الديمقراطية من صراع يسار ويمين إلى سياسة هويّات، لاجئون يتخلون عن مبادئهم لنيل حق اللجوء، ومشرّدون لا يجدون سقفًا يظلّهم.
ثم أبدع أكثر وهو يتابع الشبح السادس إلى القسم الخاص بطفولته وسيرته الذاتية: في النصفِ من أعمال برج الجديِّ جئ * تُ لوحشةِ البشريِّ فيمن جاؤوا * ذاق الترابُ الماءَ شعّت في المنا * قلِ فكرتي الشفّافةُ السمراءُ * قبل انغراسِ الأرضِ فيَّ تطايرت * بي في انفلاتاتِ الرياحِ سماءُ.
هذا الجزء من أبرع ما كتبه شاعر عن نفسه، وميلاده، وسيرة بحثه، وكشوفاته: أنّ هنا وهناك شيء واحد، الخطوات والأخطاء تتطابق أثناء السفر إلى المعنى، الزمان دائري وفي كل دورة ثمّة اختمار، وأنه سينتهي ضمن الخاسرين. لقد خذله أفلاطون، خذله أرسطو، خذله ابن سينا، خذله الغزالي.
لقد حاول الرسو في ميناء لكن سفينته الحجريّة غرقت، جرّب الطيران كالطيور لكن الإعياء أسقطه، جرّب التضوّع في حديقة لكنّ الأزهار أنكرته. وهكذا لم يبق إلا الموت أو الفناء في ذات الخالق، أن يعود إلى الصوفية بعد إعلان فشلها في ديوان سابق، فإذا به يبتهل بصوتٍ لم يبلغ هذا الصفاء من قبل:
يا آخذَ الأحباب للأحباب قل * بي مطفأ لكن هواي مضاءُ * سبّحت لألأء الحقيقة فيكَ حت * تى غاب بي عن نفسيَ اللألاءُ * خذني إلى عنوان سيناءَ المعا * صر غيّرت عنوانها سيناءُ * فمتى يشير الفيض للفيّاض كي * نحو المشيّأ تصعد الأشياءُ * ومتى يعود إلى مياهي زمزمٌ * ومتى إلى جبلي يعود حراءُ.
يقول عبد الباري: هو البعثُ يا لسجونِ الترابِ * وقد حرّرتْ جسدي المُجهدا * نعم إنّ قبريَ خلفي ومن بي * نِ كل القبورِ عليهِ ندى ؛ ثم يضيف وكأنّ الصورة الأخيرة لم تكن غريبة ما يكفي: أنا أستعيد ترابي ومائي * وأخلق من كل أمسٍ غدا * أُعِدّ طقوسَ الولادات كيما * أحاول منيَ أن أولدَا.
ثم يبارك لحظة الاستضاءة، عندما ينكشف المتخيَّل في المتجسِّد، والمستحيل في الممكن، حين يكتشف أنّ بضاعة هذا المكان الذي يلهث أهله باستمرار هو الزمان. يشير إلى تاكسي ويركب، ويدور حديث مع سائقه، في واحد من أكثر مقاطعه استفادةً من تقنيات السرد، وعبر نغمٍ يذكّر بأغنية الكعكة الحجريّة.
يسأله سائق التاكسي من أين هو، فيجيبه أنه من الصحراء. يستفهم إن كان يوجد شيء هناك، فيقول: نعم الفراغ، وحرية تجد في ذلك الفراغ متسعًا. يسأله إن كان واجه صدمة حضارية أول انتقاله إلى نيويورك، فيقول مستنكرًا إنه لم ير حضارةً هنا، فالحضارة كالشمس، تشرق في الشرق وتغرب في الغرب.
يا لذكاء التشبيه! يا لبراعة الصياغة! ما سبق ليس معنًى ساذجًا ولا عزاءً كاذبًا، بل تبصرٌ بطبيعة الوقت الدائرية وبمصائر الدول والحضارات: "يا سيدي، الغرب ليس سوى وجهة، بينما الشرق معنى!". يسأله سائق التاكسي: لماذا جئت إذن؟ يقول: كي أصبح قادرًا على فصل أشعة التنوير عن نزعة الإبادة.
ويمضي الحوار على هذا النمط، يسأله عن الفردانية فيجيب أنه يحبّذها طالما سعت للارتقاء داخل جنسها، ويبغضها حين تتجاوز خارج نوعها وتوقع في الشذوذ، يسأله عن تهمة العنف المنسوبة إلى شرقه فيصحح أنّ أصل كل ذلك جاء مع الاستعمار، حيث اكتسب العنف فصاحته من اللغات الأوربية.
يسأله صاحب التاكسي -وقد أُخِذ بفصاحته- عن أصل اللغة الجارحة التي يستعملها، فيجيب مفاخرًا أنها لغة الجرأة المستحيلة، وحين يفجّر فيها الخيال (لاحظ اختياره مفردة يفجّر بعد سماعه كليشة العنف) عندها يسيل الحنين على نصف مليار قلب. ادّعاءٌ كبير لم يكن ليزعمه لو لم يعِ أنه شاعر عصره.
يسأله السائق إن كان يتذكّر أول يوم في نيويورك، فيجيب أنّ ما يتذكّره هي أمه وحواري الرياض، ويجرفه الحنين، فيطلب أن يأخذه إلى المتماسك من نيويورك كي يودّعه: متحف الميتروبوليتان، أندية الجاز والبلوز، مسارح برودوي، محكمة العدل، منهاتن، إلى أن يمضي إلى باب الخروج أخيرًا، إلى المطار.
ثم تنحسر المشاهد السابقة: تخفت المدينة، تبرد المصابيح، تذوب الخطى، يتراجع النبيذ، تحمرّ المسافات، تتصاعد النسور وهي تحلّق إلى الشرق، منبع الوحي والفن. أي نعم، الشرق طلل، لكنه طلل يعدّ لمستقبل. أي نعم، لا راهن سوى الدمار وصوت الشاعر، لكنه صوتٌ سيلتقي بوطنه ليس الآن، إنما في الأبد.
ماذا وقد انتهت القصيدة؛ ألم تتسع للشعرية والفلسفة والتاريخ والجغرافيا وكل الأشياء التي كان درويش ينعى خفوتها في الشعر؟ نعم فعلت، وفعلت باقتدار، لكنّ الأهم من كل ذلك تصدّيها لأحجية هرقليطس، وإثباتها إمكانية عبور النهر مرتين، فقد تعيدك عملية العبور إلى ذاتك السابقة!
إنها أغنية لا تفضّل الشرق على الغرب أو العكس، إنما تحاول فهم دورة الزمان وصيرورة الأشياء، إنها لا تمجّد الثبات أو تنافح عنه، إنما تتغنّى بالتغيّر الذي يجعل نقطة الإنطلاق تبدو مختلفة حين تكون نقطة عودة. لكن، بربك يا عبد الباري، وبمنطق هرقليطس، كيف سأستمرئ الشعراء بعد سماعي أغنيتك؟
جاري تحميل الاقتراحات...