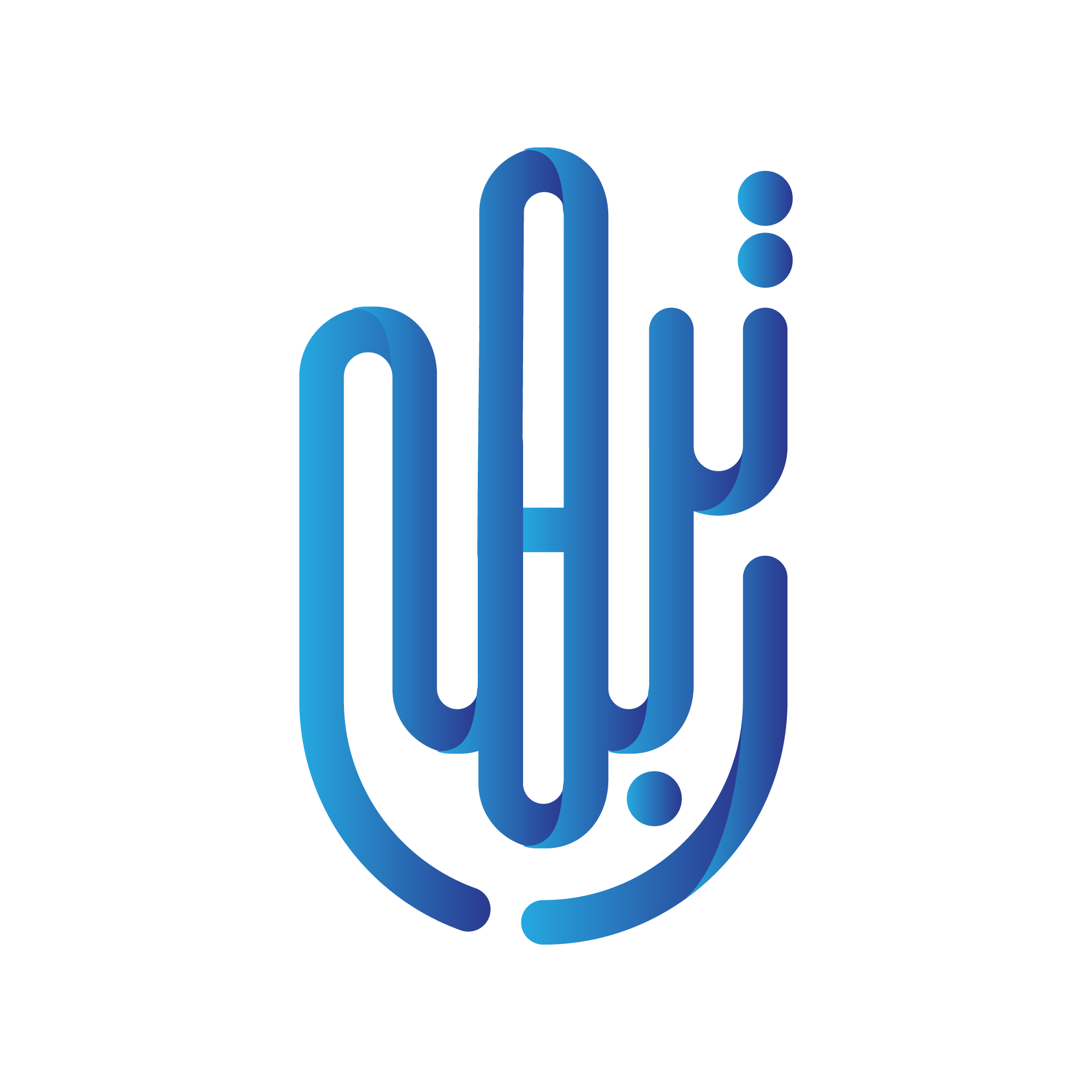جاء الإسلام هاديا للناس في مسارين أساسيين، ومحاسبا على الانحراف فيهما، وهما (مسار المعرفة ومسار السلوك) ومن الناس لم يفهم شمولية الإسلام لهما فتجده يقول (لا يضر اعتقادك بأي شيئ طالما أنك على سلوك حسن) وهذا ظلم للإنسان وللسلوك وجهل بالإسلام.
إن الانحراف المعرفي لا يقل خطراً عن الانحراف السلوكي، وإن الإسلام الذي حرّم الغش والشذوذ والظلم حارب الخرافة والجهل والتصورات المعرفية الخاطئة، بل إنه جعل طريق الانحراف المعرفي موصلا إلى النار بدرجة أشد من السلوكي: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"
والقرآن لفت انتباه الإنسان إلى أن الانحراف المعرفي ظلم قد يفوق الظلم السلوكي، فقال (إن الشرك لظلم عظيم).
فالذي يأخذ تغليظ الإسلام للظلم السلوكي دون تغليظه للظلم المعرفي لا يكون قد فهم القرآن حقا، وكذلك العكس، إذا إن من الناس من ينكر الظلم الاعتقادي ولا يهمه الظلم في باب السلوك.
فالذي يأخذ تغليظ الإسلام للظلم السلوكي دون تغليظه للظلم المعرفي لا يكون قد فهم القرآن حقا، وكذلك العكس، إذا إن من الناس من ينكر الظلم الاعتقادي ولا يهمه الظلم في باب السلوك.
وإذا كان الإنسان مؤمناً بالقرآن ثم هو يوهِم غير المؤمن بأنه لا مشكلة عليه طالما أننا متسامحون سلوكيا فهذه خيانة له؛ لأنه لم يسع إلى تحذيره من الهلكة التي تنتظره في نهاية طريقه.
وإذا استدل بـ"لكم دينكم ولي دين" فذكّره باسم السورة وأول آية فيها (الكافرون) ليفهم سياقها فهماً صحيحاً.
وإذا استدل بـ"لكم دينكم ولي دين" فذكّره باسم السورة وأول آية فيها (الكافرون) ليفهم سياقها فهماً صحيحاً.
والفصام النكد بين المعرفة والسلوك إنما يدل على جهلٍ كبير بتأثير أحدهما على الآخر؛ إذ إن كثيرا من صور الظلم والطغيان السلوكي ناشئ عن الانحراف المعرفي، إما بعدم الاعتراف بالحساب، أو بسلوك ضروب من التأويلات المعرفية التي تبرر له ظلمه.
(أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعّ اليتيم)
(أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعّ اليتيم)
والخلاصة: أننا نحتاج إلى تأسيس معاييرنا التي نقيّم بها أصول نظرتنا إلى الإنسان وحاله ومآله من خلال القرآن الكريم: رسالة الله للبشرية، الذي جاء لصلاح أحوالهم (ولكن أكثر الناس لا يعلمون)
جاري تحميل الاقتراحات...