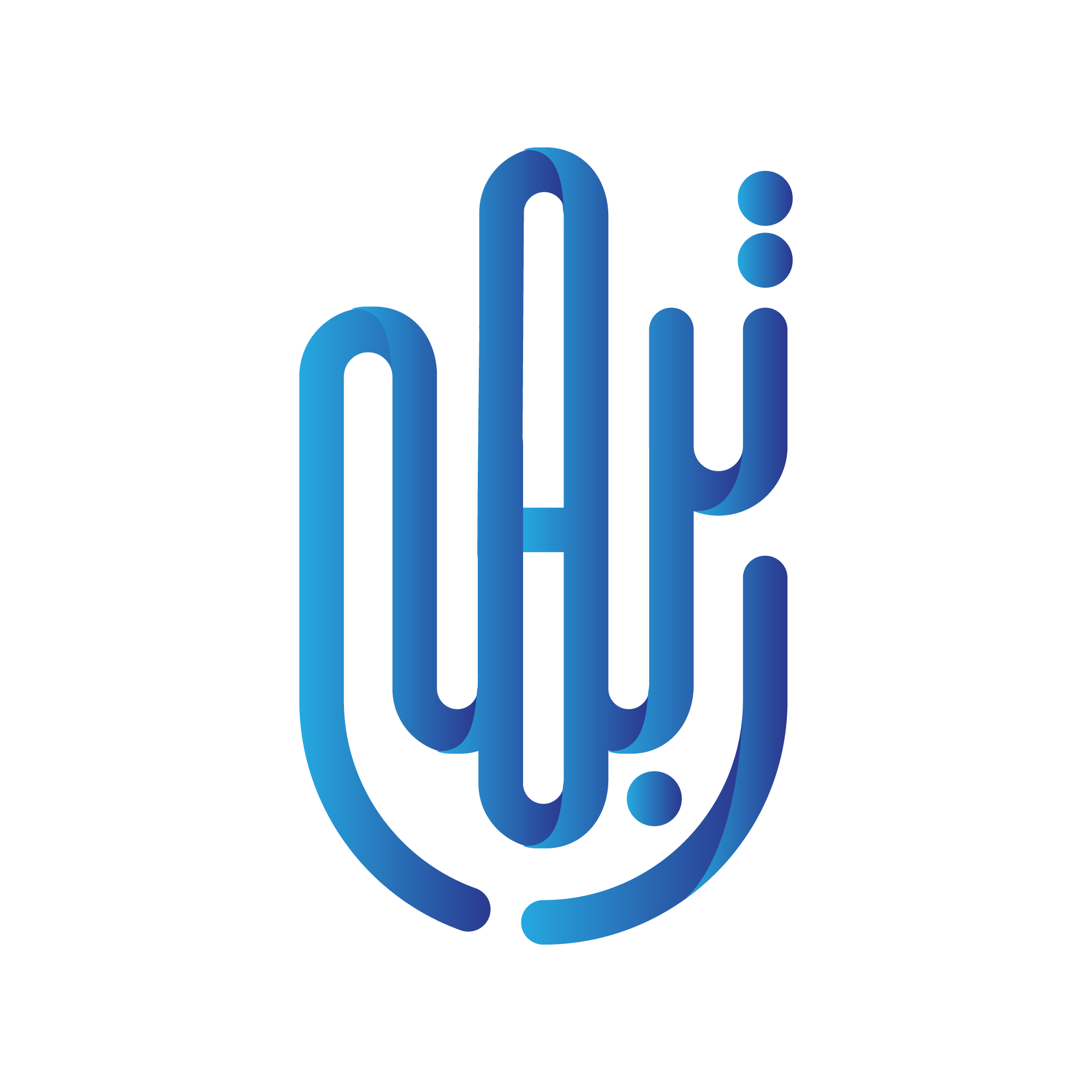في البداية، أُدرك تماماً أنّ أصابع الاتهام موجّهة إلي بذات السؤال: "كم مرة حبيت؟"، والإجابة لاتهم، مادُمت صادقاً في مشاعري تجاه كُل حُب.
في بورصة، مدينة جبليّة تقع على بعد ٢٥٠ كلم عن العاصمة اسطنبول. مكثت هُناك لعدّة أشهر، بأمل الدراسة.
كنتُ أظن اللغة التركيّة سهلة، كما أسمعها بالمسلسلات، واضحة المخارج، لاتحتاج إلى عناء.
رغم أنّها صعبة - بالنسبة لي كوني قد درستها لعدّة أشهر هُناك. إلّا أّنها من أجمل اللغات التي سمعتها وأكثرها شاعريّة.
كنتُ أعمل بأحد المقاهي المحلية، في حيّ كبير، يتّسع لهموم الأتراك. النوافذ والشُرفات كانت تحتضن صور أتاتورك.
كنت الـ"قهوجي"، أحضر الشاي التركي والقهوة التركية للزبائن، وأقدّمها لهم بينما يتحدثون سوياً.
كنت أتذمّر من عدم شربهم للشاي بكاسات كبيرة، يكتفون بأصغرها، ويطلبون كأس وراء كأس، مما يجعل العمل هُناك، صعب قليلاً.
حتى أنني سألت أحد أصدقائي عن السر وراء ذلك، وأخبرني أنّهم لو شربوا بكأس أكبر، يبرد الشاي قبل أن ينتهوا من شربه.
أحببت تلك التفاصيل، فهي توصف الأتراك بأفضل شكل. كنت أحب سماعهم وهم يقولون لي ”Eyvallah” أو "إي والله" بعد أن أقدم لهم القهوة والشاي.
على أيّة حال، كنتِ قد جئتِ مُتأخرة، في أيام عملي الأخيرة، وقبل مُغادرتي لتركيا بشهر.
والشاعر المُنهك بداخلي يُخبرني دائماً، أن الحُب وحده، من يسعه المجيء متأخراً، دون أن نطالبه بالإعتذار.
لم أكن مُعتاداً على خدمة النساء بالمقهى، فمعظم من يأتي إما مجموعة من اليافعين أو رجال طاعنين بالسن يظنّون أن الشاي يُنسيهم الماضي.
إذاً، هُنا كانت مأساتي، أنا الذي لا أتحدث التركية بطلاقة، وهي الّتي لاتعرف من العربيّة سوى سورة الفاتحة.
توجّهتُ إليها، وطلبت كوب قهوة، مع القليل من السُكّر. لم تعلم أن طلبها البسيط ذلك كان أكثر تعقيداً من دخول خمسة زبائن مختلفين إلى المقهى بالوقت ذاته.
منذ ذلك اليوم، حذفت جملة "يمكنني العمل تحت الظروف الصعبة" من الـCV الخاصة بي.
ذهبت إلى صديقي الذي يعمل معي، وأخبرته: "طلبت قهوة مع سكر قليل، كم معلقة سكر؟ كيف؟"
قررت أن أضع ملعقة واحدة، ووضعتُ لها فنجان من الطقم الذي كلّفنا المدير أن لانستخدمه إلا للزبائن المُهمّين.
لم أكسر قاعدة مدير المقهى. كنتِ مهمّة، بالنسبة لي. مهمّة للحد الذي وضعتُ به قطعتين من حلوى الحلقوم وقطعة شوكولا اشتريتها بنفسي.
صديقي لاحظ اهتمامي المُفرط بطلبك البسيط، وكنتِ نقطة ضعفي التي كان يبحث عنها ليبدأ بالسخرية.
أخذتُ الطلب على طبق فضي، وكنتُ أبتسم، بعد كل خطوة، بينما أتوجه نحوك.
وصلتُ إليك، ويدي ترتجف، وقلبي أيضاً. وضعت الطّبق على الطاولة، وكنتُ أنتظر، بلهفة، سماع جملة "إي والله" منكِ.
لم تبتسمي، ولم تنظري إليّ. كنت حتى تلك اللحظة أعتقد أنني وسيم إلى حد ما، وأنني أجيد التركية بما يكفي للفت الإنتباه.
ولكن تحطمّت ثقتي بنفسي، أمامكِ. عدتُ إلى صديقي، بلا ابتسامة، وأخذ يقول "والله مو ناقص غير انك تحب".
لم تنتهِ القصّة هُنا. أخبرته حينها: "ما أكون منذر لو ماكلمتها". ربّما أفقد ثقتي بما تعكسه المرآة، ولكنني لا أفقد ثقتي أبداً بالحديث.
أطالبكم متابعيني الأعزاء بمنحي عدة دقائق أدخّن بها وأسترجع ماحدث، فالقصة طويلة ولم تبدأ بعد.
حسناً، مرّت أعوام ولكن أتمنى أن أسرد ماحدث دون ترك فجوات، يكفي أن هناك فجوة في قلبي بسببك.
تمالكتُ نفسي، وعدتُ إليها بعد ربع ساعة، كوني الموظّف اللّبق، لأسأل ما إذا كانت ترغب بطلبٍ آخر.
أحياناً تختلط الرأسمالية بالحُب، ولكن السذاجة دائماً تكون المنقذ الوحيد، في المواقف الحرجة.
إذاً، ها أنتِ، بشعركِ الأسود المُنسدل، بالبنطال الضيّق، في المقهى الذكوريّ، هل كانت تلك شجاعة منك أم جهل؟
سألتكِ، ما إذا كنتِ ترغبين بطلبٍ آخر، لو كان بوسعي لسألتِك ما إذا كنتِ تودين المجيء إلى شقتي، ولأحضّر لكِ هُناك، القهوة، والشاي، والقصائد، والقبلات التي لاتنتهي.
ابتسمتِ حينها، بغرور، لايُناسب أي امرأة سواك. وسألتِني "من أين أنت؟" اعتذرت حينها وقلت أنني لا أجيد التركيّة بطلاقة. أكملت حديثي بالإنجليزية، وليتني لم أتحدث.
منذُ ذهابي إلى تركيا، لم أعثر على شخص يتحدث الإنجليزية، ظننتُ أنّك لن تفهمي ما أقوله.
ولكنّك بدوتِ سعيدة جداً، وأخذتِ تتحدثين معي، بلغتك الإنجليزية الثقيلة. كنتِ تُريدين أن تُثبتي نفسك، وهُنا أدركت أنني.. وسيم، أو مُبهر، إلى حدٍ ما.
استعدتُ ثقتي التي فقدتها منذ ربع ساعة، واعتذرت لكِ وقلت.. "يجب أن أعود للعمل"، فكما يسعك أن تكوني مغرورة، يسعني أيضاً أن أكون مغروراً.
عدتُ إلى صديقي بإبتسامة نادرة، تؤلم الوجه، ما إذا ارتسمت. أخبرته بما حدث، وأخذت انتظر، بكل لهفة، لحظة مغادرتها.
كان يوماً هادئاً، فالحياة متوازنة في النهاية، إذا كان قلبك مُضطرباً، تكون الشوارع خالية والمقاهي لايُسمع منها صوت اللعنات التي يتلفظ بها المُراهقين أو العجزة.
غادرتِ المقهى، وركضت نحوك إلى الخارج، ومشيت ببطء قبل أن أصل. "باردون"، قلت لكِ، والتفتِّ إليّ، وكأنّك لم تعلمي أني سأفعل ذلك. إنّها كذبتك الأولى.
"اسمي منذر، أدرس هُنا، وأعمل أيضاً.. كما رأيتِ"، جاء ردّك بالإنجليزية، وكأنّك تقولين لي أن التركيّة لا تليق بي.
"زينب، أعيش هُنا، ولكن كنت أدرس في ألمانيا والآن أكمل دراستي هُنا". هُناك سر في طريقة تحدّثك، تبدين وكأنك تُحاولين وضع نقطة بعد كل كلمة.
"ميمنون أولدوم"، قلت لكِ، بلغتكِ، لأُثبت لك أن الإنجليزية ليست وحدها ما أجيده.
سألتُك إلى أين ذاهبة، وأخبرتِني أنك ستذهبين لمحطة الميترو، التي تقع أسفل الحي، على بعد عشرة دقائق.
لم تخبريني بوجهتكِ النهائية، وكأنّك تطلبين منّي مرافقتك إلى المحطة، أو ربّما هذه طريقتي بالبحث عن ذريعة لأتأكد من اهتمامك بي.
سألتكِ ما إذا كنتِ تُمانعين بمرافقتي لك، ولم نتحدث بقدر ماكنّا صامتين، جنباً إلى جنب، نحو المحطة. ربّما كنّا نشعر بالخجل، أو ربّما كنّا حذرين.
وصلنا إلى المحطّة، لم أطلب رقم هاتفك، كنت أبحث عن طريقة عصريّة أكثر، دون أن أبدو عادياً، فلم تكوني أنتِ عاديّة.
فطلبت، وأنا أحكّ وجهي، بخجل، ما إذا كنتِ تودّين الخروج معي في نهاية الأسبوع، وأومأتِ برأسك بحركة تركيّة الأصل، وكأنك تقولين: من أين لك هذه الثقة؟
سأكمل لاحقاً، أصابعي مُتعبة، وشاعريّتي تكاد تنفذ، اسمحوا لي أن أستعيد القليل منها.
لقد عدت، الساعة الواحدة بعد منتصف اللّيل، والثالثة بتوقيتكِ، لايهم، فالوقت مناسب لنا نحنُ الإثنين لنفُصح عن مشاعرنا.
لا أعلم ما إذا كنتِ قد كتبتِ قصيدة عن حُبّنا الطفوليّ، القصير، والغير ناضج، ولكنني قد كتبت، أكثر من قصيدة.
تربّيت وكبِرت وأنا أسمع جملة "الرجل لايبكي"، لذا لاتقلقي، لم أبكِ، ليس لأنّك غير جديرة بالبكاء، بل لأنّه مُحرّمٌ عليّ البكاء.
إذاً، وافقتِ على مكان اللقاء، في ساحة "فيدان هان"، حيثُ المقاهي مُتراصّة، والمكان مُزدحم، كان اختياري سيء.
اخترتِ يوم السّبت، وكأن يوم الجمعة لايليق بي. بالنهاية أنا أشبه يوم السّبت، يوم الخطط البديلة، واللقاءات المؤجلة، أحسنتِ الاختيار، يازينب.
صافحتُ يدكِ، كنتُ مُحتاراً حينها، هل أقبض يدكِ بقوّة، لأُفصح عن إعجابي، أم برقّة، حيث أجازف بالظهور كشخص يريد الهرب. لا أذكر أيّهما فعلت.
ومضيتِ، وشعركِ الأسود يُناديني، عفوتِ عنّي ذلك اليوم، ولم تتعطرّي، فلستُ بحاجة لرائحة أخرى تُؤلمني، وتُشعل بي نار الأرق.
فبعد كُلّ هذه الأعوام، يصعبُ عليّ الإستمتاع برائحة عطر، دون أن يكون لها ذكرى مؤلمة.
عُدت إلى عملي، صعدت الشارع، أو تسلقّته، أيّاً يكن، فبورصة مدينة جبليّة لاترحم بمرتفعاتها المبعثرة، في كُل اتجاه.
وأكملتُ عملي، حتى الواحدة بعد منتصف الليل، يالها من مصادفة، أن أتحدث عن ذلك في هذه الساعة.
مررتُ إلى دكّان السيد أركان بيك، بطريق عودتي لشقتي، التي أتشاركها مع صديق لي يُدعى أحمد.
واشتريت قهوة تركيّة، يجلبها أركان بيك من أحد المطاحن، ويبيعها بفرق ليرتين أو ثلاث، لم أتذوق مثلها من قبل.
"من يشتري قهوة بهذا الوقت؟"، سألني أركان بيك، ضاحكاً. "العشق، أركان بيك، العشق يشتري." وضحكنا سويّاً. ساعدته بإقفال الدكّان، وعدت للشقة.
أحمد كان يعمل حلّاقاً، في الصالون الذي يقع على بعد عدّة أمتار من المقهى، سمعتُ قبل فترة وجيزة أنه اشترى الصالون، ولكن لم نتحدث منذ أن سافرت.
أحمد كان صامتاً دائماً، لايتحدّث سوى عندما نشرب القهوة سويّاً صباحاً، أو عندما يصدر خبراً عن نقل لاعب ما إلى نادٍ آخر.
لم يكن يجيد الحديث معي، أو ربّما أنا لم أجد طريقة مناسبة للتحدث معه. كُنّا نتشارك كل شيء، حتى مهامنا، إذا طبخ هو يوماً فأنا أطبخ اليوم التالي.
لاحظ أحمد حماسي، تلك اللّيلة، ورآني، بينما أغلي الماء وأضع القهوة، وسأل:
"خير؟ شكله وراك مصايب اليوم؟".
"خير؟ شكله وراك مصايب اليوم؟".
ليتها المصائب هكذا، يا أحمد. أخبرته بما حدث، وأنّني الآن سأشرب فنجان قهوة، احتفالاً، يليق بسذاجتي.
فلم يتردّد بُمشاركتي هذا الحماس وهذه اللهفة وقال: "احسب حسابي"، كنتُ سعيداً حينها، كانت تلك المرّة الأولى التي نتحدث بها، عن قرب، بلا حواجز. والأخيرة أيضاً.
أعتذر على إطالتي للقصة، فأحمد جزء مُهم، وأهمّيته تتجاوز حُبي الطفولي.
حدّثني أحمد، عن الفتاة، التي تمرّ كل يوم، على حد قوله، من أمام صالون الحلاقة، وتنظر إليه، بدا لي وكأن أحمد يذهب للعمل لأجل رؤيتها فقط.
وأخذ يُطلب منّي نصائح، أنا الذي أصغره بأربع أعوام، لايعلم أنني بحاجة لمن ينصحني.
أخبرته أنني لا أعرف الكثير، ولكن أخبرته أيضاً أن الجرأة على سؤالها، هي سلاحه الوحيد.
وحينها أخذ يهذي بأنّه يُفكّر بالذهاب إلى أهلها وطلب يدها منهم، وأنا لا أملك هذه الخبرة، فخبرتي بالحُب دائماً ماكانت مبنيّة على التمرّد، على المجتمع، والعادات، والتقاليد.. الملعون منها والجيّد.
خلدتُ إلى النوم، يائساً، بلا جدوى، بسبب قهوتي، ويوم السبت يبعدُ يومين، تمنّيت لو بوسعي النوم ليومين متواصلين.
استيقظت صباح اليوم التالي، وأنا ألعن نفسي مراراً: "لانيت اولسُن"، تبدو جميلة باللغة التركية.
هزأتُ نفسي لأنّني فضّلت أن أكون شاعراً، أنا الذي لم أكتب قصيدة صحيحة يوماً، ووافقت على لقائها دون طلب رقمها.
كنتُ وكأنني طفل يتذمّر من سقوط قلعته الرمليّة مراراً بسبب قربه من الضفّة.
سعيداً بالأمل، وحزيناً لأنني بنيته بالمكان الخطأ.
مرّ اليوم، المئات من كاسات الشاي وفناجين القهوة والمئات من جملة "إي والله"، صديقي بالعمل لم يكف عن المزاح طوال اليوم، ولهفتي لموعدنا تكاد تقتلني.
عُدت للشقة، وقبل أن أنام، دفعتني لهفتي للبحث عن معنى اسم زينب. إنّها شجرة، ليست جميلة، بالنسبة لي. ولكنكِ جميلة.
جاء اليوم الثاني، استيقظت صباحاً، تناولتُ فطوري، وشربت قهوتي، ومضيتُ إلى العمل.
كنتُ أتوقع مجيئكِ إلى المقهى، بلا سبب، لتفاجئيني، أنا ساذج لهذا الحد، ولم لا أكون كذلك؟
يمضي اليوم، وأنا أُفكر، كيف سأتمكن من الهرب من عملي غداً، فالمقهى سيكون مُكتظاً، والإنسحاب ليس خياراً أملكه.
ولكن صديقي بالمقهى، قد فكّر بالأمر، وتحدّث مع أحد أصدقائه ليشغل مكاني، وتحدّثت حينها مع "باترون" المقهى، وأخبرته أنني سأخرج بموعد معكِ.
ردّه كان مُفاجئاً، فلقد تفهّم الموقف، هل وقع يوماً إذاً بالحُب، بينما كان يقدّم القهوة، لأحد زبائنه؟
هكذا نجوت، ألم أخبركم، أن السذاجة، هي المنقذ الوحيد، عندما يتعلّق الأمر بالرأسماليّة والحُب؟
انتهى اليوم، أغمضت عيني، لايهم ما إذا كنت قد نمت أم لا، واستيقظت مبكّراً، تناولت فطوري وذهبت إلى النادي مع أحمد، وأنا كنت قد توقفت عن الذهاب للنادي لأسبوعين قبل ذلك اليوم.
لم أكُن ساذجاً، أعلم تماماً أن عضلاتي لن تبرز بعد يوم واحد، ولكن احتجت لكسب المزيد من الثقة بنفسي، فلقد سلبتِها منّي بنظرة.
تمرنت بحماقة، وأحمد يستمر بتحذيري: "ثقيل عليك يامنذر"، لا أعلم هل تلك نتيجة المجتمع الذكوري الذي كبرت به، أم أن الحُب دفعني لفعل ذلك، أم كلا الأمرين.
انتهيت بعد ساعتين، والعرق يصبّ سخيّاً، كنتُ سعيداً جداً. ها أنا، رجلُ أحلامك، قادم، يازينب.
"تفاجأت منك والله، طلع الحب في منه فايدة"، قال لي أحمد، وهو من كان يسخر من حملي لأوزان خفيفة طوال الوقت.
استراحة أخرى لأدخّن سيجارة أخيرة، قبل أن أسرد النهاية.
أعودُ لشقّتي، ويرافقني أحمد، ليستحم ويمضي إلى عمله، بينما أبحث أنا في خزانتي، عن ملابس تليق بموعدنا الليلة.
جينز؟ عاديّ جداً، لايليق بلقاء امرأة ليست عاديّة. قميص؟ مع رسوم؟ أم سادة؟ وهكذا غرقت في حيرتي.
يظن النساء أننا لانحتار بإختيار مانلبسه عندما نلتقي بهن، لاتقلقن، فنحن نتشارك الهم ذاته.
انتهى أحمد من الإستحمام، وجاء وهو يقول: "الله الله، البس أي شي.. لو تحبك رح تحب اللي لابسه".
شكرته على النصيحة الثمينة، وأخذتُ اختار مرة أخرى، بنطال أسود، قميص سُكرّي، حذاء أسود، وسترة سوداء. حسناً. لن أفكر بالأمر أكثر من ذلك.
أسود، احتفالاً بحُبّنا الناقص، وقميص سُكّري، لأنك تُحبّين القليل من السّكر مع قهوتك.
استحممت وارتديت ملابسي، أبدو رسميّاً أكثر من اللازم، شعرتُ أنني شخص آخر، ولكن بالنهاية، أنا، كما أنا، لا أليق بك.
ذهبتُ إلى المقهى، شربتُ قهوة مجانيّة، كانت بالأمس من صُنعي. قدّمها لي صديقي هناك، وقلت له.. "اي والله"، وضحكنا.
تبادلنا أطراف الحديث، واقترح عليّ أن أشتري وروداً، لكِ. لم أشترِ، ربّما أنا ساذج قليلاً، ولكني لستُ رومانسياً لهذا الحد يازينب.
إذاً، الساعة الثانية عشر ظُهراً، وموعدنا عند الساعة السادسة مساءً، وأنا ارتديتُ ملابس لقائنا منذ الصباح..
مررتُ إلى أركان بيك، وأخذ يمدح مظهري "چوك غوزال ياه، چوك ياكشكلي"، تحدثنا قليلاً، ثم مررت إلى أحمد.
كان مُنشغلاً برأس شاب ما، لم يتحدث عن مظهري، يعلم تماماً أني أخجل ما إذا مدحني أحدهم، لذا وفّر على نفسه عناء المدح.
أخبرني أن هُناك قهوة في الترمس، لم أرفض، أخذت كوباً وأخذت أصب، وانسكب بعضها على ملابسي.
أنا الذي لم أسكب القهوة بشكل خاطئ طوال فترة عملي، سكبتها، باليوم الوحيد، الذي يُمنع به حدوث ذلك.
إذاً، لسخافة القدر، أو لسذاجتي، ربّما الجينز يليق بي، والتيشيرت كذلك، فأنا بالنهاية رجل عاديّ. لايسعني أن أكون غير عاديّاً.
وكأن الحياة تقول لي، كُن كما أنت، ليس هُناك مجال للتصنّع.
خرجت من الصالون، بينما يهزّ أحمد رأسه.. "نيابتِن لان.. نيابتِن"، عدتُ للشقة، وبدّلت ملابسي، سأكون طبيعياً، أيها القدر، ولن تتمكن من العبث معي.
الساعة الثالثة الآن، اتصلت بأصدقائي القدامى، لإمضاء الوقت، فأنا لستُ شخص مثاليّ.
واحد وراء الآخر، أحدهم خطب، الثاني سافر للدرس بالخارج، والآخر كذلك، تمضي ساعة، اتصل على أمي، وتمضي ساعة أخرى..
تبقى ساعة، ساحة "فيدان هان" تبعد خمسة عشرة دقيقة، ذهبت إلى هُناك، قبل موعدنا، بخمسٍ وأربعين دقيقة.
هُنا، نصلُ للحظة الموعد، فيجب أن تسمعوا معجزة شوبان، حتى تشعرون باللهفة.
youtu.be
youtu.be
ساحة "فيدان هان" مُكتظّة، وهُناك أكثر من مقهى، ولم نتفق على مكان لقائنا بالتحديد.
هل أقف عند المدخل، بجانب الكشك الذي يوزّع عروض الوشوم، أم أقف بمنتصف الساحة، فأنا طويل القامة، أنافس الأتراك بطولهم. يمكنكِ رؤيتي حينها.
الأماكن المزدحمة تُقلقني، وتجعلني مشوّش التفكير، وأنا يكفيني مافعلتِه بي. لذا، كيف ستمضي هذه الدقائق..
انتظرتكِ بجانب أحد مداخل الساحة، بجانب كشك الوشوم، الذي يديره طفل يملك عين واحدة، يتحدّث بفظاظة مع القادمين، كنتُ بحاجة لمكان أكثر هدوءاً.
انتظرت هُناك لعشر دقائق، وعدت إلى منتصف الساحة، وأخبرتُ نفسي أنني رجل، لا أخشى الأماكن المُزدحمة.
كيف نتأكد من حبّنا لأحد الأشخاص؟ أليس مُحتملاً أن يكون إعجاباً؟ ما الحُب إذاً؟ هل الحُب أن نعتاد على رؤيتهم؟ ونعتاد على استيقاظنا بجانبهم؟ بلا لهفة، وبلا شوق؟
الأفكار كانت تراودني، هل ما أقوم بفعله الآن نابع عن مُراهقتي الناقصة؟ أم لعدم خبرتي؟ هل جيّد أن نملك خبرة بالحب؟ ألن تُفضّلين أن تكونين أول حبيبة لي؟ أم العاشرة؟
أسئلتي كانت كثيرة، ولاتزال كذلك، وكلّها كانت بلا إجابة، مثلك. تُصرّين على وضع علامة الإستفهام أمامي، وتمضين.
إذاً، الساعة السادسة الآن، مئات الوجوه حولي، هل يعقل أنّكِ هنا الآن، دون أن أتعرف عليك؟ هل أنسى وجهك؟
هل أنسى شعرك الطويل؟ وشفتيك المنطبقتين على بعض مثل شقّي صَدَفَة؟
هل تنسين وجهي؟ لاشيء غير عاديّ لديّ يا آنستي، وجهي قابل للنّسيان، حتى أنني أنسى أحياناً كيف أبدو.
هل يسع رجل عاديّ مثلي، أن يحبّ امرأة، إلهيّة الملامح والحضور، مثلك؟ أليست هذه أسطورة، نقرأها، ونُشاهدها بالأفلام، ونسمعها بالأغاني؟
السادسة وخمس دقائق الآن، هل الساعة التي تملكينها ذات توقيت آخر؟ هل تتأخرين، عن الرّجل، الذي لم يتأخر من قبل على امرأة؟
ألمحكِ، قادمة، من ذات المدخل الذي جئتُ منه، وتبحثين، بين الوجوه، كما كنت أفعل. جاءت مُعجزتي. جاء الحُب. إيه والله.
أحاول جاهداً أن لا أبتسم، حتى أبدو جذاباً أكثر، ولكنّها محاولة فاشلة، ابتسمت، لأجلك، وانتظرتُ تعابير وجهكِ، حتى تمتلئ حيرة بينما تبحثين عني، ثم مشيت نحوك.
رأيتِني عندما اقتربت، وابتسمتِ للحظة، ثم رفعت رأسكِ، أهذا كبرياء الأتراك يازينب؟
تُسلمين عليّ بالتركيّة، وكأنّك تفرضين هويّتك، وأرد عليك بالتركيّة، فلستُ أملك وطنيّتك.
ثم أسألك كيف حالك، بالتركيّة، وتردين علي بالإنجليزية، ماذا تفعلين؟ ألا تُقدّرين محاولاتي العديدة للتحدّث معك بلغتك؟
أطلبُ منك أن تختاري أحد المقاهي، ماذا فعلت يامنذر، جميعها مقاهي عائلية، هذا يصرخ، وهذا يبكي، وهذا يجري، ألم تملك ذوقاً واختياراً أفضل؟
تختارين أحدهم، على عجلة، وكأنّك سئمتِ من الضجيج، أمشي خلفك بينما أوبّخ نفسي على مافعلت.
تختارين طاولة فارغة، أفكّر ما إذا كان عليّ سحب الكُرسي لأجل أن تجلسي، هل سيبدو ذلك وكأنه تصرّف مُبتذل؟ أم ستُعجبين بي؟
أقرر ألّا أفعل شيء، أنتظرك حتى تجلسي، ثم أجلس، هكذا لا أبدو فظاً، ولا أبدو لبقاً أكثر مما ينبغي.
يقدّم لنا العامل قائمة المشروبات والطعام، أسألكِ ما إذا كنتِ جائعة وتجيبين بالنفي. تطلبين قهوة، مع القليل من السُكّر، وأنا مثلك، ولكن بلا سُكّر.
لحظات صمت تمرّ وسط الضجيج حولنا، ها أنا أرتجف، هل أنا جبان أم أن هيبة حضورك لها كل هذا الأثر؟
اسألك عن أسبوعك، وتُعيدين السؤال عليّ، أجيب ثمّ تُجيبي أنتِ، تخبرينني عن فترة دراستك في ألمانيا، وأنّك خرّيجة إدارة سياحة أو شيء كذلك.
أخبركِ أنني ولدتُ بالمدينة، تتفاجئين، وتسأليني ما إذا اعتمرت وزرت قبر الرسول.. أسئلتكِ ساذجة، يازينب.
تصل قهوتك، مع قِطعَتَي سُكّر على الجانب، يخبرك النادل أن بوسعك وضع المقدار الذي تريدينه. وقطعة حلقوم واحدة بجانب القهوة.
أبتسم، وتنظرين إلي، إذاً، النادل، لم يقع بحُبّك، حمداً لله. لم يُجازف بتوبيخك له ما إذا كان قد وضع الكثير من السُكّر، جبان.
يذهب النادل، تضعين قطعة واحدة، ونستمر بالحديث.. أنسى في لحظات أنّك تتحدثين، فأحاديثك كانت سياسية أكثر مما ينبغي. لذا أتأمل وجهك.
أحاول الخوض معك، ولكنّك تبدين وطنيّة جداً، وأنا بلا وطن، آرائنا تختلف، والتضاد لايقود للتشابه في أكثر الأحيان.
تحاولين التحدث معي بالتركيّة، وتقولين لي أن مستواي "جيّد"، كان حريّاً بكِ أن تقولي سيئاً بدلاً من شفقتك المُبتذلة.
لايهم ذلك، مازلتُ أحبّك، ولازال بوسعك أن تكوني لي وطناً.
تمر ساعة، او اثنتين، كنّا قد طلبنا عصير بعد القهوة، مع الفواكه، بإسم غريب، يجذب السيّاح بلا شك.
ننتهي، وتستمر أحاديثنا، وقعت بحب طريقتك بالكلام، حركة يدك وأنت تشرحين موقف ما، وخصلتك التي ليتها تسقط كلّ دقيقة، حتى ترفعيها، بكلّ أنوثة.
نخرجُ من المقهى وأخبركِ ما إذا كان بوسعي مرافقتك للمحطة، تُخبريني حينها أنّك تسكنين بجانب المقهى الذي أعمل به.
وأنّك ذهبت للمحطة يوم لقائنا لأنّك كنت ستلتقين ببعض الأصدقاء، أبتسم، ها أنت إذاً، قريبة. جداً.
أرافقك، نتحدث لدقيقة ونصمت لدقيقة أخرى، نصل إلى منزلك. لاحيل لديّ الآن، لن أجازف، فأنا رجل عاديّ.
"هل يمكن أن أطلب رقم هاتفك"، تضحكين، وأتوتر، ثم تُعطيني إياه. "نلتقي قريباً إذاً، إي غيجيلار" أقول لكِ، وتردّين "غود نايت"، أين وطنيّتك، الآن، يازينب؟
الساعة الرابعة فجراً الآن، لايسعني أن أكمل القصة، النعاس يتخطى حنيني، لم أتوقع أن تستغرق القصة كل هذا الوقت، ولكن سأكمل غداً. تبقى جزء أخير، يتطلّب بعض التركيز. شكراً على قراءتكم ♥️
يبدو أن القصص الناقصة دائماً ماتحظى باهتمام أكثر، ربّما لأنّها تُتيح لنا اختيار النهاية المُناسبة. ولكن ها أنا عدت، لأنهي قصّتي.
بتوقيت الخيبة، أقول لكم، مساء الخير.. أرسلتُ لها رسالة اليوم، "كيف حالك؟"، لن ترد، ولكن يكفي أني سألت.
إذاً، عدتُ إلى الشقّة، أحمد لم ينته عمله بعد، استلقيت على السرير، وأنا أنظر، إلى اسمك على هاتفي.
سأرسل لكِ رسالة، ولكن لم تساعدني حروفي، ما الذي سأكتبه؟ قضيت وقتاً ممتعاً معك؟ هل نلتقي مرة أخرى؟ تصبحين على خير؟
"ألو"، كانت رسالتي. كلمة كافية، ساذجة قليلاً.. مثلي. وجاء ردّك سريعاً. اعتذرت على اختياري السيء للمقهى. وقبلتِ الإعتذار.
تُخبريني حينها أنّك ستسافرين غداً إلى اسطنبول، وستمكثين هُناك لفترة أسبوعين، لماذا أخبرتِني بذلك؟ أهي غريزة الأنثى في كسر قلوب الرجال؟
أتوقف عن الكتابة لدقائق، بعد رسالتك الأخيرة، واسأل نفسي، هل سأكتب ما أفكّر به؟ هل أنا شُجاع، لذلك الحد؟
"هل نلتقي الآن"، كتبت لها.. وضغطت على زر الإرسال بسرعة حتى لا أتراجع. كانت فرصتي الوحيدة.
جاء ردّك سريعاً أيضاً: "هل تريد أن نلتقي؟"، تعلّمتُ أن أخطر النساء هن من يجاوبن على السؤال بسؤال آخر.
لم أعرف زينب جيداً، ولكن كلّ سؤال طرحته عليها كان يندفع نحوي لأعرف نفسي أكثر.
وكان بوسعي، أن ألعب لعبتك، وأن أقول لك: "هل تريدين أنتِ أن نلتقي؟"، ولكني واثق الآن من إجابتك. لذا قلت لكِ: "نعم، أرغب برؤيتك.. الليلة، مرّة أخرى".
"وماذا سنفعل؟" تسأليني، أي تلميحات هذه يازينب؟ امرأة مثلكِ لاتصلح لي، لا يسعني حمل المزيد من التوقّعات على كتفي.
"لا أعلم"، أخبركِ، وأنا أعلم، تماماً، ماذا سنفعل. بعد ساعة سنلتقي، سأذهب إلى باب منزلك، ومن هُناك الرّحلة تبقى سرّي.
أبدّل ملابسي، وأتعطر، وأتوجه نحو منزلك الذي حفظت موقعه. ربّما لايزال بوسعي الذهاب إليه الآن.
"أنا بالخارج"، أرسل لكِ، وتخرجين بعد دقائق، كما أنتِ، إلى أين سنذهب، تسأليني، وأخبرك أننا سنمشي، ونقرّر.
لو التقينا اليوم، لن نتفق، فلقد تغيّرت كثيراً. لم أعد أخرج من المنزل بلا وجهة، اسكندنافيا ليست مثل تركيا.
هُنا لاتُسمع اللعنات من المقاهي، والمسافة بين كل شخص تتخطى الأمتار، الحُب هنا لايُعرض على الملأ.
أصبحتُ بارداً، كما الطّقس هنا، وفقدت حرارة الحُب، بتعبيرٍ آخر، لم يعد بوسعي أن أكون طفلاً.
صعدنا الشارع، الذي تسكنين بأسفله، نساء هذه المدينة يعرفن أن الصعود يتبعه نزول، والعكس أيضاً. وأنتِ مثال حيّ على ذلك.
وكنتُ أتوجه، نحو شقّتي، وأنا في حيرةٍ من أمري، هل أدعوكِ للمجيء إلى شقّتي. أم أقبّلك، على الأرصفة، ونمضي.. كلٍّ في طريقه؟
توقفت، بغتة، وقبّلتكِ، لم يكن هُناك أحد. لم تصفعيني، ولم تُلقي شتائم مدينتك عليّ.
جبل أولوداغ كان شاهداً على قُبلتنا. والقمر أيضاً. كانت أول قبلة لي في مكانٍ عام. وليتها لم تنتهي. ليتها استمرّت، حتى حلول الرّبيع.
كانت شفتيك أكثر حرارة من شمس أغسطس، وأنا الذي لا أنجو خلال شتاء مدينتك، نجوتُ تلك الليلة.
ابتعدت عنك، وأنت ابتسمتِ، أدرتُ وجهي، حياءً، بلا حيلة، وكأنني أوبّخ نفسي على مافعلت. أهذا أكبر ذنب لي يا الله؟
هل القبلة، التي دائماً ما كنت أشيح نظري عنها بالأفلام خلال طفولتي، هي أكبر ذنوبي الآن؟
"نولدو؟" تسألينني، وأقول لك "هيچ بيشي يوك"، هل دفعتكِ حميميّة الموقف للتحدّث بالتركية؟
عانقتكِ حينها، وأخبرتكِ أنّكِ جميلة. كُنت على بُعد شيطان من دعوتكِ إلى شقّتي، هُناك حيث نسقط كلانا، في هاوية بلا قرار.
ولكن لم أرغب بالمجازفة بكوني "رجلٌ آخر لاتجرّه سوى شهوته". لذا أمسكتُ بيدكِ، وأعدتكِ لمنزلك. بدوتِ سعيدة.
"غوروشوروز"، تقولين، وأرد عليك. تختفين في الظلام بعد دخولك بوابة المنزل الصدئة. ولا نلتقي بعد ذلك.
ربّما كنّا نعلم يقيناً أنّ الحُب هذا حبٌ ميّت، وربّما كنّا نعلم، أن الله وحده من يبعث الموتى.
ستسافرين غداً، وأنا بعد شهر، ربّما اتفقنا كلانا، دون وعي، على أن الحُب هذا يكفي للقاء واحد، وأنه إذا استمر، سنحزن.
ولكن لم أعلم أن الندم على عدم المحاولة أشد إيلاماً من الانسحاب. ليتني، أرسلتُ رسالة أخرى. ليتكِ عدتِ للمقهى.
إذاً، اختفيت أنتِ، وانسحبت أنا، كوني جباناً، وبقي رقمك مسجّل في هاتفي. حاولتُ الإتصال بك، وحاولت إرسال الرسائل.
رقمكِ ملغيّ، يازينب، ورقمي ليس ذاته رقمي التركي الآن، هل أرسلتِ لي رسالة، لم تصلني، او حاولتِ الإتصال، كما فعلت أنا؟
هل يُكافأ العُشّاق على محاولاتهم المتأخرة؟ أم يعيشوا مرارة الندم حتى الموت؟
على أيّةِ حال، ستبقين ذكرى عالقة في سماء قلبي، أنتِ، وكاسات الشاي، وبورصة بهضباتها وجبالها، وتركيا، واللغة التركية أيضاً.
كنتِ ثقيلة على قلبي، حتى أنني وضعتُ وشماً على صدري، باللغة التركية.
جاري تحميل الاقتراحات...