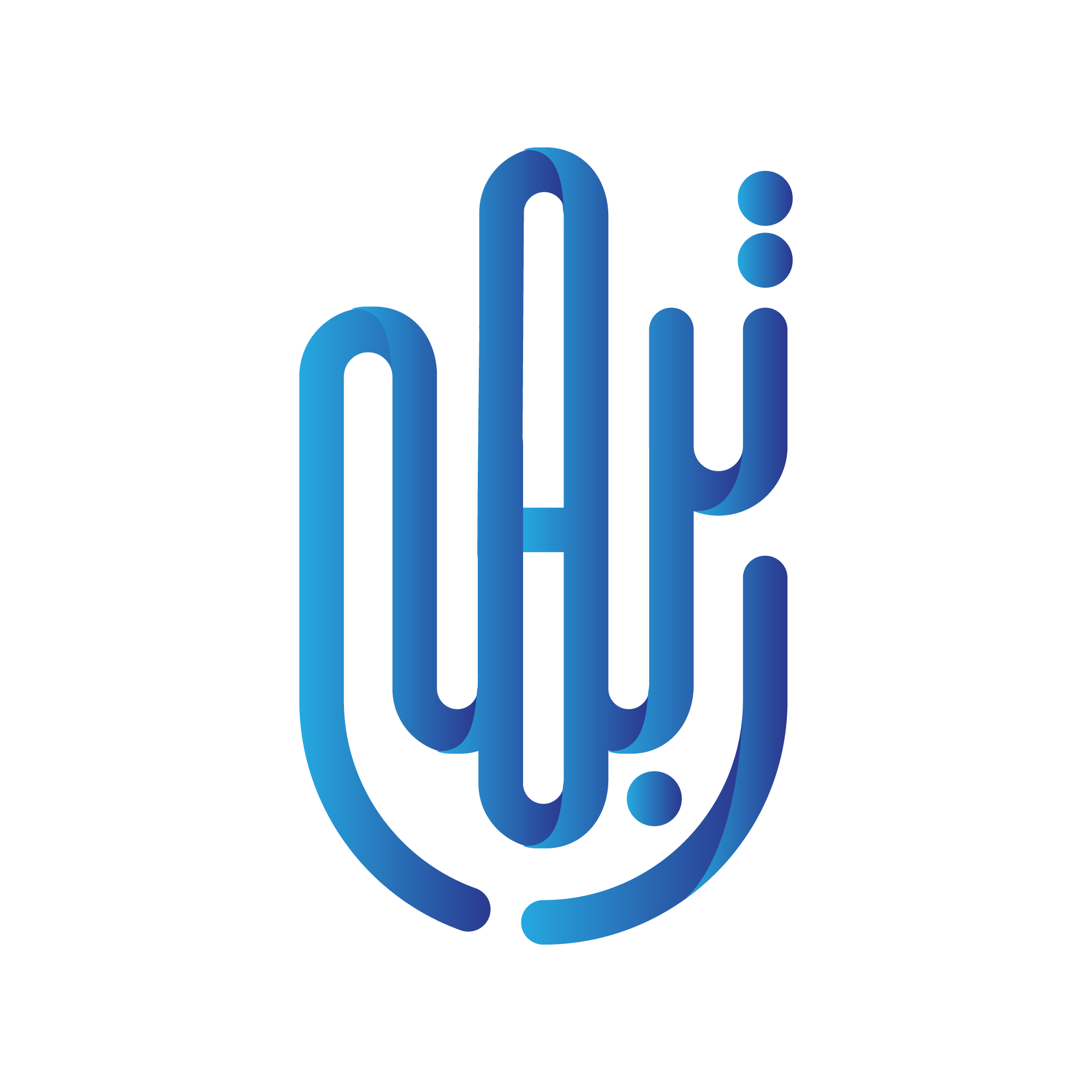في إحدى ليالي أثينا الحالمة، حضر فلاسفة وشعراء اليونان الأعظم مأدبة أعدها الشاعر أجاثون احتفالاً بفوزه في مسابقة مسرحية في اليوم السابق. وبعد أن فرغوا من الطعام، تحداهم فايدروس أن يلقي كل منهم خطبة يصف فيها الحب ويثني عليه.
ممتلئي البطون ونصف مخمورين، انطلق كل منهم في محاولة الإمساك بذلك الشعور الأثيري مُمثلا في إيروس إله الحب، وإعطائه جسداً من كلمات.
كان ذلك هو الإطار الذي دارت بداخله محاورات "المأدبة"، كتاب أفلاطون الذي تمحور خصيصاً حول الحب. بطريقة أو بأخرى، لا يختلف ما فعله أفلاطون وأصدقاؤه في تلك الليلة عمّا نفعله نحن في جلساتنا الحميمة مع الأصدقاء، حيث نجد دائماً أن للحب والعلاقات مكانها المحجوز في أي نقاش تقريباً.
أحياناً، وبسرعة وبلا سابق إنذار، نجد أن ما قد بدء كفكاهة مرحة ونميمة غير مؤذية، سرعان ما استحال إلى أسئلة ثقيلة حول حياتنا العاطفية وعلاقتنا بمن نحب. ينتهي النقاش ويذهب كلٌ إلى بيته، لكن داخل كل رأس ما زالت التساؤلات تدور.
لا تجيبنا الفلسفة بالضرورة عن تساؤلاتنا الأعمق، فطالما اتسمت بمراوغة لا مكان فيها لإجابات قاطعة، ولم تكن يوماً لمن يبحثون عن إجابات جاهزة بلا عناء.
لكنها تنير لنا مصابيح صغيرة نستطيع على ضوئها التفكير بوضوح أكبر، وتمنحنا في شكل الفلاسفة رفقة نستطيع معها البحث وراء ما يشغلنا دون أن نشعر بأننا وحيدون تماماً.
منذ مأدبة أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد وحتى يومنا هذا، ولا جديد تحت شمس الحب. ما زال هو الشعور نفسه المُسكر والمؤلم في آن واحد، والذي نغرق في عذوبته بعض الأيام وبالكاد ننجو من أعاصيره أياماً أخرى.
وبين هذا وذاك، نظل نتساءل، من أين جاء حبنا هذا؟ وهل نحن حقاً نحب من نظن أننا نحب؟ هل سيستطيع حبنا البقاء طويلاً وأن يبني يوماً ما زواجاً ناجحاً؟!
لم نكن دائما في هيئتنا الحالية حسب أريستوفان؛ ففي قديم الزمن، كان البشر يمتلكون رأسين، وأربع أذرع، وأربع سيقان، وضِعف قوة أي منا الآن!
وإلى الآن، لا يزال الجرح الذي تركه سيف زيوس يلد أجساداً مبتورة وأرواحاً تائهة. تهيم تلك الأرواح على وجهها في طرقات الحياة الوعرة بحثاً عن نصفها الآخر، تمد أياديها للفضاء بحثاً عن صداها الضائع، لتعود الأذرع بخواء وخيبة لا تزال الرغبة تحترق عند أطراف أصابعها !
ربما لم يصف هذا الألم أفضل من الفيلسوف الفرنسي رولان بارت في كتابه "شذرات من خطاب في العشق" عندما كتب يقول: "الرغبة ملتهبة وأبدية، لكن لا تبلغ الأذرع المرتفعة أبداً الكمال المعبود".
خاطت تلك الأرواح فوق الجرح غشاء رقيقاً من العادية تغلف به مكان الحنين النازف لتندمج بسهولة في ابتذال اليومي والمعتاد، حتى يأتي ذلك الزمن السحري وتقابل من ضاع عنها في قديم الأزل!
وبعد أن صارت الأنا والآخر شيئاً واحداً، تُكللنا هالات السعادة والفرحة بالإكتمال وتضعنا في فضاء بعيد كل ما فيه جميل. ويتبدى لنا المحبوب حينها بالكمال وقد تجسد بشراً، يمد لنا يده وينقذنا من انكساراتنا.
لكن على حواف جنّتنا الشعورية، لا تزال الأسئلة تحوم، نحاول أن نحبسها بعيدا عنّا حتى لا تفيقنا من سُكرنا اللذيذ، لكن تأتي اللحظة إن عاجلا أم آجلاً، ربما على هيئة جدالنا الأول، أو في شكل حادث تافه وصغير، ويظهر لنا المحبوب بشكل مختلف عن ذاك الذي رسمناه له في مخيلتنا!
الجمال ينير المحبوب:
في بُعد ما ورائي، يكمُن عالم آخر مختلف كثيراً عن عالمنا الحالي، يطفو فيه أصل كل شيء في الوجود في كمال لا يُضاهى، وتتجسد القيم والمُثل والمشاعر وكل ما هو غير محسوس جنباً إلى جنب مع سائر الموجودات.
في بُعد ما ورائي، يكمُن عالم آخر مختلف كثيراً عن عالمنا الحالي، يطفو فيه أصل كل شيء في الوجود في كمال لا يُضاهى، وتتجسد القيم والمُثل والمشاعر وكل ما هو غير محسوس جنباً إلى جنب مع سائر الموجودات.
يقول بارت: "يدرك الشخص العاشق الآخر بكليّته ككُلٍ يبعث فيه رؤية جمالية؛ يمدحه لكونه كاملاً، ويمجد ذاته لإختياره له كاملاً".
وهكذا، فطبقاً لأفلاطون، أن حبنا لمن نحب هو وسيلة للاقتراب أكثر قليلاً من الجمال الكامل الواقع في عالم المُثُل.
-يتبع.
وهكذا، فطبقاً لأفلاطون، أن حبنا لمن نحب هو وسيلة للاقتراب أكثر قليلاً من الجمال الكامل الواقع في عالم المُثُل.
-يتبع.
تكتب ماري لومنييه وأود لانسولان عن هذا في كتاب "الفلاسفة والحب" وتقولان: "يوضح لنا أفلاطون جلياً لماذا يعد الجمال هو الهدف الأول لرغبتنا، فسقطنا من سماء الأفكار الطاهرة لمستنقع الحواس، ونسينا الأشكال التي أدركناها فيما مضى وسط خضم خلودها.
وحده الجمال، حيث "التألق" هو ملمحه المتفرد، وهو ما يظل يبهرنا للأبد. ولهذا، فإن الروح في حضرة انعكاس هذا الجمال الذي يتجسد أحياناً على الأرض، تشبه آنذاك الجواد المجنح فتستثار وترغب في الطيران.
لكن رُغماً عن كل شيء، يأتي الوقت لا محالة ونكتشف ملمحاً ما فيمن نحب أبعد ما يكون عن الكمال. حينها، تبدأ أنوار الحب والجمال الباهرة في الإنحسار قليلاً عن رؤيتنا، لنرى المحبوب لأول مرة عارياً من هالات العشق التي كللناه بها !
نأخذ خطوة للخلف، ونحاول أن نفهمه ونعرفه كما هو في الحقيقة لا كما نحب أن نراه. لكن، هل تلك المعرفة ممكنة أصلاً؟!
في رأي عالم النفس الفرنسي "جاك لاكان"، فالإجابة هي "لا" قاطعة! فهويتنا الحقيقية تبقى محبوسة للأبد خلف سجن الجسد الذي يظهر وحده للآخرين.
فبينما يقضي كل منا وقته مع نفسه بشكل كامل داخل أفكاره متحدثاً مع ذاته في حوار غير منطوق، لا يظهر للعالم من كل هذا سوى أشكالنا الخارجية التي قد لا تشي بالضرورة بمن نكون حقاً.
ولهذا، تبقى القاعدة هي كوننا غير مفهومين من قِبل الآخرين، ما يصنع حاجزاً حديدياً يحول دوننا ودون التماهي تماماً مع أحد، ويُبقِي التواصل الحقيقي شيئاً نفتقده في علاقاتنا الإنسانية. لكن المحبوب مُستثنى من كل هذا، أليس كذلك؟
لا يعتقد "لاكان" هذا. فوفقاً لعالم النفس الفرنسي، نحن لا نرى أو نفهم حقاً من نحب، بل نقوم بإلصاق خيالتنا عن "الحبيب المثالي" فوق جسد المحبوب ونقع في حب خيال اختلقناه لأنفسنا !
تشرح لومنييه ولانسولان هذا على لسان الشاعر والفيلسوف الروماني "لوكريس" وتكتبان: "إن "المعبود" هو حبيب غير موجود. موضوع الحب ليس سوى عرض سمات تخيلية.
وابتداء من تلك الذرات التي تخرج من مخلوق جذاب لترتطم بالعين المقابلة، يحكي المحب لنفسه حكاية، ويصنع إلهه، كائناً يعج بألف إغراء، بحيث تتلخص أمنياته في توافر تلك المغريات في الحبيب".
يبدو الحب إذاً مجالاً محكوماً بالأوهام وتشوش الرؤية، ولا يقتصر الوعي بهذا على الفلاسفة فقط، فهنالك مثل شعبي شهير يقول: "مرآة الحب عمياء". ومع عجز مرآة الحب عن عَكس المحبوب، ما الذي يقودنا إلى معرفة إذا ما كنا نحب الآخر حقاً، وليس تصورنا الشخصي عنه؟
الإجابة ليست صعبة، كل ما عليك فعله هو الإنتظار وسيأتي المحبوب لا محالة بشيء تافه، شيء لا يناسب الكمال الذي أضفيته عليه، ويخرج حينها بالضرورة عن معجم الخيالات التي رأى "لاكان" أنك تلصقها به.
حينها، ستبدأ عيوبه في التعري، والعيوب، كما يخبرنا الفيلسوف المعاصر "سلافوي جيجيك" وحدها تخبرنا إذا كنا نحب من نحب صدقا أم لا.
يقول جيجيك: "لا يمكنك أبداً أن تقع في حب شخص كامل. لا بد من وجود شيء صغير مزعج فيه، وفقط عبر ملاحظتك لذلك الشيء يمكنك أن تقول: "بالرغم من ذلك العيب، ما زلت أحبه".
وفقاً لجيجك إذاً، وحدها العيوب تمثل برهاناً قوياً على صدق عاطفتنا، فكونك ترى من تحب يأتي بشيء لا تحب، ثم تقرر بعد هذا أنك مازلت تحبه، لهو دليل جازم أنك تحبه هو نفسه وليس صورة مخادعة رسمتها عنه في خيالك.
بعد أن تمر بمراحل الافتتان بالمحبوب، ثم الصدمة حيال عيوبه، ثم تجاوز تلك الصدمة وقبوله كما هو، ويمر ما يكفي من وقت تتأكدان فيه حقاً من قوة ما يجمعكما، تبدآن بالتفكير في قضاء ما يبقى من حياتكما معاً.
ولهذا، فإن كان حياً بيننا وتقدمنا إليه بالسؤالين السابقين لضحك ساخراً منا ورد بـ"لا" قوية تقلب تصوراتنا رأسا على عقب.
فوفقاً للفيلسوف الألماني، الحب هو في النهاية شعور؛ والمشاعر، بجموحها وتقلباتها، لا تصلح لأن تكون أساساً نبني فوقه كياناً نتوقع استقراره للأبد.
فوفقاً للفيلسوف الألماني، الحب هو في النهاية شعور؛ والمشاعر، بجموحها وتقلباتها، لا تصلح لأن تكون أساساً نبني فوقه كياناً نتوقع استقراره للأبد.
يقول نيتشه: "ينبغي أن يُمنع الإنسان وهو عاشق من اتخاذ قرار يكون ملزماً له طوال حياته، ومن اختيار مرة واحدة وللأبد الشخص الذي سيحظى برفقته".
مع هذا، لم يكن نيتشه ضد الزواج ككل، بل كان ضد دخولنا فيه وفي رأسنا تصور حالم عن حياة وردية يزين الحب تفاصيلها، فإن قام الزواج على هذا التصور، لن يعدو حينها كونه وهماً نخدع به أنفسنا.
لهذا، يرى الفيلسوف الألماني أنه من السخافة أن يَعِد أيّ منا الآخر بشعور هو لا يتحكم فيه من الأصل. وحتى لا تأتي اللحظة التي نشعر فيها بأننا مخدوعون، سيكون علينا أن ندخل الزواج ونحن على وعي تام بأنه لا ما نشعر به تجاه الآخر ولا ما يشعر به الآخر تجاهنا يقع في حيز المضمون.
وبناء عليه، اقترح نيتشه تغيير عهود الزواج لتصير: "طالما أحببتك، سأظل أقدم إليك أفعال المُحبين؛ وإن كففت عن حبك، فستظل تتلقى مني الأفعال نفسها، لكن انطلاقاً من دوافع أخرى".
ولا يتخذ الزواج المثالي بحسب نيتشه مادته من مشاعر ملتهبة أو قبلات حارة، بل من شيء أهدأ وأبسط من كل هذا بكثير؛ إنها الأحاديث. فنحن نقضي معظم أوقاتنا مع الشريك في تبادل رؤانا وأفكارنا عن طريق الكلمات، مايجعل القدرة على التواصل هي الميزة الأهم التي على أي زواج ناجح أن يمتلكها.
يطلب نيتشه لهذا من أي شخص مُقدم على الزواج أن يقف برهة ويسأل نفسه: "هل تعتقد أنك ستستمتع بالحديث مع ذاك الآخر حتى سنوات الشيخوخة؟"
هذا المثال يرتكز على أن يخلق للإثنين، من خلال الإحترام المشترك، واحداً يبتكره الاثنان، قد يكون طفلاً أو أي هدف آخر مشترك يسمح بتحقق الطرفين. أما العاطفة، والجنس، وروعة الأيام الأولى، فكلها أشياء مؤقتة".
يقوم الزواج المثالي إذاً على استمتاع الطرفين بأحاديثهما معاً، وعلى خلقهما شيئاً يجمع بينهما ويصبوان دائما إليه. ستحل أيام سيئة لا محالة، لكن يظل رباط الصداقة ضامناً على مضيها بسلام؛ وعندما تأتي الأيام الصافية، سَيُعبّر الحب عن نفسه مجدداً في شكل أكثر هدوءاً.
جاري تحميل الاقتراحات...