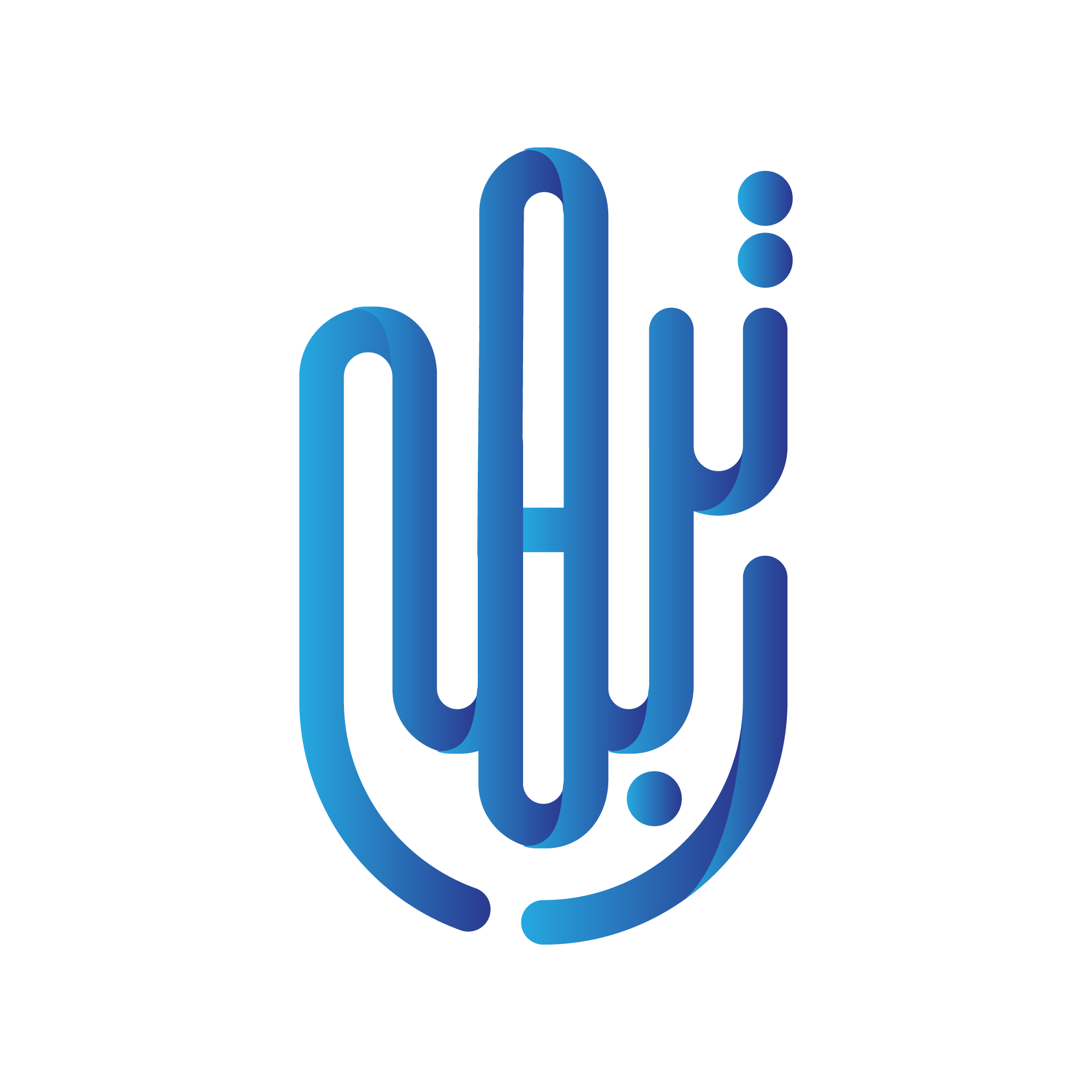في أيامِ نوفمبر الأخيرة من العام المنصرم كنت برفقة محمد سيد أحمد الماحي وحسام قريش وغيرهم من الشباب نلتقي في بيت الصديق أحمد الشريف نتبادل فيه جرعات من السمر، ونتناول قضايا الراهن الذي تداعت حوفه تحت سياسات حكومة معتز موسى.
أهلّ ديسمبر واستفحلت المشاكل، وبدأنا نتلمس سخط الناس في الطرقات، كانت بوارق الإنفجار الوشيك المُعتمِل بين صفوف الإنتظارِ الطويلة تلوح في الأفق الذي انسد تماما. حتى اندلعت الإحتجاجات في مايرنو والدمازين فاشتعل على إثرها "لستك الفاشر"،
وبدأت مواقع التواصل الإجتماعي بتناولها بكثافة، مما انعكس على تشديد القبضة الأمنية للنظام من خلال رفع حالة الإستعداد لقوات مكافحة الشغب والأمن الشعبي وجهاز الأمن بفصائله المختلفة بنسبة مئة في المئة.
كنا نتقابل بصورة مكثفة، نناقش الوضع الإقتصادي، ونحاول التنبؤ على إثر ذلك بمقدرة النظام على الصمود في ظل العزلة الداخلية والدولية التي يعيشها، وكنا نتوقع أن تضطر الحكومة لرفع الدعم الكلي عن المحروقات والقمح بحلول يناير مع إعلان الميزانية الجديدة للعام "٢٠١٩" لتمدد قليلا من فترتها،
بالإضافة لسياسات أخرى أقرب للهمبتة منها إلى السياسات الإقتصادية الرشيدة. أذكر أنني قد دونتُ انطباعاتي تلك ذات يوم وذيلتها بهاشتاق "صفرجت"، والذي تلقفه الصديق حسام الكتيابي بأخذه لصورة شاشة "سكرين شوت" وذهب لتعميده هاشتاق المرحلة،
فانتشر في مواقع التواصل انتشار النار في الهشيم خلال ساعات بسيطة، حتى الآن وكلما صادفته في جدارٍ ما انتابني إحساس عجيب بألا مستحيل تحت الشمس بالفعل، ورب كلمة لا تلقي لها بالا تفعل في الناس فعل السحر،
لذلك دائما ما نقول بأن الكلمة مسؤولية، وعانيت ما عانيت بسبب هذا الهاشتاق في التحقيق الأول، ولكن من يبالي، فالممطورة ما بتبالي من الرش، أو كما قال أهلونا.
قبل بضعة أيام من التاسع عشر من ديسمبر، جمعتنا جلسة أنا وحسام قريش وأحمد تاج السر ومحمد عبد الغني ومحمد مدني وغيرهم في الناحية الجنوبية حدائق النخيل "حبيبي مفلس"، دار حديثنا في مجمله حول ذات القضايا،
بيد أننا حاولنا فيه الإستئناس بآراء بعض الشخصيات المنسوبة للقوى السياسية المعارضة والناشطين السياسيين، أذكر فيما أذكر أنها تباينت في قراءة المشهد المضطرب، ولكنها اتفقت على شيئين، ألا وهما خلو جراب النظام من أي حلول مما يعني تفاقم الأزمات، وعدم رهانهم على الشارع بمبررات مختلفة.
في تلك الجلسة تباينت أراؤنا أيضا، بيد أني لن أنسى أنني وحسام اتفقنا على أن الغضب الساطع آتٍ لا محالة وفي القريب العاجل، لم يكد ينفض السامر حتى اشتعلت الشوارع في عطبرة، وخرج مواطنوها عن بكرة أبيهم، شيبا وشبابا، رجالا ونساءا،
وانتهى بهم الأمر إلى إحراق دار المؤتمر الوطني، حيث تتجسد سلطة المستبد، لم يكن إحراقها إحراقا لجدرانها، بل لرمزيتها، كانت قطيعة بكل المعاني بين عصر المعاناة والظلم الموروث وبين مستقبلهم الذي يحلمون به، كأنهم يريدون أن يوجهوا خطابا ملتهب اللهجة للنظام،
بأن أيامكَ قد شارفت على النهاية، وأنا سنرمي بك في مزبلة التاريخ، وها نحنُ ذا الليلة شاهرين هتافنا في وجهك، ها نحنُ ذا نُحرِقُ دارك، ليس لك موطئ قدمٍ بيننا،
فكانت بذلك ملحمة تعيد إلى الأذهان سقوط الباستيل كما ذهب الصديق عبد العظيم البنا، إعلانٌ نهائي بأن بلغ السيل الزبى، وأنْ آن أوانُ التغيير بلا رجعة.
كان حراك أهل عطبرة في تقديري إعلانا رسميا لبداية الثورة، وذلك لحجم الحشود، وتحول المطالب وبسرعة من مطالب إقتصادية للمطالبة بسقوط النظام،
ثم الإفصاح عن هذا المطلب بسفور من خلال إحراق الدار، مما جعلها سنة حسنة سارت بها سائر المدن من بعد عطبرة، فسقطت دور الحزب الحاكم دون الغضب الشعبي دارا تلو دار.
أعلن تجمع المهنيين عن نفسه ووجد التفافا معقولا من الساسة والناشطين في العمل العام وطلاب الجامعات والحادبين على التغيير، فدعى لموكب الخامس والعشرين من ديسمبر، لبى كل أولئك الدعوة، فخرج الموكب بثوبٍ ثوريٍ قشيب، أعاد للشوارعِ عافيتها، وللناسِ الأمل في إمكانية التغيير.
تلت تلك الدعوة دعوة أخرى لموكب تقرر له الحادي والثلاثين من ديسمبر، تقابلنا فيها ثلاثتنا مجددا لنتفاكر حول إمكانية تطوير تصعيد العمل الثوري، فالمراقبون للوضع الإقتصادي يعلمون أن النظام على التحقيق في أوهن حالاته منذ الثلاثين من يونيو المشؤوم،
ولا يجب أن تفصل الإحتجاجات فترات متباعدة، تمهل النظام بريهات يلتقط فيها أنفاسه، إذ أنّ المعركة معه هذه المرة ليس من المتوقع أن تنتهي بضربة قاضية، بل هي أشبه بمعركة جمع النقاط، أو فلنقل أقرب ما تكون لحرب الإستنزاف.
كنا نفكر كثيرا في ما أطلقنا عليه "حرب العصابات"، ولكنها تأتي بالتزامن مع جدولة أسبوعية ثابتة للمواكب المركزية، ينبغي أن يتجه لإعلانها تجمع المهنيين. في تلك الأثناء وقبل موكب "31 ديسمبر" إلم تخني الذاكرة ظهر ما يسمى بـ"تنسيقية الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني"،
فناصبناها أشد العداء ليقيننا بأنّ تلكَ المرحلة لم تكن تحتمل وجود الأحزاب بكل تاريخها المتشِح بدثار الممارسات السياسية الرعناء والشائهة، والتي جنينا ثمارها حنضلاً تمثل في حكومة الإنقاذ.
كان من الواضح أن نواة المقاومة الأولى التي تشكلت إبّان إعلان تجمع المهنيين عن قيادتِهِ للإحتجاجات والتفاف الفوج الأول من الثوار حوله في المواكب الأولى لم تتشكل إلا لاطمئنان الناس حول دفوعات التجمع كجهة نقابية لا تنطلق من أي أجندة حزبية، من هنا كان هجومنا الشديد على التنسيقية،
ولم يدفعني شخصيا في هجومي هذا كراهية أو عداء تجاه الأحزاب كأجسام سياسية، فأنا أعلمُ ألا ديموقراطية بلا أحزاب، بل وأعلمُ أنّها الشر الذي لابُدّ مِنه، ولكن لمّا يحِن الوقت لولوجها إلى المشهد بعد،
وقد كتبتُ حينها بأنّ على الأحزاب إن كانت جادة وصادقة في دعمها لجذوة الحراك الوطني الوليدة فعليها بتذويب عضويتها في تجمع المهنيين ورفد الحراك السياسي من خلاله،
لم أكن أملك تصوراً كافيا عن كيفية إجراء هذه الخطوة بيد أنّي أعلمُ ألّا خيار أمامنا وغالبية الشعب السوداني ما زال قابعاً في منطقة الحياد وانعدام الفعل السياسي حينها، فهو ذات الشعب الذي لا ينسى وهتف بتلقائية غير مرة "العزاب ولا الأحزاب"،
ومن هنا دائما يلتقط العساكر القفاز معتبرين أن تذمر المواطنين من سياسات الأحزاب المتصارعة حول السلطة مع إهمال وتجاهل ممنهج لقضاياهم المعيشية الملحة بمثابة ضوء أخضر لقرع مارشاتهم العسكرية والإستيلاء على السلطة.
كان كل هذا العته في الذاكرة، قد استرقت النظر للحظة مّا فيما بعد سقوط النظام، لن أنكر أني كُنتُ شديد التفاؤل ولا شيء يدعو للتفاؤل حينها ولا حتى لبعضه، فوجدتُ هذا المشهد بشكل مجرد، أحزاب تزعم أنها من صنعت الثورة، وأخرى تنعتها بالمتسلقة على نضال الشعب،
لم يكن يعنيني الإنتصار لأي طرف، فقط لم أُرِد أن تنهزم تضحيات جيلنا عند مطب صراعات أيدلوجية أو سياسية عفت عنها يد الدهر، فقد كنا في الشوارعِ بمختلف انتماءاتنا المذهبية والسياسية والإثنية والجغرافية وغيرها، لا مجال للمزايدة بيننا،
تدخل المزايدة الملعب عندما تدخل المصالح، والأحزاب لا تدفعها أي مصلحة وطنية وهذا رأي شخصي راكمتُ يقيني به عبر المطالعة والمدارسة والمعايشة حتى استقرت خلاصته في نفسي، ولعل هذا ما يحدث الآن .
لم يكن معاش الناس في يوم من أولويات الأحزاب إلا على مستوى الشعارات والخطب والبرامج الإنتخابية في الدمويقراطيات الوئيدة، بل صراعا سياسيا سرمديا حول كراسي السلطة، ربما لو تمعنا قليلا في تاريخ هذا الصراع فلن نجد له جذور موضوعية تجعلنا نتفهم طبيعته،
لم تكن إلا رعونات تدفعها روعنات تُقابلها رعونات بالجهة المقابلة، فكانت ثمرتها على طول المدى جحيم لم يتلظى به إلا السودانيين،
فيما كان ولا زال يستمتع المعتركين في غير مُعترك بخصوماتهم المترفة والبعيدة عن هموم الناس ويُديرونها من شُرُفات قصورِهم الفارهة، وغرفهم الفخمة في فنادق دول العالم الأول.
كثفنا هجومنا ليومين حتى خَفَت صوت التنسيقية وصداه معا، وبدأنا نتحدث عن ضرورة توسيع دائرة الإحتجاجات في كل زمانٍ ومكان لاستنزاف عسس النظام ذهنيا وبدنيا، ومن خلفهم النظام إقتصاديا بمزيدٍ من الصرف على الحوافز والعلاوات وخلافه،
كانت التفاعل إيجابيا، مما حدا بنا للتفاكر حول الإعلان لموكب إبان موكب الحادي والثلاثين، فالداعي لتدشين المبادرات الإحتجاجية ينبغي أن يكون في رأس الرمح، لكي لا يوصم بزج الناس في المحارق والإكتفاء بالتحرض من خلف شاشات الهواتف الذكية.
لم يكن موكب الحادي والثلاثين بذات القوة التي اتسم بها موكب الخامس والعشرين لا من حيث الإستمرارية الزمنية ولا من حيث العدد، بيد أنه كان مرضيا إلى حد ما.
تقابلنا بعده وتناقشنا حول ضرورة إعلان موكب خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، ندشن من خلاله فكرة توسيع الإحتجاجات والمبادرات، ونضغط من خلاله على تجمع المهنيين للإعلان عن جدولة أسبوعية ثابتة.
أفقت عصر الأول من يناير على دعوة من الصديق أحمد الشريف لموكب ينطلق من صينية القندول في تمام الحادية ظهرا في الثاني من يناير، لم أتفاجأ فالدعوة وقعت داخل الفترة الزمنية التي اتفقنا عليها قبلا،
فتبنيتها وأعلنتها مصحوبة بهاشتاق الموكب وتاريخه، وذهبت إليه في بيته، ووجدته متكوما حاسوبه يتابع تفاعل الناس مع الدعوة، عاينت التفاعل بدوري وبدأت بالنشر حول الدعوة وجدواها.
بدأنا بالتواصل مع عدد مقدر من الأصدقاء الداعمين للموكب عبر الماسنجر والواتساب والمكالمات، على رأسهم يوسف محمد يوسف وأحمد ود اشتياق وعبد المتعال صابون وفيصل موسى وعبد العظيم البنا وغيرهم كثر،
ربما فاق عدد المؤيدين والملتزمين بالموكب مئتي شخص، قد تستغربون ولكن في تلك الأيام لم يبلغ الخوف بالنظام من الإحتجاجات مبلغا يجعله يوجه جهاز أمنه لتتبع المحتجين عبر هواتفهم بعد.
في تلك الأثناء وبينما كنا نأخذ ونرد مع المحتجين على فكرة الموكب في الفيسبوك وتويتر دخل محمد سيد أحمد ومن بعده حسام قريش، تأكد دعمهم للموكب، بعد بضع ساعات من النقاش خرج سيد أحمد ليقضي غرضا ما، وظللت أنا وحسام وأحمد نعد أنفسنا لليلة عسيرة قبل الموكب.
سأرجع قليلا للوراء لأتحدث عن أمر في غاية الأهمية، عانينا منه في دعوتنا، ولذلك أجدني متفهما وداعما للصديق عبد الله جعفر في دعوته ليوم القيادة في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، عندما أعلنّا عن موكب الثاني من يناير انقسم الناس حول دعوتنا إلى مؤيدين ومعارضين.
• المؤيدين انقسموا بدورهم إلى قسمين:
- داعمين لقيام الموكب في تاريخه ومكانه.
- داعمين لقيام الموكب في تاريخه مع تغيير المكان.
- داعمين لقيام الموكب في تاريخه ومكانه.
- داعمين لقيام الموكب في تاريخه مع تغيير المكان.
• المعارضين انقسموا إلى قسمين:
- معارضين لتوقيت الموكب، ودفعوا بأنّ فترة الإعلان ليست كافية.
- معارضين لأي موكب لا تتم رعايته والإعلان له عبر صفحة تجمع المهنيين السودانيين، ودفعوا بأنّ أي دعوة خارج جدول التجمع "الذي لم يُعلَن عنهُ بعد" تدخل في باب شق الصف ولو بغير قصد.
- معارضين لتوقيت الموكب، ودفعوا بأنّ فترة الإعلان ليست كافية.
- معارضين لأي موكب لا تتم رعايته والإعلان له عبر صفحة تجمع المهنيين السودانيين، ودفعوا بأنّ أي دعوة خارج جدول التجمع "الذي لم يُعلَن عنهُ بعد" تدخل في باب شق الصف ولو بغير قصد.
حتى هنا لا توجد مشكلة، لأنّ الإختلاف ما زال في باحة التدافع بين وجهات النظر، ولم يتعداها لتفتيش النوايا، بيد المشكلة كلها تأتي مع مَن ذهبوا لاتهامنا مباشرة بالتعامل مع الأجهزة الأمنية بغرض الإيقاع بالثوار، ولم يروا في موكبنا إلى طعم نحاول به اصطياد المحتجين لوأد الحراك في بدايته.
مما أحزنني أنّ بعض هؤلاء ممن نحسبهم ثواراً وطنيين، لا تدفعهم في مناجزة النظام إلا أجندة وطنية خالصة. أجدُ اليوم أنّ الكثير منهم يصِمون بعض أعضاء تجمع المهنيين بالخيانة!
يبدو أنّ القضية ليست في تجمع المهنيين ولا فينا، بل في مدى تطابق موقفك مع موقفهم، الذي إن انطبق تماماً مع مذهبهم فأنت الثائر الوطني الجذري الذي لا يساوم،
وإن لم يتطابق بالقدر الكافي فإنّ فيكَ خَوَرٌ وهشاشة، ويمكن أن توصف تقديراتك على إثرها بـ"الهبوط الناعم" مثلاً، أما إن تباينت التقديرات فإنّكَ أمنجي لا محالة، وعدو للتغيير!
في الحقيقة ما زلتُ عاجزاً عن فهم هذه الفئة التي ما إنْ تُميط أكف الأحداث براقع التباين في وجهات النظر حتى تقفز إلى اتهام الأصوات المختلفة في وسائل المقاومة، وأجندة التغيير بالخيانة! ويدخل في ذلك خيانة: "دماء الشهداء، الثورة، الوطنية ..إلخ".
هذه التهم الجزافية هي أدخلُ عندي في باب الرَجْمِ بالرأيِ الفج، وافتعالِ معاركٍ في غيرِ معترك، ولا تصدرُ إلّا عن نفوس مريضة، امتلأت بالغل والحسد والكراهية، وعقول تالِفة، لا تفهم الحياة بله العمل السياسي.
كان التنسيق جاريا على قدمٍ وساق مع الأصدقاء العازمين على مشاركتنا الموكب، علمت حينها أن أحمد الشريف قد تواصل مع الصديق يوسف محمد "قطيع" ليستكشف عبر عربته الموقف في صينية القندولليلة الثاني من يناير، وجاء إفادته على دفعتين،
أتت الأولى لتؤكد ارتكاز قليل من عرباط شرطة الشغب، والثانية بعدها بساعتين ربما وأشار يوسف من خلالها إلى أن أعداد القوات الأمنية والشرطية قد تضاعف حتى غصت بهم القندول، فابتسمنا لتحقيقنا الإنتصار الأول،
حيث أننا بدعوتنا تلك اضررنا الأجهزة الأمنية للإستعداد في ذلك البرد القارص، وهذا ما نعنيه بحرب الإستنزاف البدني والذهني والإقتصادي، بحيث أننا حتى ولو ألغينا الموكب تماما فلن نكون الطرف الخاسر بأي حال من الأحوال.
خرج أحمد الشريف ليقابل أحد معارفه، حيث تكفل بإعارتنا مكبرا للصوت يشبه مكبرات باعة الخضروات والفواكه في الأسواق، وقد تحركنا من خلفه لتأمينه في حال حدوث أي أمر خارج على الحسابات،
جلبنا المكبر، ومضت ساعات الليل الباردة بلا غداء ولا حتى عشاء، نتابع فيها تعليقات الأصدقاء وغيرهم، لا يمكنكم أن تتخيلوا عدد المكالمات التي استقبلناها لكي نُعْرِضَ عن هذا الأمر، ولكننا كنا قد عزمنا ولن نرجع شبرا.
أصبح علينا الصبح ولم نكد نغمض أعيننا قبيل ساعة أو ساعتين على الأكثر، افتتحنا يومنا بالإستحمام، واحتساء الشاي، تركت هاتفي في منزل أحمد الشريف، الذي ترك هاتفه أيضا، إلا أن حسام حمل هاتفه، لففنا مكبر الصوت بقطعة قماش، ووضعناه في كيس بلاستيكي أشبه بـ"مخلاية"،
وتوكلنا على إيماننا بخيارنا، استأجرنا عربة أمجاد زرقاء اللون، كان يقودها شيخٌ ستيني، اتضح من خلاى الثرثرة الجانبية معه خلفيته الختمية، لم يدخل بنا عبر موقف جاكسون لشدة الإزدحام، بل اختصر طريقه عبر كلية البيان، حتى توغلنا في قلب السوق،
ولما اقتربنا من القندول تفاجأنا بحشد أمني كثيف، أكبر حتى من الحشد الذي أُعِدّ لموكب الخامس والعشرين، كان رجالات الأمن يمشطون الطرقات، وينظرون عبر نوافذ العربات والمركبات الخاصة والعامة، بدا لنا أنهم بانتظارنا فعلا،
ولحسن حظنا أنهم لم يلاحظونا في ذلك الإزدحام الشديد. طلبنا من الشيخ الجليل التوقف، فتوقف وسألناه أن يدعو لنا، فابتسم وتلا علينا:
يـا ربـي بهـم وبآلهــمِ
عَجِّل بالنصرِ وبالفرجِ
يـا ربـي بهـم وبآلهــمِ
عَجِّل بالنصرِ وبالفرجِ
أمَنّا بصوتٍ واحد، ومضينا نبحث عن مكان نستقر به حتى انطلاق الموكب الذي لم يتبقى لموعده سوى نصف ساعة، فاتخذنا من زاوية اختارتها خالة وديعة لتبتاع فيها الشاي والقهوة متكأ لنا،
طلب أحمد وحسام القهوة، بينما طلبت كوبا من الشيريا، لم نكن نتسامر بل نراقب الشوارع عسى أن نلمح بعض الأصدقاء، ففشلنا في ذلك وانتهينا إلى أنهم حتما موجودون في مكان ما وسيظهرون في اللحظة المناسبة،
نظرنا إلى الساعة، لم يتبقى إلى دقيقة، تحركنا كل على حدة صوب القندول، وفي تمام الواحدة ظهرا دخلنا من جهات مختلفة وأخرج أحمد مكبر الصوت ودخل إلى مركز دائرة القندول تماما وبدأنا بالهتاف:
-يا بشير يا جبان الثوار في الميدان-
وحدث ما حدث "يضحك"
-يا بشير يا جبان الثوار في الميدان-
وحدث ما حدث "يضحك"
علمنا لاحقا أن أصدقاءنا كانوا حضورا ولكن تباينت تقديراتهم للموقف، وبدا الأمر أشبه بانتحار، بطبيعة الحال لا يمكننا أن نزايد عليهم، فهذه الأمور لا يحكمها منطقٌ واحد،
وعلمنا ممن تم إلحاقهم بنا في زنازين الأمن السياسي أنّ السوق العربي قد أُغِلق تماما بأمر القوات الأمنية بسبب موكبنا الصغيرِ ذاك،
تخيلوا حجم الخسارة المالية! وعلمنا أنّ النقاش حول مدى صحة ما أقدمنا عليه قد استغرق وقتا من الناشطين في مواقع التواصل، مما دفع تجمع المهنيين لإعلان جداوله الثابتة وإعلان تأييده لكل المبادرات خارج جدوله،
والتي تطورت لاحقا لتشكل مواكب الأحياء ولجان المقاومة غير المعلنة، التي كانت سببا مباشرا في دخول حمى الثورة لكل بيوتات أهالينا، حتى تطورت شكلا ومضمونا فكانت الرهان الكاسب في كسر الطوق الأمني المفروض حول نقاط التجمع والمسارات المعلنة في السادس من أبريل المجيد.
لن أنكر أنها كانت واحدة من أنصع لحظات "ركوب الراس" التي خضتها وعايشتها، لكنه بحسبي ركوب راس محمود وليس مذموم، فبالرغم من أنّ الحكمة منشودة في كل شيء، ولكن ثمت لحظات لا تحتمل التعقل والتأني والحكمة، بل تحتاج لمصادمة مجنونة تخترق حُجُب المجاز التقليدي للتعقل والمنطق،
لا سيما إن كان صاحب تلك اللحظة قد استفتى قلبه واستهدى بحدسِهِ وانغمر حتى أخمصه بإيمان عميق ودافئ بجدوى ما سيقدم عليه، وهذا سيخرجه من دائرة التهور والطيش إلى براح الإطمئنان إلى الموقف الصائب بحسبِه،
ومن سِمات المناجِز لهذه الملمات بهذه الطريقة وفي تلك اللحظات أنّهُ لا يُزايِد بخياره على أحد ولو تم اضطراره إلى أضيق سبل المزايدة المناوئة، كما أنه لا يقبلُ الإبتزازات العاطفية أيضا باسم موقفه ذاك.
أخيرا فلا أقول إلا:
يا أصلنا ومبتدانا
يا حلاة مسرح صبانا
وذكرياتنا ومشتهانا
إنت فينا كبير
وريدنا ليكا كتير
القومة ليك يا وطني
عاش كفاح الشعب السوداني
عاشت ثورة ديسمبر المجيدة
يا أصلنا ومبتدانا
يا حلاة مسرح صبانا
وذكرياتنا ومشتهانا
إنت فينا كبير
وريدنا ليكا كتير
القومة ليك يا وطني
عاش كفاح الشعب السوداني
عاشت ثورة ديسمبر المجيدة
جاري تحميل الاقتراحات...