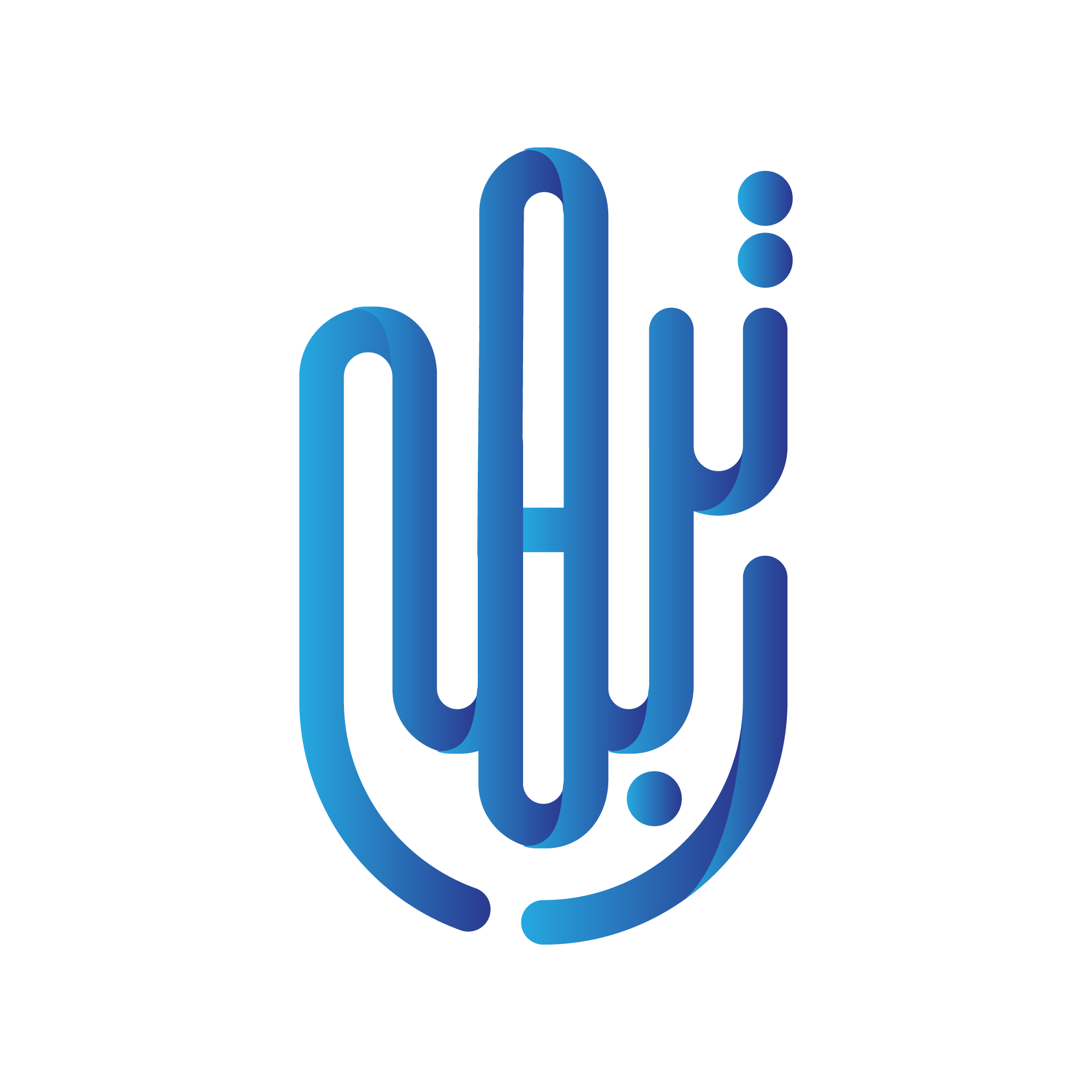هذه التساؤلات كادت تدفعه إلى الإنتحار والتي جعلت من تولستوي يكتشف أن البشرية ما كانت لتستمر في هذه الحياة لولا ذلك التفسير الذي يلغي العقل من خلال فكرة الإيمان التي يعرّفها على أنها "فهم لمعنى حياة الإنسان، وأن الإيمان هو قوة الحياة".
هذا كتاب له خصوصيته التي لا تقارن بأي من كتابات تولستوي الأخرى على عظمتها، لم يأخذ هذا الكتاب -ضمن كتابات تولستوي الدينية - ما يستحقه من شهرة مثل أعماله الأدبية.
لا لأنه أقل قيمة بل لأنه يحوي مفاهيم ومعرفة روحية عالية لم يمكن أن تقدّر في الوقت الذي كتبها فيه -في أواخر القرن التاسع عشر- ولا على مدى القرن العشرين كله، حيث سواد المادية لا يعطي الفرصة لفهم هذا الكتاب وتقديره إلا بين القليلين في عصره ممن يقدرون التجربة الروحية.
لكن في سن 18 بدأ يشعر بأن إشارات الصليب التي يؤديها وانحناءات الركبة تعبداً واحتراماً في صلاته ليس لها أي مدلول عنده وأنه غير قادر على الإستمرار في الكذب "على حد وصفه" فتوقف عن أدائها تماماً!
لكن - كما يقول- "كان بداخلي شعور بأني أؤمن بشئ ما، أؤمن بإله أو بمعنى آخر لا أنكر وجوده، ولكن أي إله؟ لم أكن أدرك على وجه التحديد! أذكر أيضا أني لم أكن أنكر تعاليم المسيح؟ لكن ماذا كانت تعني لي هذه التعاليم وقتها؟ لا أستطيع أن أعرف تماماً".
ينطلق الشاب ناشداً الكمال والإكتمال في كل شئ، في علومه، في المعرفة العامة، في صحته ولياقته البدنية، ومع هذا كله وفوقه ينشُد" الكمال الأخلاقي" فماذا يجد؟
يقول في اعترافه: "كلما حاولت أن أعبر عن رغبتي العميقة وطموحاتي الأخلاقية، كنت أُقابل ممن حولي بالإزدراء والإحتقار، وبمجرد ما أسلّم نفسي للرغبات الوضيعة أقابل بالمدح والتشجيع!"
فبدأ الشاب الصغير يستبدل طموحاته الأخلاقية بطموحات أخرى يقرها المجتمع، يعبّر هو عن هذا المجتمع الذي نشأ فيه بقوله أنه مجتمع يعتبر أن القوة، المصلحة الذاتية، الإنغماس في الشهوات، التكبر، الغضب، الإنتقام" هي الصفات التي يجب أن تحترم!
فأصبح طموحه الأساسي أن يكون أكثر شهرة وأكثر أهمية وأكثر ثراء من أي إنسان آخر حتى لو كان ذلك -كما يقول- من خلال ارتكاب أي خطأ أخلاقي.
ويتذكر تولستوي هذه الفترة قائلاً: كنا نتحدث جميعاً في وقت واحد ولا يستمع أحد للآخر، أحياناً يمتدح واحد منا صاحبه انتظاراً لمدحه في المقابل وأحيانا تتعالى صرخات الاعتراض فيما بيننا كما لو كنا في مستشفى للأمراض العقلية!
في إحدى رحلاته لباريس يرى شباباً تُجتث رؤؤسهم من قِبل السلطة بحجة أنهم من أعداء "التقدم"، يحرك المشهد أعماقه فيقول في نفسه: "لو كان كل الناس منذ بدء الخليقة وحتى الآن تحت أي مزاعم يقتنعون بأن مثل هذا العمل ضروري فأنا أعرف تماماً أنه ليس ضرورياً وأنه خاطئ".
من هنا يرى أن الحكم على أي شئ بأنه ضروري وصواب يجب ألا يأتي من أي مصدر خارجي مهما كان، لكنه يجب أن ينبع مما تستشعره الروح.
في موقف آخر يموت أخوه الأكبر بعد معاناة مع المرض فيقول تولستوي في نفسه وهو يعتصره الحزن: "مات دون أن يفهم لماذا كان يعيش أو لماذا مات" لكن الأمر كله عند تولستوي كان لا يزال مرهوناً بما سيأتي به التقدم فيقول: ما لا أفهمه الآن سأفهمه غداً من خلال التقدم.
بعد هذين الموقفين يشعر بأن هناك سؤالاً في أعماقه عن المعنى الحقيقي للحياة، وكان مؤرقاً له بينما لم يملك إزاءه إلا الهروب بالإنغماس في العمل. كان في بداية الثلاثينات من عمره ففكر أن تكوين أسرة قد يهدئ من هذه النفس المؤرقة بلا سبب معروف.
وفي وقت كان فيه تولستوي يتمتع بكل ما يمكن أن يصبوا إليه إنسان في حياته المادية، حيث كان في بداية العقد الخامس من عمره، يتمتع بصحة ممتازة، يلقى شهرة ونجاحاً فائقاً، لديه أموال وأموال، وحياة أسرية ناجحة بكل المقاييس، فيفاجئه سؤال من الداخل : وماذا بعد؟!
يهرب من السؤال ويقول لنفسه: حين أفرغ من هذا العمل سأفكر في إجابة، لكن السؤال لا يبقى مجرد سؤال أو خاطر عابر، إنه يأخذه إلى حالة نفسية من الاكتئاب والرغبة في الإنعزال!
تبدأ مرحلة في حياة تولستوي أقل ما يقال فيها أنها عذاب متواصل، عدم قدرة على الحياة بسبب الإحساس بأن أي سعادة أو تعاسة في هذه الحياة ما هي إلا خدعة كبيرة، والسؤال بداخله عن معنى أعمق وأدوم لا يفارق كيانه.
فلا هو يستطيع أن يتجاهله، ولا هو قادر على مواصلة الحياة كما كانت باستبعاده، ولا هو قادر على الإجابة عليه!
يتبع.
يتبع.
"ما نتيجة أي فعل أقوم به اليوم أو غداً؟ ما هي نتيجة حياتي كلها؟ هل هناك أي معنى للحياة سيبقى ولا يفنى بقدوم الموت المحقق الذي ينتظرني؟" يعبر عن هذا بقوله: "بحثت عن إجابة لأسئلتي في كل فروع المعرفة التي اكتشفها البشر!
بحثت لفترة طويلة وبكد عظيم، لم أبحث بقلب فاتر أو لمجرد حب الاستطلاع ولكن كنت أبحث وأنا يشملني العذاب ولايفارقني الإصرار ليل نهار كإنسان يحتضر ويبحث عن أي مخرج للنجاة، لكنني لم أجد شيئاً!
هنا يلخص تولستوي إجابات العلم عن ظاهرة الحياة وهي أنها تصف هذه الظاهرة وتصف ظاهرة توقف الحياة من خلال توقف أجهزة الإنسان جميعاً ومعها تختفي من هذه الحياة تساؤلاته وكل ما كان العقل يفكر فيه.
أما الفلسفة- كما يقول- فإنها تقول إن الوجود كله هو وجود مطلق ولا يمكن الإحاطة به والإنسان نفسه هو جزء غامض من هذا الوجود الغامض.
ولم تكن مجرد قراءة، بل كان كصريع من الظمأ يبحث عن نقطة ماء وسط الصحراء، بنفس الروح التفت إلى الناس، علّه يجد دليلاً، فوجد معظم الناس في حالة من الهروب من الإجابة عن السؤال عن معنى الحياة.
و هُم حسب تصنيفه ينقسمون إلى أربعة أنواع:
الأول يهرب من خلال الاكتفاء بالجهل ولا يسعى للمعرفة.
والثاني يهرب من خلال منهج في الحياة يجعل الهدف منها هو اللذة واتباع الشهوات.
الأول يهرب من خلال الاكتفاء بالجهل ولا يسعى للمعرفة.
والثاني يهرب من خلال منهج في الحياة يجعل الهدف منها هو اللذة واتباع الشهوات.
النوع الثالث يتسم-كما يقول- بالشجاعة والقوة لأنه يعرف أن الحياة كلها شر ولا طائل من ورائها فيرفضها ويُقدِم على التخلص منها.
أما الصنف الرابع فهو "ضعيف" لأنه يعرف أن الحياة كلها "عبث وعدم" ورغم ذلك فإنه يفتقد الشجاعة للتخلص منها.
تولستوي صنّف نفسه في النوع الرابع لأنه يتعذب ولا يجد معنى للحياة لكنه أيضا لا ينتحر.
تولستوي صنّف نفسه في النوع الرابع لأنه يتعذب ولا يجد معنى للحياة لكنه أيضا لا ينتحر.
في هذا الوقت من تجربته كان تولستوي لا يعرف حتى لماذا لا يقدم على الإنتحار، رغم أن الفكرة راودته كثيراً، وكان كل العذاب واليأس داخله يدفعه لأن يمسك بحبل ليخنق نفسه أو يمسك مسدسه ويطلق رصاصة واحدة فينهي بها عذابه، فكان يتجنب التواجد مع "حبل أو مسدس" في أي مكان!
تحوّل تولستوي من البحث في الكتب وبين أفراد طبقته، إلى العامة، فلمس شيئاً بينهم أشعره بأنهم يعيشون معنى الحياة حتى لو كانوا غير قادرين على التعبير عن هذا المعنى، يكفي أنهم سعداء راضين بالحياة رغم أنهم ينقصهم الكثير من رفاهية الماديات التي تتمتع بها طبقة المثقفين والأثرياء.
وهم لا يرفضون الحياة ولا يرونها عبثاً مثل الطبقات التي يعيش بينها.
شعر تولستوي بالراحة للعيش وسط هؤلاء البسطاء، لكنه كان يشعر بأن هناك نوعاً ما من المعرفة يحتاج إليه ولم يجده بعد.
شعر تولستوي بالراحة للعيش وسط هؤلاء البسطاء، لكنه كان يشعر بأن هناك نوعاً ما من المعرفة يحتاج إليه ولم يجده بعد.
من هنا بدأت مرحلة جديدة في حياته وجد فيها شيئاً كان بمثابة اكتشاف عظيم، أيقن أن الإجابة عن تساؤله الأساسي: ماهو المعنى الذي لا يحطمه الموت؟ لا يمكن أن توجد إلا في "العقيدة"، فالمعنى الذي لا يموت هو توحد الإنسان مع مالا يموت، في توحده مع الله!
أدرك تولستوي الآن بل أيقن أن هناك نوعاً من المعرفة تختلف عن "معرفة العقل" أو الذهن، لأن معرفة العقل تتعامل مع كل ما هو مؤقت، وهي مصدر الحقيقة عن كل ما هو مؤقت، لكنها لا يمكن أن تكون مصدراً للمعرفة عما هو خالد، عما لا ينتهي بالموت.
هنا يقول تولستوي: إذا غاب عن الإنسان الفهم والبصيرة بأن كل ما هو مؤقت ليس إلا نوعاً من الوهم، فإنه لن يؤمن إلا بما هو مؤقت، أما إذا رأى ببصيرته أن كل ما هو موقوت ليس إلا وهم فحينئذ سيؤمن بما هو باقي ودائم.
بهذا اليقين انطلق يبحث في المعرفة الدينية المسيحية من خلال من حوله من رجال الدين، كان يسألهم عن إجابة لمعنى الحياة كما يعيشونها، لكن لأن الأمر بالنسبة له لم يكن مجرد كلام أو أشكال، فإن شيئاً جوهرياً جعل تولستوي يدرك أن نوع العقيدة والمعرفة التي يريد أن يحياها لا توجد عند هؤلاء!
فهُم -كما رآهم- لا يعيشون حياة يطبقون فيها ما يقولونه، إنهم مثل كل من لا عقيدة لهم بل ربما أكثر حرصاً على حياة المادة والثراء والشهوات وربما السلوك اللاأخلاقي!
وهنا يخبو عند تولستوي الأمل الذي كان قد ولد داخله بأنه على وشك أن يجد إجابة لتساؤلاته، بل حيرته، بل بحثه بالروح والعقل والقلب والجوارح، ليس بحثاً عن إجابة سؤال بل بحثاً عن الحياة نفسها!
يتبع.
يتبع.
ماذا يفعل الآن وقد طرق كل الأبواب بشدة ولم يفتح له؟ مرحلة جديدة من العذاب، واستنفذ كل ما يستطيع أن يفعله بنفسه!
فإذا به يدعو الله قائلاً: "أدعوا من أبحث عنه لعله يساعدني، وكلما دعوته كلما بدا لي أنه لا يسمعني، ولا يوجد من ألجأ إليه أبداً، وبقلب مليء بالحزن توجهت من جديد أصرخ: يا إلهي رحمتك، انقذني، أرني الطريق!!
بدا له أيضا أنه ليس هناك من مجيب وأن الحياة به قد وصلت إلى نهايتها، وفي قمة اليأس يتطرق إلى ذهنه خاطر جديد: "إن المفهوم عن الله ليس هو الله"، "أنا أبحث عن الله الذي بدون وجوده لا توجد حياة، هاهو الله، هو الحياة! أن أعرف الله وأن أحيا هو معنى واحد، الله هو معنى الحياة!"
يقول: "وبأقوى من أي لحظة أخرى في حياتي أشرق كل شئ داخلي ومن حولي بالنور، ولم يفارقني هذا النور أبداً!
كانت هذه لحظة رائعة وفاصلة في حياة تولستوي .. لحظة ميلاد حقيقي سبقتها آلام وآلام .. آلام المخاض .. كل لحظة منها كان يشعر بعقله الإنساني أنها تأخذه إلى مرحلة جديدة من اليأس والضياع .. وكانت في الواقع تقربه من لحظة الميلاد العظيم.
بكل الحب والنور وعنفوان الحياة الحقة المتدفقة يريد تولستوي أن تكون حياته كلها تعبيرا عن عقيدته، وأول أساسيات العقيدة أن يكون في طلب لمدد من الحياة من أصل الحياة وذلك من خلال إقامة الصلاة، فيذهب إلى الكنيسة بروح الحب والرغبة في الإلتزام والإحترام لتعاليم الدين المسيحي.
لكنه يجد أشياء كثيرة في الطقوس لا يعرف لها معنى .. فيحاول هو بنقائه أن يضفي عليها معنى ومفهوماً من داخله .. لكن الوقت يمضي به وبداخله إحساس بأن هذه التعاليم يختلط فيها "الحق" بالـ"زيف" .. كيف يجد الخط الفاصل بينهما؟ لا أحد يستطيع أن يدله!
المفهوم الشائع هو إضفاء القدسية على الكنيسة ويبررون ذلك بأنهم يعتبرونها رمزا "للتجمع بالحب"، لكنه يرى الطوائف المختلفة تتهم بعضها بعضا بالكفر ..فأين هو هذا الحب؟ وحين يسأل أحد عن معنى من معاني الطقوس يقال له أن الطاعة واجبة سواء أفهم أم لم يفهم!
وكلما قرأ وبحث اكتشف أن هناك طبقات من "الدين الخاطئ" الذي يروج له رجال الدين ويفرضون فيه سلطتهم على الناس دون أن يكون لما يقولوه سند حقيقي من تعاليم المسيح، المنهج الذي اتبعه استطاع به فصل الغث عن السمين في كل شئ حوله، في نفسه أولاً، في مصادر المعرفة، وفيما يقول ويفعل الناس.
عكف تولستوي على تعلم العبرية واليونانية، ليتّسق له أن يطلع على المنبع الذي صدرت عنه مختلف ترجمات العهد القديم والعهد الجديد.
وهاجم الطقوس الدينية، واتهمها بأنها موضوعة ومزيفة، ونظر إلى الكنيسة نظرة تحدٍ ومناجزة، فقد رأى كيف تغلّف القشور الكاذبة فكرة الإيمان، وأخد يصوّب سهامه اللاذعة إلى الكنيسة داعياً إلى دين منزه عن التمويه والتضليل.
منهجه يبرز فيه نقاء القلب فلم يستطع أبداً أن يكون منافقاً أو كاذباً فيما يعتقد، حتى حين أخذته ثقافة المجتمع حوله وبريقها إلى طبقة من زيف الشهرة والمال فإن صوت الداخل أخذه إلى الحقيقة.
كان منهجه يحترم العقل ولا يقبل ما لا يقبله عقله، فينقذه صوت الداخل أيضاً من أن يكون سجين "معرفة العقل" وحدها، بل يفتح له مصدراً لمعرفة أخرى هي معرفة الروح التي تعلو معرفة العقل ولكن لا تتناقض معها.
كانت ثمار تجربته أن كل ما تعلمه حتى من قبل ميلاده الحقي ترجمه في النصف الأخير إلى سلوك يعبر فعلاً عن معنى الحياة.
فبأمواله ساعد الكثير والكثير من الفقراء
وبعقله تحولت العقيدة عنده إلى شيء لا ينافي العقل بل هو يؤكد على أنه من الدين القويم أن يلحق الإنسان بكل علوم عصره
وبقدرته الأدبية ترك كتابات دينية يفيد منها أي إنسان يريد أن يفرق بين الحق والزيف.
وبعقله تحولت العقيدة عنده إلى شيء لا ينافي العقل بل هو يؤكد على أنه من الدين القويم أن يلحق الإنسان بكل علوم عصره
وبقدرته الأدبية ترك كتابات دينية يفيد منها أي إنسان يريد أن يفرق بين الحق والزيف.
جاري تحميل الاقتراحات...