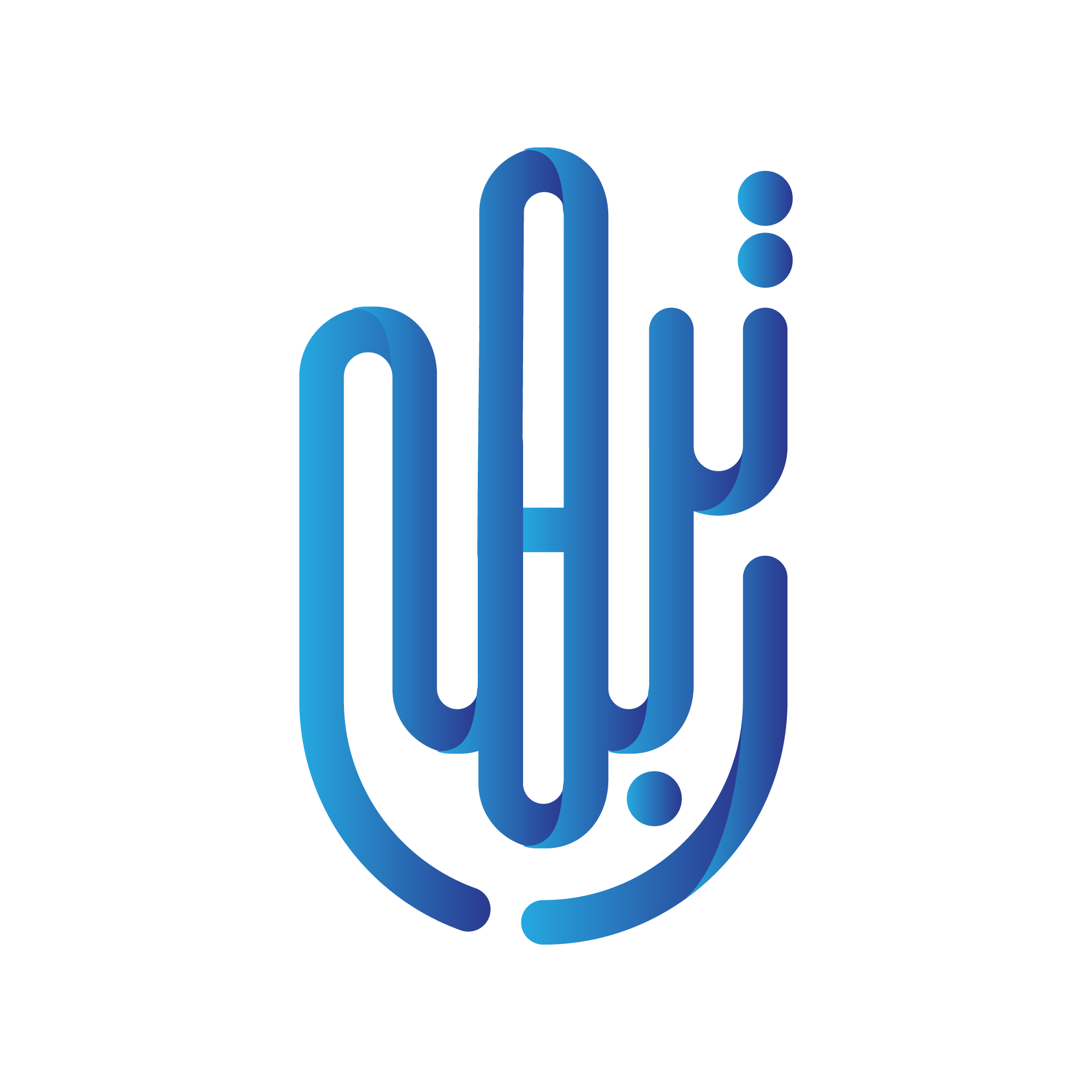حتى بلغت الـ 23 من عمري، لم تتجاوز رحلاتي بالطائرة الـ 3 مرات؛ مرتان للرياض ومرةً لجدة.
ولم يكن في ذلك الزمان التنوع الحاصل في هذا الوقت من شركات الطيران، والسهولة الحاصلة في حجز التذاكر.
ولم يكن في ذلك الزمان التنوع الحاصل في هذا الوقت من شركات الطيران، والسهولة الحاصلة في حجز التذاكر.
فإن ابتلاك الله يومًا واضطررت للسفر، فإن أول كابوسٍ تجده أمامك هو حجز تلك التذاكر.
يجب أن تتصل على الرقم الوحيد للخطوط السعودية والذي تتصل عليه كل المملكة لتحجز لسفرها.
يجب أن تتصل على الرقم الوحيد للخطوط السعودية والذي تتصل عليه كل المملكة لتحجز لسفرها.
كان البشر ينامون ويستيقظون والتلفون مايزال يرنّ على الخطوط، واعلم أن الشهر الذي تسافر فيه بالطائرة أنك ستبكي في أوله حتى تحجز تذكرتك، وستبكي في آخره عندما يرسلون لك وزارة البرق والهاتف فاتورة تلفونك ذلك الشهر.
وبعد أن يردون عليك ويحجزون لك تذكرتك، يجعلونك تسابق الزمن خلال 24 ساعة تذهب إلى المطار لتسدّد نقدًا هناك ثمن التذكرة وتستلمها.
يضعون لك التذكرة في ظرفٍ أزرق وعليه شعار الخطوط؛ السيفان والنخلة.
كانت فخامة الظرف توازي تمامًا فخامة من يمشي في شوارعنا اليوم بروزرايز.
يضعون لك التذكرة في ظرفٍ أزرق وعليه شعار الخطوط؛ السيفان والنخلة.
كانت فخامة الظرف توازي تمامًا فخامة من يمشي في شوارعنا اليوم بروزرايز.
كان الشباب يضعون ظرف الخطوط على المراية الأمامية لسيارتهم ليستميلوا بها قلوب النساء، كل نساء الحارة وكل الفتيات في مدارس أخت هذا الشاب وكل نساء تلك المدينة يتعالمون عن ذلك الشاب الذي سيسافر غدًا بطائرة ويتمنونه زوجًا لهم.
آخ كم كانت إمالة قلوب النساء بسيطة؛ ما أقبح نساء اليوم.
آخ كم كانت إمالة قلوب النساء بسيطة؛ ما أقبح نساء اليوم.
مرّ الزمان، انفجرت الأرض بشركات الخطوط، أصبح السفر إلى الخارج سهلًا، كل العالم سافرت.
إلا أنا، لم أتجاوز تلك الثلاث سفرات حتى توظفت وأرسلتني شركتي في سنتي الأولى من الوظيفة إلى خارج هذه البقعة الجغرافية المباركة.
إلا أنا، لم أتجاوز تلك الثلاث سفرات حتى توظفت وأرسلتني شركتي في سنتي الأولى من الوظيفة إلى خارج هذه البقعة الجغرافية المباركة.
أرسلوني إلى دبي لحضور دورةٍ هناك، وحجزوا لي التذاكر على الخطوط الإماراتية.
وكشخصٍ لم يذهب في حياته إلا على رحلات داخلية في الخطوط السعودية إلى رحلة دولية على الخطوط الإماراتية، فكأنك شخص كنت تستمع عمرك كله إلى الأغاني العراقية الهابطة؛ وفجأةً انتقلت إلى محمد عبده.
قمة الرقيّ.
وكشخصٍ لم يذهب في حياته إلا على رحلات داخلية في الخطوط السعودية إلى رحلة دولية على الخطوط الإماراتية، فكأنك شخص كنت تستمع عمرك كله إلى الأغاني العراقية الهابطة؛ وفجأةً انتقلت إلى محمد عبده.
قمة الرقيّ.
ذهبت إلى دبي، استقبلني رجل هندي ذو شارب عريض عند بوابة المغادرة ومعه ورقة يحمل اسمي بها، سلمت عليه كما أسلّم على عطران الشوارب في العزايم، كنت أحسبه زميل عمل وأنه يفزع لي ليس إلّا، ثم طلب مني أن يحمل شنطتي فأعطيته أيمانًا مغلظةً أنه وافي وأبيض وجه وإنه مايمسكها.
ثم مشينا سويةً حتى وصلنا السيارة فقفز أمامي وفتح ليَ الباب الخلفي، وأنا مازلت مؤمنًا أنه زميل عمل، وعيب وشقّ الجيب أن أعامله كما أعامل السواقين وأركب في الخلف؛ فأغلقت الباب وركبت بجانبه.
في الطريق وبعد شرحٍ طويلٍ منه أنه ليس موظفًا مثلي في المختبر، ورفضٍ مستمر منه أن يعطيني رقمه لنتبادل الخبرات، استوعبت أنه مجرد سائق في الشركة وأنه ذاهبٌ بي إلى الفندق فقط ثم يختفي من حياتي.
أخبرته أن يقف على جنب، نزلت من السيارة وركبت في الخلف ولما وصلنا إلى الفندق جعلته يحمل الشنط إلى غرفتي في الأعلى.
أمزح والله كملنا الخط واحنا ساكتين مانطالع فبعض ونزلت شلت شنطتي بنفسي آخر شيء.
أمزح والله كملنا الخط واحنا ساكتين مانطالع فبعض ونزلت شلت شنطتي بنفسي آخر شيء.
كانت موظفة الإستقبال امرأة مصرية، حسبتها مالكة الفندق في البداية من الكشخة.
في قصة أخرى نتفرّع لما حصل في الدورة، في هذه القصة نتفرّع في دبي وفي السفر إلى الخارج.
وعادة البشر العاملين هناك والموظفين -خصوصًا في الفنادق والمطاعم- أن يبتسمون لزبائنهم.
ومن سوء حظي أن الفندق الذي نزلنا به ثلاثة أرباع الموظفين به نساء.
فكل ما أدرت وجهي إلى واحدة وجدتها تبتسم لي، فرددت في خاطري: الله يلعني إنهم شافوا الجواز الأخضر وعرفوا إني سعودي وطمعوا فيني ويبغون يشبكوني عشان فلوسي.
إليهنّ اليوم أعتذر ??
فكل ما أدرت وجهي إلى واحدة وجدتها تبتسم لي، فرددت في خاطري: الله يلعني إنهم شافوا الجواز الأخضر وعرفوا إني سعودي وطمعوا فيني ويبغون يشبكوني عشان فلوسي.
إليهنّ اليوم أعتذر ??
بعد دخولي إلى الفندق، خرجت منه مهرولًا إلى دبي مول.
كنت أحسب أنه لا أكبر من الراشد مول على وجه الأرض إلّا صحراء الربع الخالي؛ فوجدت دبي مول أكبر منهما كليهما.
كنت أحسب أنه لا أكبر من الراشد مول على وجه الأرض إلّا صحراء الربع الخالي؛ فوجدت دبي مول أكبر منهما كليهما.
ثم ذهبت إلى نافورة دبي، فأخرج الله كل مافيني من جيناتٍ عربية ووضع فيني كل جينات الهند؛ معي جوال إن سبعين كاميرته من الخلف، أفتح الكاميرا وألف الجوال على وجهي وأبتسم ابتسامةً غريبة وأضع النافورة والبرج خلفي وأتصور.
أدفع دم عمري وأجد تلك الصور الآن.
أدفع دم عمري وأجد تلك الصور الآن.
حذرني والدي أينما تحذير عن الشراب والخراب وعن الحياة الليلية خارج السعودية.
فإذا استدارت الشمس إلى غروب، ذهبت أجري إلى فندقي لا أنظر خلفي خوفًا من حياة الليل وأن السكارى سينتشرون في الأرض يقتلون ويسرقون أي أحدٍ في الشارع بلا حسابٍٍ أو عقاب.
فإذا استدارت الشمس إلى غروب، ذهبت أجري إلى فندقي لا أنظر خلفي خوفًا من حياة الليل وأن السكارى سينتشرون في الأرض يقتلون ويسرقون أي أحدٍ في الشارع بلا حسابٍٍ أو عقاب.
ذهبت في اليوم التالي إلى زيارة الجي بي أر، فلم أجد إلّا مدينة الرياض مصغّرةً أمامي؛ شباب الرياض كلهم هناك، مقترضين من البنوك ومستأجرين سياراتٍ فخمة رافعين بها صوت أغنيةٍ تدلّ تمجّد السعودية ويدورون فقط هناك بلا هدف.
مازلت مؤمن أن قمة النشوة عند أهل الرياض حتى اليوم أن يعود الواحد منهم إلى منزله آخر اليوم ويحسب كم نظرة إعجابٍ أتت إليه حتى يرتعش وينام.
جاري تحميل الاقتراحات...