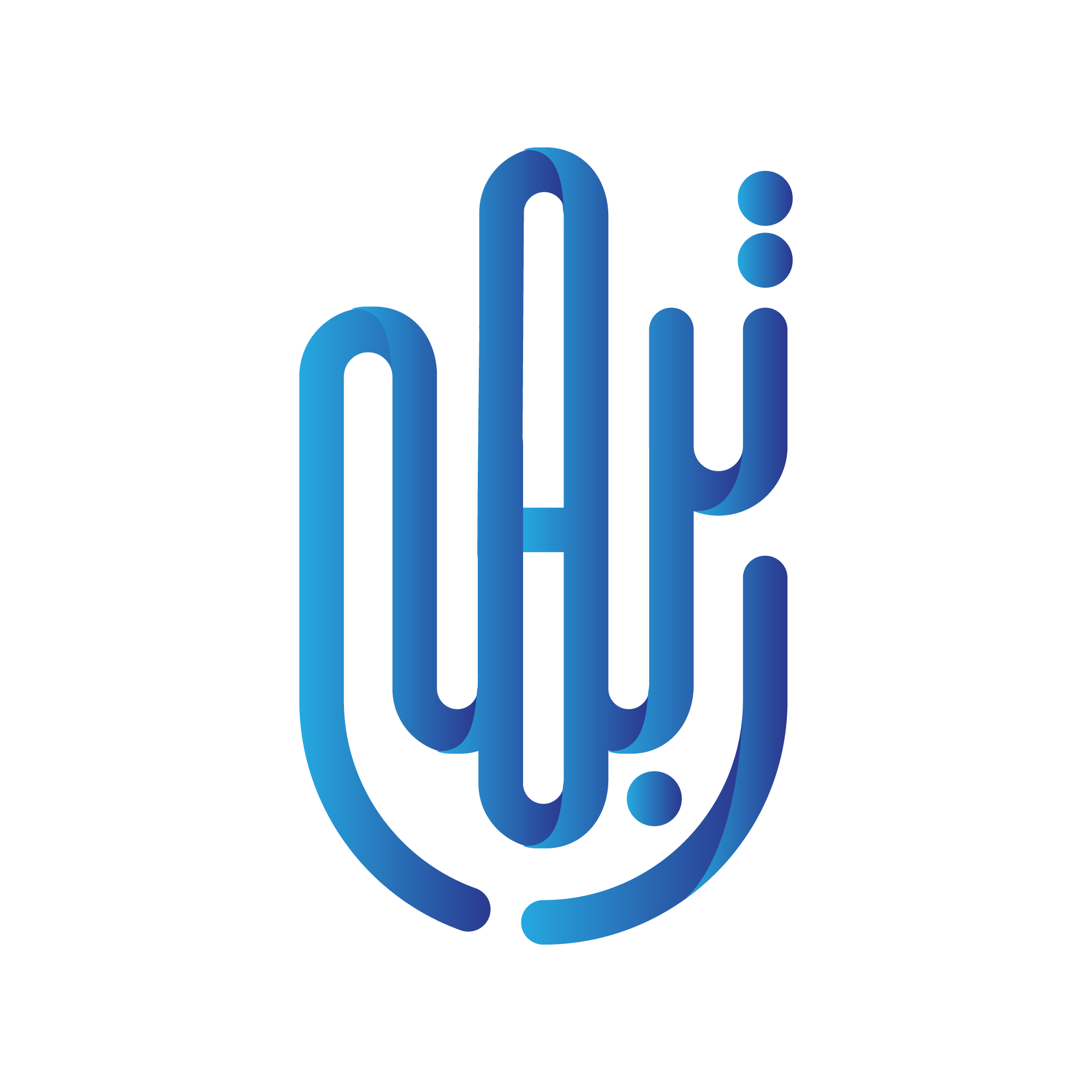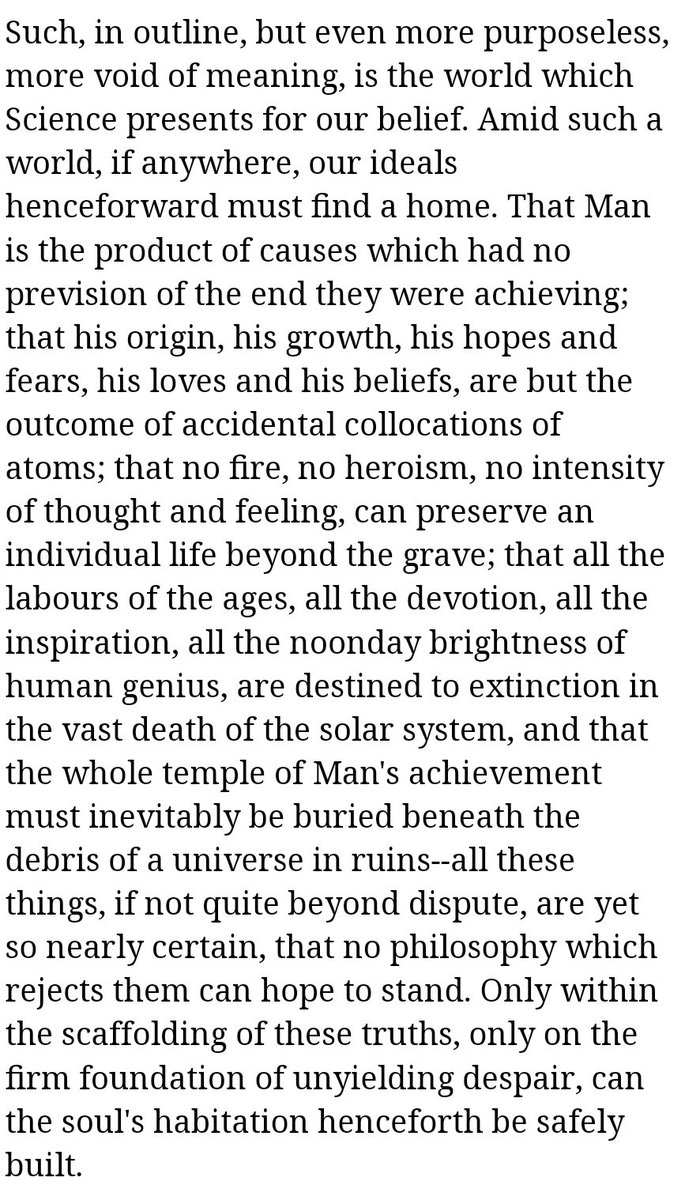يعرّف قاموس أوكسفورد (Oxford Dictionary) العدمية (Nihilism) بأنها :
The rejection of all religious and moral principles, in the belief that life is meaningless.
ترجمة :
الرفض التام لجميع المبادئ الدينية والأخلاقية، والإعتقاد بأن الحياة لا معنى لها.
en.oxforddictionaries.com
The rejection of all religious and moral principles, in the belief that life is meaningless.
ترجمة :
الرفض التام لجميع المبادئ الدينية والأخلاقية، والإعتقاد بأن الحياة لا معنى لها.
en.oxforddictionaries.com
من الملاحظ أنّ تعريف قاموس أوكسفورد للعدمية أقرب منه للعدمية الوجودية على العدمية الأصولية التي شاعت على يد إيفان تورجينيف في روايته "آباء وأبناء 1862m" فقد استخدم العدمية لوصف العلوم الخام التي إعتنقتها شخصية "بازاروف" والتي تبشّر بعقيدة الرفض التام، ولم يُشر للعدمية الوجودية.
وكما أن طبيعة الأشياء تُعرَّف بنقائضها عبر التقسيم المنطقي لصراع الأضداد كما في جدلية هيجل، وما أقصده هنا أن التناقض يولّد المعنى، ف"الخير" لا يُعرف إلا بنقيضه "الشر" ولولا وجود الشر لما عرفنا الخير.
بمعنى آخر : لا معنى من دون الصراع ولا صراع من دون التناقض ولو كان جزئياً.
بمعنى آخر : لا معنى من دون الصراع ولا صراع من دون التناقض ولو كان جزئياً.
وبعبارة أوسع وأشمل، فالكون كلّه عبارة عن صراع سرمدي بين التناقضات والأقطاب (الموجبة والسالبة)، بل إن هذا التناقض والصراع هو الذي يولّد المعنى ليصبح جزءًا من الصيرورة الكونية السرمدية، مما يجعله المحرّك الأساسي للتاريخ والطبيعة والفلسفة.
في الفلسفة الأخلاقية كمثال نجد الصراع الأبدي بين الخير والشر، وفي الفلسفة الوجودية نجد الصراع الأبدي بين الوجود والعدم، وفي السياسة نجد الصراع الأبدي بين اليسارية الراديكالية واليمين المتطرف الخ...
وكذلك العدم والوجود، فالعدم هو الوجه الآخر للوجود وبه نعرف حقيقة الحياة.
وكذلك العدم والوجود، فالعدم هو الوجه الآخر للوجود وبه نعرف حقيقة الحياة.
بالنسبة لموضوع "الوجود والعدم" والذي يعدُّ من المقاربات الفلسفية الأنطولوجية، الواسعة والعميقة جداً ويعدّ مادةً دسمة للنقاش، وقد كتب عنه فلاسفة كبار مثل هايدجر الذي ناقش "الوجود والزمان" في أطروحة تحمل نفس الإسم، وهي دراسة أنطولوجيّة من خلال المنهج الفينموينولوجي الهوسرلي.
وشرحه أيضاً جان بول سارتر في كتابه "الكينونة والعدم" طبعا الوجود الذي نقصده هنا وجود الكينونة الواقعية، لأن الكينونة المثالية قد تكون أوهاماً مثل المُثُل العليا لأفلاطون فليس لها وجود حقيقي، سارتر في هذا الكتاب كان يؤكّد على أن الوجود يسبق الجوهر، أو أن وجود المرء يسبق ماهيّته.
وقد كتب الفيلسوف الروسي الثوري "الأناركي" ألكسندروفيتش باكونين مقولة يشرح فيها العدميّة وما زال هذا التعريف سائداً وتُعرَّف به إلى الآن.
فكتب يقول "دعونا نضع ثقتنا في الروح الأبدية التي تدمر وتبيد فقط لأنها مصدر الإبداع لكل الحياة، الشغف بالتدمير هو أيضا شغف إبداعي".
فكتب يقول "دعونا نضع ثقتنا في الروح الأبدية التي تدمر وتبيد فقط لأنها مصدر الإبداع لكل الحياة، الشغف بالتدمير هو أيضا شغف إبداعي".
وقد برزت العدمية في القرن التاسع عشر في فرنسا على يد الأدباء والروائيين الفرنسيين مثل روايات الواقعية النقدية للروائي الفرنسي جوستاف فلوبير، وأندريه دي بلزاك، وفي أعمال الطبيعة الانطباعية لإميل زولا.
إلا أن الأديب الفرنسي جوستاف فلوبير هو المعبر الأول عن العدمية في رواياته، ثم أصبحت مذهباً أدبياً لعدد كبير من الأدباء في القرن التاسع عشر.
ويعدّ الأديب والشاعر والروائي الألماني جوتفريد بن من أبرز العدميين الذين وضحوا معنى العدمية كمذهب أدبي.
ويعدّ الأديب والشاعر والروائي الألماني جوتفريد بن من أبرز العدميين الذين وضحوا معنى العدمية كمذهب أدبي.
ماكس ستيرنير كان من أوائل الفلاسفة العدميين، تمخّضت عدميّته عند هجومه على الفلسفة المنهجية، وإنكار المطلق، ورفض جميع المفاهيم المجرّدة.
وبالنسبة إلى ستيرنر، فإن تحقيق الحرية الفرديّة هو القانون الوحيد، والدولة التي تضر بالحرية الفردية ضرورةً يجب تدميرها.
وبالنسبة إلى ستيرنر، فإن تحقيق الحرية الفرديّة هو القانون الوحيد، والدولة التي تضر بالحرية الفردية ضرورةً يجب تدميرها.
منذ مطلع القرن العشرين شغل فشل العدمية في جزئيّتها الإبستمولوجية، وسقوط المنظومة القيمية أو الأخلاقية، والذي نتج عنه ضياع حس الغائية الكونية، عقول الفنانين، والمفكرين، والنقاد الاجتماعيين، والفلاسفة.
وفي منتصف القرن العشرين ساهم الوجوديون في نشر وتعميم العدمية في محاولة لصقل إمكانيات وقدراتها التدميرية.
وبحلول نهاية القرن العشرين، فسح اليأس الوجودي المجال أم اللامبالاة كاستجابة للعدمية، والتي ارتبطت بالنزعة الأنتي-تأسيسية (النزعة التأسيسية المضادة).
وبحلول نهاية القرن العشرين، فسح اليأس الوجودي المجال أم اللامبالاة كاستجابة للعدمية، والتي ارتبطت بالنزعة الأنتي-تأسيسية (النزعة التأسيسية المضادة).
ومن الجدير بالذكر أن العدمية في روسيا أصبحت مرتبطة بحركة ثورية منظّمة بشكل كبير، والتي رفضت كل أشكال السلطة: من سلطة الدولة والكنيسة والعائلة.
دعت الحركة إلى إقامة ترتيب اجتماعي قائم على النزعتين: العقلانية والمادية كمصدر وحيد وأساسي للمعرفة، والحرية الفردية كأسمى هدف في الوجود.
دعت الحركة إلى إقامة ترتيب اجتماعي قائم على النزعتين: العقلانية والمادية كمصدر وحيد وأساسي للمعرفة، والحرية الفردية كأسمى هدف في الوجود.
وقام العدميون بإنكار الجوهر الروحي الإنساني واستبدلوه بجوهر ذو أصل مادي كلياً. تدهورت الحركة الثورية في نهاية الأمر وسقطت في مستنقع الشر (التخريب، التدمير، إثارة، الفوضى).
وفي نهاية سبعينات القرن الثامن عشر أصبح العدمي هو أي شخص متورط أو مرتبط مع الحركات السياسية السرية.
وفي نهاية سبعينات القرن الثامن عشر أصبح العدمي هو أي شخص متورط أو مرتبط مع الحركات السياسية السرية.
ومن الجدير بالذكر أن فلسفة العدمية تظهر في الفعل "annihilate" أو "إبادة" بمعنى تحويل الشيء إلى لاشيء أو تدميره كلياً من باب نفيه إلى العدم.
تطور المفهوم بمرور الوقت على يد العدميين من أمثال فريدريش جاكوبي وزمرة الروائيين من أمثال ايفان تورجنيف وغيره.
تطور المفهوم بمرور الوقت على يد العدميين من أمثال فريدريش جاكوبي وزمرة الروائيين من أمثال ايفان تورجنيف وغيره.
أما عن الفلسفة التي أتبنّاها في العدمية فهي متطوّرة عن النماذج الكلاسيكية التي أسسها العدميون الأوائل من أمثال نيتشه والفيلسوف باكون والشكوكي Skeptics وديموسثينيس وستيرتر وغيرهم.
فلسفتي تنحصر في إنعدام الغائية "الكونية"، وغياب المعنى "الجوهري" للحياة وليس المعنى الواقعي.
فلسفتي تنحصر في إنعدام الغائية "الكونية"، وغياب المعنى "الجوهري" للحياة وليس المعنى الواقعي.
وأساس فلسفتي مستخلص من نموذج سارتر الكلاسيكي والذي أسسه في كتابه "الكينونة والعدم" من أن الوجود يسبق الجوهر، أو أن وجود المرء يسبق ماهيّته.
النموذج الذي قمت بتطويره عن نموذج جان بول سارتر هو أن الجوهر قد يتحلل ويموت "موت المعنى" بالرغم من عدم تحلل الوجود الواقعي "الحياة".
النموذج الذي قمت بتطويره عن نموذج جان بول سارتر هو أن الجوهر قد يتحلل ويموت "موت المعنى" بالرغم من عدم تحلل الوجود الواقعي "الحياة".
الإنسان العدمي يرى العالم بواقعية ومنطقية أكبر، وتفسيره للعالم متماسك علمياً ومنطقياً، الرؤية العدمية مستخلصة ومتشرّبة ومتشبّعة من جذور الفلسفة والمنطق العلمي.
رؤية العالم كله بنظارات وردية "إيجابية" سذاجة لأنه يتضمن إنكاراً لحقيقة واقعية وهي الشر.
رؤية العالم كله بنظارات وردية "إيجابية" سذاجة لأنه يتضمن إنكاراً لحقيقة واقعية وهي الشر.
وكذا الأمر عند رؤية العالم كلّه بنظارات سوداء قاتمة "سلبية" سذاجة لأنه يتضمن إنكاراً لحقيقة واقعية وهي الخير والجمال "الغير جوهري" في الحياة.
الشخص العدمي يمسك العصا من الوسط ويرى العالم بمنطقية الوقائع، وحكمة التاريخ، وبأمانة المنهج العلمي.
الشخص العدمي يمسك العصا من الوسط ويرى العالم بمنطقية الوقائع، وحكمة التاريخ، وبأمانة المنهج العلمي.
لذلك الشخص العدمي ليس متشائماً بالضرورة كما يعتقد الأغلبية من الناس، وهو ليس مكتئباً بالضرورة أو ذو مزاج ورؤية سوداوية، وسيكولوجية مضطربة نفسياً.
العدمي لا ينفرد برؤية كونية أحادية قطبية عن الخير أو الشر، فهو يرى "الخير" و "الشر" في نفس الوقت.
العدمي لا ينفرد برؤية كونية أحادية قطبية عن الخير أو الشر، فهو يرى "الخير" و "الشر" في نفس الوقت.
من أسباب إتهام العدمية بالسلبية، والتشاؤم، والسوداوية، يرجع إلى هالة الخوف التي تحيط بكلمة "العدمية" وهذه النظرة غير صحيحة، وغير واقعية. فتجاهل العدم لا يلغي حتميّته كنهاية واقعية محتومة، فهو الوجه الآخر للوجود، ولا يمكن الفصل بينهما لأن معنى كل منهما مرتبط بالآخر.
هناك بعض نقاط الإختلاف والتشابه بين الإلحاد والعدمية، فالإلحاد الصريح يعتقد بعدم وجود "الإله" جملةً وتفصيلاً كمنهج سارتر، أما العدمية فترى أن مسألة وجود "الإله" مسألة عديمة القيمة من الناحية الوجودية، فسواء وجد "الإله" أم لا فإن ذلك لا يعطي قيمة جوهرية للإنسان.
ومن أساسيات العدميّة التي أعتقد بها في شقّها العلمي هو أن مسألة وجود "الإله" مسألة عديمة القيمة علمياً، فسواءًا وجد "الإله" أم لا، فإنَّ الكون غير متأثرّ بوجوده من عدمه.
لأن النظريات العلمية بما تحتويه من تفسيرات منطقية دقيقة ومتماسكة تغني عن "الإله" تماماً.
لأن النظريات العلمية بما تحتويه من تفسيرات منطقية دقيقة ومتماسكة تغني عن "الإله" تماماً.
وهنا نستعير تشبيه الفيلسوف ريتشارد كارير، فنقول: تخيّل الرؤية الكونية للعدميين بوصفها سفينة، اللوح الأول فيها، وهو ما يمكن أن نسمّيه المقدِّم الحقيقي لمعتقداتنا عن الكون هو الهيكل الكلي للإستنتاجات الذي نسميه العلم، وهو بدوره مبني من تطبيق المنطق والرياضيات على المشاهدة الحذرة.
ومن الجدير بالذكر أنّ سارتر كان مهتماً اهتمامًا كبيرًا بالفلسفة العدمية باعتبارها تداخلًا في نسيج الصيرورة الكونية، فالفرد عنده يعيش في مواقف تتصف بالخداع، ويحاول أن يتخطى حدود نفسه ويخدعها.
ومن أجل أن وجوده مرتبط بوجود الآخرين يرى تصارُع إراداتهم مع إرادته بوضوح ومنطقية.
ومن أجل أن وجوده مرتبط بوجود الآخرين يرى تصارُع إراداتهم مع إرادته بوضوح ومنطقية.
طبقاً لنموذج العدميّة الذي أتبنّاه، فالموت هو الإنطفاء والنسيان بصورة أبدية، فهو الوجه الآخر للوجود أي: "العدم المطلق"، وهو أمرٌ حتمي لا مفرّ منه، وحين تموت أدمغتنا وتتحلّل في النهاية سينتهي وجودنا دون رجعة.
لأن ما نحن عليه وما يكوّن ذواتنا هو الدماغ، وجميع المعلومات البشرية مخزّنة في الدماغ بشكلٍ مادي بحت (لا يمكن للروح أن تأخذ معها نسخة احتياطية)، وحين يفقد الدماغ الأكسجين أو أي موردٍ حيويٍّ آخر سيتعرّض بسرعة شديدة لتلف يتعذّر إصلاحه، مما يؤدّي إلى الموت بلا رجعة، أي: "عدم مطلق".
ولو قبلنا جدلاً بوجود الروح، فإن انتقال "الروح" من جسد إلى جسد آخر سيجعل الجسد الآخر إنساناً جديداً، ولن تنتقل أنت بشخصيتك ومعرفتك إلى الحياة الأخرى، مما يعني أنك ستموت في كل الأحوال ﻷن دماغك سيموت معك ولن تعرف أنك حييت مرة أخرى في الجسد الجديد الذي يملك دماغاً جديداً.
وهذا يعني أننا لن نلتقي أبداً بأحبائنا الراحلين، وأن أعمارنا نفسها ذات أمدٍ محدود، وأن "العدالة" التي بشّرت بها الأديان كما يقول الفيلسوف البرتغالي كرستافيو فيريرا مجرّد خدعة أنطولوجية فلا وجود للجنة ولا للنار لأنه لا وجود للحياة الأبدية أصلاً، كلّ هذا مجرّد خدعة ماكرة لعينة.
وكما يقول أونفريه فإن كتاب "نقيض المسيح" يحكي قصة النزعة العدمية الأوروبية، ويقترح دستوراً بمثابة العلاج للأمراض الميتافيزيقية "الدينية" والأنطولوجية في حضارتنا.
العدمية المعاصرة تستدعي مبدأ "تجاوز القيم السائدة" transvaluation يتجاوز كل الحلول والإفتراضات الدينية.
العدمية المعاصرة تستدعي مبدأ "تجاوز القيم السائدة" transvaluation يتجاوز كل الحلول والإفتراضات الدينية.
أي أنه لا ينبغي أن تكون الفكرة الإلحادية غاية في حد ذاتها فقط، صحيح أنه يجب الغاء الإله، ليس لأننا مشوشون بأمر وجوده من عدمه، بل لأننا متأكدون يقيناً أننا لسنا بحاجته ونظراً لأن كل شيء رأيناه يحدث ولم يتسبب البشر في حدوثه، هو نتيجة حتمية أو غير حتمية... يتبع
تكملة : هو نتيجة حتمية أو غير حتمية "مباشرة أو غير مباشرة" للأسباب الطبيعية، فنحن إذاً لسنا بحاجة للإله علمياً ومنطقياً ورياضياً، فالسؤال المنطقي الجوهري في قضية وجود الإله يجب أن يكون : هل نحن بحاجة للإله حقاً؟! بدل السؤال عن وجوده من عدمه.
فالإله لا يؤثّر فعلياً في وجود الكون، لأننا نستطيع تفسير وبناء كل المنظومة الكونية التي هي عبارة عن تجمّع و تكتّل ضخم لكامل المنظومة المعرفية، والأخلاقية، والسياسية، والإقتصادية البشرية بدون الحاجة للإله أو لشرعه المتمثّل في دياناته.
ولأننا لسنا بحاجة للإله حقاً، يجب الغاؤه من المنظومة البشرية الشمولية بما تحتويه من تكتل وتجمع لمنظومات معرفية، وأخلاقية، وسياسية، واقتصادية.
وذلك عبر ومن أجل تأسيس منظومة بشرية شمولية جديدة لا تحتكم للمعايير الميتافيزيقية بل تتحاشى البعد الغيبي للظواهر الطبيعية في بناء التصورات والإستنتاجات حولها، لتكوين منظومة فكرية الحادية عدمية متماسكة منطقياً ومنهجياً.
هنا أتذكر ريتشارد كارير حين قال متسائلاً إذاً حين نموت فإن وجودنا ينتهي!!، هل هذا يعني أن الحياة بلا معنى؟! لمجرد أنها مؤقتة.
بحسب النموذج الذي أتبناه "العدميّة الوجودية" فالجواب : ليس فعلاً، لأن معظم الأشياء القيّمة وذات المعنى العميق "ليس جوهرياً بالضرورة" مؤقتة.
بحسب النموذج الذي أتبناه "العدميّة الوجودية" فالجواب : ليس فعلاً، لأن معظم الأشياء القيّمة وذات المعنى العميق "ليس جوهرياً بالضرورة" مؤقتة.
فنحن لا نعتبر مناسبةً بهيجة ورائعة بلا معنى لأنها تستمرُّ ليومٍ واحدٍ فقط، فالشخص العدمي يستطيع أن يقضي حياته بسعادة، فعبر وجودنا وصنعنا لشيء جيد من أنفسنا، نمنح أنفسنا وبعضنا بعضا قيمة، ونصنع الهدف والمعنى "الواقعي أو الضروري" بالرغم من عدم وجود المعنى الجوهري "الغائية الكونية".
وفي فلسفة السعادة أتذكّر مقولة نيتشه "السّعادة هي التصالح مع الشّقاء"، لأن الشقاء جزءٌ من الحياة، ولكي يكون المرء سعيداً يجب أن يتعلّم كيف يحبُّ الحياة كما هي ويتقبّلها في كلّ تجلّياتها، فلا "العدم المطلق" ولا غياب "الغائية الكونية" يغير شيئاً من "القيمة الواقعية" للوجود.
يقول الحكماء أن "الحب فعلاً هو المفتاح" فحب التعلم، حب العلم، حب العمل، حب الآخرين، حب المثل، حب الوطن، أي شيء وكل شيء هو الأساس للمعنى "الواقعي" وبالتالي هو الأساس للحياة.
لذلك قد يوجد المعنى "الواقعي" وهو الضروري للحياة نتيجة التكيف، بالرغم من إفتقاد المعنى "الجوهري" للحياة.
لذلك قد يوجد المعنى "الواقعي" وهو الضروري للحياة نتيجة التكيف، بالرغم من إفتقاد المعنى "الجوهري" للحياة.
يجب أن نرى العالم بنظارات "الواقع" و"المنطق العلمي"، وأن لا ننافق ذواتنا برؤيته ب"نظاراتٍ وردية ضبابية"، يجب أن نتقبّل بكل سعادة أن مصيرنا هو "العدم المطلق"، فقط ولا شيء بعد ذلك، وأن لدينا حياة واحدة فقط، ولذلك يجب أن نعيشها بسعادة (هدوء وسلام واستقرار وتقبّل) بعيداً عن الصراعات.
وفي هذا الصدد يسرد مفيستوفيلس تاريخ البشرية لدكتور فاوست كما يلي :
لقد بدأت التسابيح اللانهائية لجوقات الملائكة تصبح مضجرة، لأنه في النهاية ألم يكن يستحق تمجيدهم؟، ألم يمنحهم متعة لا نهائية؟، أليس الأمر مسلياً أكثر إن حصل على تمجيد غير مستحق؟، أن يُعبد من قبل كائنات يعذبها؟.
لقد بدأت التسابيح اللانهائية لجوقات الملائكة تصبح مضجرة، لأنه في النهاية ألم يكن يستحق تمجيدهم؟، ألم يمنحهم متعة لا نهائية؟، أليس الأمر مسلياً أكثر إن حصل على تمجيد غير مستحق؟، أن يُعبد من قبل كائنات يعذبها؟.
ابتسم روحانياً، وقرر أن الدراما العظيمة يجب أن تنجز.
ثمّ يستطرد قائلاً : لعصورٍ لا تحصى كان السديم الحار يدور بلا هدفٍ في الفضاء. مع مرور الزمن ابتدأ يتخذ شكلاً، الكتلة المركزية شكّلت الكواكب، الكواكب بردت، البحار الهائجة والجبال المشتعلة اهتزّت وارتفعت.
ثمّ يستطرد قائلاً : لعصورٍ لا تحصى كان السديم الحار يدور بلا هدفٍ في الفضاء. مع مرور الزمن ابتدأ يتخذ شكلاً، الكتلة المركزية شكّلت الكواكب، الكواكب بردت، البحار الهائجة والجبال المشتعلة اهتزّت وارتفعت.
من كتل الغيوم السوداء غمرت أمطارٌ حارّة أديم الأرض شبه الصلب.
والآن نمت الجرثومة الأولى للحياة في أعماق المحيطات، وتطورت بسرعة في الدفء المثمر إلى أشجار الغابات العظيمة، نباتاتٌ هائلة انبثقت من سطح الأرض الرطب، وحوش البحر تكاثرت، تصارعت، أبيدت ثم اختفت.
والآن نمت الجرثومة الأولى للحياة في أعماق المحيطات، وتطورت بسرعة في الدفء المثمر إلى أشجار الغابات العظيمة، نباتاتٌ هائلة انبثقت من سطح الأرض الرطب، وحوش البحر تكاثرت، تصارعت، أبيدت ثم اختفت.
ثم تمضي الأسطورة الفاوستية في شرح ولادة الإنسان، وصراعه من أجل البقاء، وإدراكه المصطنع للغاية الكونية "الوهمية"، ثم تخلّيه عن الصراع مصمما أن الله قد أراد أن ينتج الإنسجام من المساعي البشرية، ومن ثم اتّباع غرائزه التي تطورت في النهاية إلى مفهوم "الخطيئة".
ولكنه وقع في الشك فيما إذا كان الله سيغفر له له لاحقاً، فاخترع خطّة إلهية عن طريقها يسترضي بها نقمة الله، وفي نهاية الأمر عندما رأى الله أن الإنسان قد حاز على الكمال في النكران والعبادة، أرسل شمساً أخرى عبر السماء حطمت شمس الإنسان، وعاد كل شيء إلى السديم مرةً أخرى كما في البداية.
ويقول الفيلسوف وعالم المنطق والمؤرّخ والناقد الإجتماعي برتراند راسل معلّقاً على عدميّة هذه الحياة متّخذاً هذه المسرحيّة التراجيدية كمقدمة لمقالته التي نشرت عام 1903 بعنوان "A Free Man's Worship" :
عالمٌ كهذا، بخطوطه العريضة، ولكنه بلا هدف بشكلٍ أكبر.
www3.nd.edu
عالمٌ كهذا، بخطوطه العريضة، ولكنه بلا هدف بشكلٍ أكبر.
www3.nd.edu
تكملة: وأكثر خلواً من المعنى يقدمه العلم لنا، في مثل هذا العالم على مُثُلنا أن تجد مكانها من الآن فصاعداً.
ذلك أن الإنسان نتاجٌ لأسبابٍ لا تخدم أيّة غاية مطلقاً، أصله، نموّه، أهدافه، ومخاوفه، محبته، ومعتقداته، جميعا ناتجة عن انتظامٍ عرضيٍّ للذرات، لا النّار، لا البطولة.
ذلك أن الإنسان نتاجٌ لأسبابٍ لا تخدم أيّة غاية مطلقاً، أصله، نموّه، أهدافه، ومخاوفه، محبته، ومعتقداته، جميعا ناتجة عن انتظامٍ عرضيٍّ للذرات، لا النّار، لا البطولة.
تكملة: لا كثافة المشاعر والأفكار ستحفظ حياة الفرد وراء التراب، جميع أعمال العصور، كل الإخلاص، كل الإلهام، كل تألق لعبقرية البشر سيفنى مع فناء النظام الشمسي، وكامل معبد الإنجازات البشرية سيفنى حتماً تحت أطلال الكون.
إذاً حين نموت فإن وجودنا سينتهي، هل يعني هذا أن حياتنا بدون معنى لمجرد أنها مؤقتة؟! يجيب الفيلسوف ريتشارد كارير على هذا السؤال في كتابه "Sense And Goodness in A natural world" فيقول:
"ليس فعلاً فمعظم الأشياء القيّمة وذات المعنى مؤقتة...، فنحن من يصنع الهدف والمعنى".
"ليس فعلاً فمعظم الأشياء القيّمة وذات المعنى مؤقتة...، فنحن من يصنع الهدف والمعنى".
"فلا الوجود صدفةً ولا العيش لفترة وجيزة، سيغير أي شيء في قيمة الوجود، قيمة التوصل للوجود، لمشاهدة الكون ومعرفته، لخلق شيءٍ ما".
ثم يقول "الحب فعلاً هو المفتاح، حب التعلم، حب العمل، حب الآخرين، أي شيء وكل شيء هو الأساس لصنع المعنى، ولو افتقدنا ذلك سنكون تعساء ولو عشنا للأبد".
ثم يقول "الحب فعلاً هو المفتاح، حب التعلم، حب العمل، حب الآخرين، أي شيء وكل شيء هو الأساس لصنع المعنى، ولو افتقدنا ذلك سنكون تعساء ولو عشنا للأبد".
في الواقع مسألة "عبثية الوجود" و"انعدام المعنى" تناولها وعالجها الوجوديين الكبار مثل كيركغارد وسارتر وهايدغر كلٌّ على نسق فلسفته، بل إن كامو بالرغم من رفضه المتكرر لوجوديته قضى أغلب وقته منشغلاً بالبحث عن أشهر المسائل الوجودية مثل "انعدام المعنى ومواجهة الموت".
والتي طرحها في أعماله مثل (أسطورة سيزيف) و (الإنسان المتمرد)، كما سأعالجها شخصياً على نسق فلسفتي الوجودية الخاصة، والتي أسعى لتوطيدها في مجال هذا البحث.
وقبل الخوض تفصيلاً في تفسيرات الوجوديين، يجب أن نعي ماهيّة "الرعب" أو "الفزع" الوجودي الذي هو محور الإستشكال.
وقبل الخوض تفصيلاً في تفسيرات الوجوديين، يجب أن نعي ماهيّة "الرعب" أو "الفزع" الوجودي الذي هو محور الإستشكال.
ذلك القلق الوجودي العميق منشأه اللحظات الحرجة النفسية التي تنهار فيها الحقائق الأساسية حول الطبيعة، والوجود البشري، عندما نصعق بلحظات وعي كونية وجودية نتيجة التعلم والتثقف الأصيل المستمر، لحظات تجعلنا نقف مذهولين أو مغيّبي الوعي لفترة قصيرة ريثما يعيد الوعي ترتيب نفسه.
تلك اللحظات تزلزل ما اعتبرناه حقيقة ووجوداً أساسياً ليتكشّف الفرض خلفها مسبّبةً "هزّة وجودية"، فرضيات عشنا معتقدين بحقيقتها التي رسمت كامل وعينا لمدة طويلة، لنكتشف زيفها لاحقاً، تلكمُ اللحظات تصنع أزمة شعورية ذات عمق وجودي يتسم بالقلق والخوف للوهلة الأولى.
كمن يطارد السراب وعند الوصول يدرك حقيقة خدعة السراب، فيقف فاغراً مذهولاً، ولإدراك الوجوديين لعمق تلك اللحظات والتي تعيد رسم باقي مسار الوعي وتصور الحياة عند رؤية الفرد بصورة جذرية وذات عمق أكبر، فقد وصفها كلُّ منهم على نسق فلسفته.
كيركغارد مثلاً استخدم وصف "الفزع" الذي ينتاب الإنسان عند مواجهة الفراغ واللامعنى الوجودي خلف حقيقة العالم، مع تأكيده على الإلتزام الأخلاقي والروحي الذي أمرنا الله به، مرجعاً سبب ذلك للخطيئة الأصلية، وبالتالي عند كيركغارد الإلتزام الأخلاقي والروحي شرط للتكفير عنها لعيش حياة أصيلة.
وكما نلاحظ لو تعمقنا في فلسفة كيركغارد أنه اكتفى بوصف تلك الصعقة للوعي، ولكن لم يفلح في بيان السبب الجوهري خلفها، أو كيفية اعادة معالجة الوعي بشكل أصولي فلسفي يشرح الأبعاد الحقيقية لذلك الفزع الوجودي، بل اكتفى لردها لسبب ميتافيزيقي غير ضروري منطقياً ولا برهان عليه وجودياً.
أما هايدغر فقد استخدم مصطلح "القلق" كنقطة مرجعية لمجابهة الفرد مع استحالة العثور على معنى في عالم لا معنى له، كما أشار إلى إيجاد مبرر منطقي للخيارات الذاتية حول القضايا العقلانية، وهو بذلك يؤكد على الحرية الفردية الصانعة برأيه للمعنى الوجودي.
ولم يكن هذا سؤالًا حول الخطيئة بالنسبة له، إنما محاولة لتأكيد وثبات الذات مقابل تزعزعها الوجودي، بسبب تلك "الهزة" العنيفة في الوعي(أنشأت مصطلح "الهزة الوجودية") وهكذا لم يفلح هايدغر أيضاً في معالجة أصل الموضوع بل اكتفى بشرح القلق والتأكيد على الذاتية لثبوتها أمام الهزة الوجودية.
ولكن لم يبين تلك الآلية، بل اكتفى بوصفها قضايا عقلانية وضرورات وجودية تبرر الذات سبب توجهها مؤصّلةً "التفرّد الوجودي".
أما مؤسس الوجودية الحديثة سارتر وصف ذلك الإدراك الشخصي بكونه "غثيان" عند مواجهة حقيقة أن الكون ليس مرتبًا وعقلانيًا بشكل جيد.
أما مؤسس الوجودية الحديثة سارتر وصف ذلك الإدراك الشخصي بكونه "غثيان" عند مواجهة حقيقة أن الكون ليس مرتبًا وعقلانيًا بشكل جيد.
بل كونه عشوائياً وغير قابل للتنبؤ. كما استخدم لفظ "الألم" لوصف إدراك أننا البشر لدينا حرية اختيار كاملة فيما يتعلق بما يمكننا القيام به، في هذا لا توجد قيود حقيقية علينا باستثناء تلك التي نختار فرضها، وفي ذلك يكمن عنده صناعة المعنى عبر إستيعاب "الحرية" في اختيار الأفعال.
عبر إستيعاب "الحرية" في اختيار الأفعال واللازمة عنها "المسئولية" الكاملة، وهو بذلك يؤكد على عملية صنع المعنى الذاتي لكل شخصية وجودية عبر الإختيار الحر والملزم بمسئولية الإختيار ليؤكد هو الآخر على دور الذاتية والتفرد الوجودي الذي يصنع المعنى الحقيقي المتباين من شخص لشخص.
كلهم أكدوا على التفرد الوجودي لصنع المعنى مقابل فراغ اللامعنى، هذا النسق الفلسفي هو من صلب طبيعة الوجودية التي عرفت بكونها فلسفة "فردية"، وضمناً أعتقد بقوّة أن اتجاهات المجتمع المتحضّر تبعدنا عن التفرّدية وتأخذنا نحو الإمتثال الإجتماعي والتي تضمحل فيها قيمة "الذاتية المتفرّدة".
أما مؤسس الوجودية الحديثة سارتر وصف ذلك الفزع الوجودي بكونه "غثيان" عند مواجهة حقيقة أن الكون ليس مرتبًا وعقلانيًا بشكل جيد، بل كونه عشوائياً وغير قابل للتنبؤ.
كما استخدم لفظ "الألم" لوصف إدراك أننا البشر لدينا حرية اختيار كاملة فيما يتعلق بما يمكننا القيام به.
كما استخدم لفظ "الألم" لوصف إدراك أننا البشر لدينا حرية اختيار كاملة فيما يتعلق بما يمكننا القيام به.
في هذا، لا توجد قيود حقيقية علينا باستثناء تلك التي نختار فرضها، وفي ذلك يكمن عنده صناعة المعنى عبر إستيعاب "الحرية" في اختيار الأفعال واللازمة عنها "المسئولية" الكاملة، وهو بذلك يؤكد على عملية صنع المعنى الذاتي لكل شخصية وجودية عبر الإختيار الحر والملزم بمسئولية الإختيار.
كلهم أكدوا على الذاتية والتفرّد الوجودي لصنع المعنى مقابل فراغ اللامعنى، كنوع من الإدراك الشخصي "الخصوصي".
هذا النسق التفرّدي للمعنى الخاص هو من صلب طبيعة الوجودية التي عرفت بكونها فلسفة "فردية".
هذا النسق التفرّدي للمعنى الخاص هو من صلب طبيعة الوجودية التي عرفت بكونها فلسفة "فردية".
وضمناً أعتقد بقوّة أن اتجاهات المجتمع المتحضّر يبعدنا عن التفرّدية ويأخذنا نحو الإمتثال الإجتماعي والتي تضمحل فيه قيمة "الذاتية المتفرّدة".
في هذا الصدد يشير كيركغارد إلى "الدهماء"، في حين يتحدث نيتشه بلهجة صارمة
عن "القطيع"، وهايدجر عن "الفرد"، وسارتر عن "الذات".
في هذا الصدد يشير كيركغارد إلى "الدهماء"، في حين يتحدث نيتشه بلهجة صارمة
عن "القطيع"، وهايدجر عن "الفرد"، وسارتر عن "الذات".
وأنا أتحدّث هنا عن "حقيقة الذات" عبر فهم أبعاد "الهزّة الوجودية" ولا أدعوا إلى "تعميم" الوجودية بنقلها من خانة "الخصوصية" إلى "الشمولية" والتي وصمت بها فلسفة هيجل الجدلية من قبل فيلسوف كوبنهاجن كيركغارد عندما هاجمها بقوة بجانب الصحف العامة، و الكنيسة، كأداة للإمتثال الإجتماعي.
كونها فلسفة سائدة تتحدث باسم الفرد وتختار بالنيابة عن الناس، وحولت القرارات الفردية إلى قيم عليا وشاملة في صراع "الجدلية"، بالرغم من التشابه الكبير بين أساس الفلسفة "الجدلية" التي أدعوا لها والقيم "الشمولية" التي أسعى لتوطيدها.
جاري تحميل الاقتراحات...